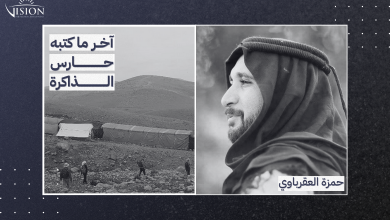كيف ينظر صنّاع الرأي الإسرائيليّون إلى العدوان على الدوحة؟

يقدِّم هذا التقرير خريطة تحليليّة للطريقة التي تناولت بها المنصّات الإسرائيلية البارزة تداعيات استهداف قيادة حماس في الدوحة، وقد شمل هذا التقرير ٢٨ مقال رأي وتحليل سياسي، بمجمل ٢٥ ألف كلمة، وكان لصحيفة معاريف الحظ الأكبر من مجمل المواد التي حُلّلت. يركّز التحليل على موضوعات أساسية تتمثل في البُعد الردعي، ومسار التفاوض، وانعكاسات العملية على شبكة العلاقات العربية، بالإضافة إلى مناقشة طبيعة السرديّة.
تنقسم الاتجاهات بشكل رئيس إلى اتجاه يرى في الضربة ربحاً ردعيّاً من شأنه إعادة هندسة ميزان القوى، واتجاهٍ يحذّر من تقويض مسار الأسرى وتفكيك منظومة الشراكات الإقليمية. من الجدير ذكره أنّ اللغة السائدة في مجمل الآراء تعبّر عن حالة استقطاب بنسبة ٨٠٪، كما تحمل تعقيداً لغويّاً بمعدّل متوسط.
تحوّل العقيدة الأمنيّة الإسرائيليّة
يؤكد مقال في معاريف أنّ الهجمات على الدوحة ليست حادثاً معزولاً بقدر ما هي حلقة في سلسلة عمليات من شأنها إرساء قواعد اشتباك تُمليها إسرائيل من طرف واحد، وتتحول فيها بشكل كامل من عقيدة الاحتواء والردع إلى عقيدة المبادرة الهجومية التي تتبنّى فعلاً وقائيّاً يتجاوز الحدود التقليدية للصراع، وتكون إسرائيل فيها قادرة على إعادة صياغة اللعبة وفقاً لغاياتها. لا يُقدَّم هذا التحول بوصفه خياراً عملياتيّاً فحسب، بل بصفته إعادة تعريف للهيكل الأمني بحيث تُسقِطه القيادة السياسية على نطاق إقليمي تكون فيه أي مسافة جغرافية أو حماية دبلوماسية لا تمنح خصوم إسرائيل حصانة من الاستهداف. يتوازى هذا الرأي مع خطاب يهدف لإيجاد شرعيّة أخلاقية لاستخدام القوة في أشد درجاتها، على اعتبار أن التردد في توجيه الضربات يمثل تهاوناً مع الشرّ.
يقدم مقال آخر في يديعوت أحرنوت مقاربة تناقش هذا الادعاء الأخلاقي، وتربط الضربات باعتبارات داخلية تتعلق بمسعى نتنياهو لمحو آثار الإخفاق في السابع من أكتوبر، وإطالة زمن الحرب لتثبيت هيمنة سياسية، معتبرة أن المبادرة الهجومية تحوّلت إلى مسرح دخاني يُبعد الأنظار عن مصير الرهائن، ويُخاطر بعلاقات إقليمية اكتسبتها إسرائيل بشق الأنفس. في هذا السياق ينتقد المقال ما يوصف بهوس صورة الانتصار، الذي يدفع الحكومة إلى عمليات رمزية ذات تكلفة باهظة، وتؤثر سلباً على استقرار اتفاقات أبراهام، بالإضافة إلى تعريض حياة الأسرى للخطر.
تجنح معاريف إلى قراءة براجماتية تبرّر المبادرة الهجومية، وتؤكّد أنّ المخاطر كانت مدروسة، وأنّ الهجمات حظيت بضوء أخضر من واشنطن، الأمر الذي يحصر تداعياته في الوقت الذي يوحي بأنّ العقيدة الأمنية الجديدة لا تتعارض مع ما يمليه التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية، بل تتكامل معه عبر توزيع الأدوار ما بين العصا العسكرية والمظلة الدبلوماسية. بالنسبة إلى الصحيفة، لن يكون لاستهداف الدوحة تداعيات سياسية خطيرة على اعتبار أن قطر دولة حريصة على الصورة، وتسعى إلى استضافة أولمبياد 2036، وبالتالي ستتجنب تصعيداً فعليّاً.
على المستوى الإقليمي، يُحاجج التحليل بأن الدول العربية المتحفّظة على قطر قد تنظر بإيجابية إلى استهدافها على اعتبار أنها وكيل للإخوان المسلمين. لكن يصطدم هذا الرهان مع تحليل يديعوت أحرنوت من احتمال اهتزاز الثقة الإماراتية والسعودية في التزام إسرائيل بحدود اللعبة، وهو ما يُعيد الجدال إلى ميدان التوازن بين المكسب التكتيكي والكلفة الإستراتيجية.
يظهر هذا التحليل أن النخبة الإسرائيلية منقسمة بين من يرى في توسيع دائرة الاستهداف وكسر القواعد التقليدية للاشتباك ضرورة تفرضها معطيات ما بعد السابع من أكتوبر، وبين من يُحذّر من أن هذا التوسع قد يُفضي إلى تآكل المكتسبات الدبلوماسية، ويُحوّل إسرائيل إلى فاعل إقليمي معزول رغم تفوقها العسكري. والحال أن الرهان على الضوء الأخضر الأميركي وعلى انقسامات عربية مُفترضة حيال قطر قد يصطدم بديناميكيات إقليمية أكثر تعقيداً، حيث تتداخل الحسابات البراجماتية مع اعتبارات السيادة والكرامة الوطنية بشكل يتجاوز التبسيط الذي تقترحه معاريف. في نهاية المطاف، هل تملك إسرائيل القدرة على فرض قواعد اشتباك أحادية دون أن تدفع أثماناً إستراتيجية مؤجلة؟ أم أن منطق القوة المطلقة سيصطدم حتماً بحدود القبول الإقليمي والدولي، خاصة في ظلّ تحولات جيوسياسية تُعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة؟
الخلاف في المؤسسة الأمنية: موثوقية قطر كوسيط ومصر كبديل
لا تخلو حلبة النقاش الإسرائيلية من سجال حول جدوى الاعتماد على أي من الدوحة والقاهرة في إنضاج صفقة تتعلق بالمحتجزين. ويُستدل من هذا السجال أنّ الهجمات لم تقرأ بوصفها عملية تكتيكية فحسب، بل كأداة لإعادة صياغة منظومة الوساطة كلّها، بما في ذلك مكانة الدوحة في مقابل القاهرة، وكذلك علاقة المؤسسة الأمنية بالقيادة السياسية في تل أبيب.
من الناحية البنيوية يسود الجدل حول قطر كرافعة من رافعات المحور السني المرتبط بفكر الإخوان المسلمين، فيما تُعدّ مصر طرفاً مناوئاً لهذا التيار، كما تحظى كوسيط تقليدي بقبول أكثر لدى بعض الدوائر الأمنية الإسرائيلية.
يسلط مقال آخر في معاريف الضوء على مفارقة لصالح القاهرة، يصف فيها مصر ذات الثقل الإقليمي والوساطة التقليدية مقابل قطر الدولة الصغيرة التي تحظى بدورها كمؤثر عبر المال والإيواء السياسي لحماس. يمثل هذا التوصيف التوجه المتبنى لدى الشاباك أن الدوحة ليست وسيطاً نزيهاً، وبالتالي يجب تحييدها لصالح القاهرة.
في المقابل، مقال رأي لبن كسبيت يكشف عن انقسامٍ واضح بين جهازَي الموساد والشاباك. فمدير الموساد دادي برنيا حذّر من أن الضربة قد تُفشل فرصة صفقة، وتشبث بفكرة أن قطر هي القناة الوحيدة القادرة على الحصول على جواب «نعم، ولكن» من قيادة حماس، وهو جواب يمكن تحويله، برأيه، إلى اتفاق لإعادة الأسرى. في المقابل يرى الشاباك أن من شأن اغتيال قيادة حماس في الخارج أن يبقي على طاولة المفاوضات قيادات غزة المُرهَقة عسكرياً.
تتقاطع الآراء المتعارضة في هذا السياق عند نقطة مركزية هي تقييم قدرة الدوحة على البقاء في موقع الوساطة. أنصار الشاباك وألداد يراهنون على أن ضعف قطر العسكري سيدفعها للتشدّد في حماية نفسها، حتى وإن تطلب ذلك التخلي عن إيواء حماس، ما يفتح الباب أمام القاهرة لتتصدّر الوساطة المدعومة إسرائيلياً. على النقيض يذهب الموساد وبن كسبيت إلى عدم تهميش حقيقة اعتبار واشنطن الدوحة شريكاً ضرورياً.
يُبرز الجدل القائم أيضاً توتراتٍ في إستراتيجية إسرائيل التفاوضية. فبينما تسعى المدرسة العملياتية، التي تجتنح إلى تفضيل الخيارات العسكرية الآنية، إلى فرض التفاوض من موقع المطارِد عبر الضغط العسكري، تُفضِّل المدرسة الدبلوماسية الأمنية، التي تمنح الخيارات غير العسكرية فرصاً أكبر، تعظيم الحوافز والحفاظ على قنوات الوساطة مهما بدت منحازة، بحجة أن أي صفقة لا يمكن أن تولد في فراغ سياسي.
إقليمياً، يشير غولاني الكاتب في معاريف إلى الحذر الإسرائيلي من التصعيد مع تركيا، التي تحتل المرتبة التاسعة عالمياً في القوة العسكرية، مقابل الجرأة على المساس بقطر التي تفتقر إلى الحماية الصلبة ذاتها، ما يسلّط الضوء على انتقائية استخدام القوة.
تكشف هذه القراءة بالمجمل عن أزمة بنيوية في التصور الإسرائيلي لمنظومة الوساطة الإقليمية. ويبدو الانقسام بين الموساد والشاباك يمثل تجسيداً لجدلية بين منطقين متعارضين: الأول يدرك حدود القوة في فرض واقع تفاوضي مستدام ويقرّ بضرورة التعايش مع وسطاء “غير مثاليين” طالما أنهم يملكون مفاتيح الحل، والثاني يراهن على إمكانية إعادة صياغة منظومة الوساطة بالقوة المجرّدة، مستنداً إلى افتراض هشاشة قطر وقابليتها للإذعان تحت الضغط. غير أن هذا الرهان الأخير يصطدم بإشكالية اعتبار واشنطن للدوحة شريكاً لا غنى عنه في معادلات إقليمية تتجاوز الملف الفلسطيني من جهة، ومن جهة أخرى، محدودية البديل المصري الذي، رغم وزنه التاريخي، قد لا يملك نفس القدرة على التأثير على مسار المفاوضات . والأهم من ذلك، تكشف الانتقائية في استخدام القوة – الجرأة على قطر مقابل الحذر من تركيا – عن تناقض جوهري في العقيدة الأمنية الجديدة التي تدّعي تجاوز قواعد الاشتباك التقليدية، لكنها تبقى في نهاية المطاف محكومة بموازين القوى الصلبة.
بناءً عليه، هل يمكن لإسرائيل أن تُحقق أهدافها التفاوضية عبر تدمير آليات الوساطة القائمة دون أن تجد نفسها أمام فراغ دبلوماسي يطيل أمد الأزمة ويُعمّق مأزق المحتجزين؟
الكلفة الدبلوماسية والإقليمية
يسلط هذا المحور الضوء على هجمات الدوحة باعتبارها اختباراً لقدرة إسرائيل على المحافظة على شبكتها الناشئة من الشراكات العربية بعد أبراهام، بالإضافة إلى شراكاتها التقليدية مع الغرب في آن واحد، إذ تحوّل الفعل العسكري الذي نُفِّذ في قلب عاصمة شريكة لواشنطن إلى مُعطى كاشف لحجم الهوّة بين المنطق الأمني الإسرائيلي ومنطق إدارة التحالفات. يُبرز ميرون رافوبورت الكاتب في موقع “سيخا ميكوميت” أن اختيار هدف في دولة ليست عدوة ويربطها بالولايات المتّحدة تعاون عسكري وثيق، لم يكن مجرد محاولة لإيصال رسالة ردعية إلى حماس، بل كان أيضاً إعلاناً متعمّداً بأنّ الحماية الأميركية لا تشكّل مظلّة حصانة أمام السلاح الإسرائيلي.
ترصد ليلاح سيغان الكاتبة في معاريف في ذات السياق ديناميّة تَحوُّل النصر التكتيكي إلى هزيمة دبلوماسية من خلال تسليط الضوء على أمور ثلاثة: أولها خطاب تفاخر داخلي أثار حنق الشارع العربي، وثانيها بيانات إدانة عربية رسمية اتسمت بحدة استثنائية، وثالثها انتقادات غربية حادة تجاوزت مجرّد العتاب التقليدي. تناقش سيغان أيضاً كيف أنّ وصف وسائل إعلام غربية لقطر بأنها وسيط يسعى إلى السلام قد قوّض السردية التي حاول نتنياهو تثبيتها أن الدوحة ملاذٌ للإرهاب.
يقدم موقف سيغان أيضاً بعداً اقتصادياً وسياسياً، حيث تستحضر تهديد بروكسل بتجميد اتفاقية التجارة وإقرار خطوات قاسية ضد وزراء إسرائيليين، ما يعكس انتقال الاحتجاج الأوربي من فضاء التصريحات إلى حقل السياسات العقابية. تكشف هذه التطورات اتجاهاً واضحاً نحو زيادة كلفة الضربة، إذ لم تعد الأزمة محصورة في الإطار العربي، بل باتت تعيد صياغة العلاقة مع العواصم الغربية التي طالما أبدت استعداداً لتغطية إسرائيل دبلوماسياً شريطة ألّا تُحرَج بمخالفة قواعد السلوك الدولي المتعارف عليها.
تتأكد جدية الموقف في تحذير رافوفورت من أن تكرار نمط استهداف وسيط مقبول دولياً قد يدفع واشنطن إلى إعادة تقييم هامش العمل الذي تمنحه لتل أبيب، لا سيما إذا كان ثمنه تعثّر مفاوضات إطلاق سراح الرهائن التي تستثمر فيها الإدارة رصيداً سياسياً داخلياً. بذلك قد تتشكّل مقاربة جديدة مفادها أنه كلما اتسعت مسافة العمل الإسرائيلي المنفرد، زادت احتمالات أن تُقابَل بتضييق أميركي حفاظاً على مصالح دفاعية أوسع.
من حيث التداعيات، يمكن رصد أربعة مسارات محتملة وفقاً لأطروحات النقاش هذه: أولاً، إعادة شبكات أبراهام خطوات إلى الوراء بعد أن كانت تتسم بالحماس نحو التطبيع، وهو ما يتجلّى في فتور التصريحات الرسمية من أبوظبي والمنامة وانفتاحها على انتقاد إسرائيل في محافل متعددة. ثانياً، دخول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي طوراً عقابياً جدياً، يتمثل في إلغاء الميزات التجارية الممنوحة لإسرائيل. ثالثاً، ترسيخ قطر لصورتها كضحية تنتهك سيادتها رغم دورها الوسيط، ما يعزّز موقعها في مؤسسات دولية ويمنحها رأس مالٍ دبلوماسياً تستثمره في ملفات أخرى. رابعاً، احتمال نشوء فجوة بين البنتاغون والمؤسسة السياسية الإسرائيلية إذا وُضِع الوجود العسكري الأميركي في قطر تحت ضغط ردّ فعل إقليمي أو محلي يرى في الضربة تجاوزاً للخطوط الحمر.
تسييس القرار العسكري وتضارب المصالح وتوظيف الضربة لتغطية إخفاقات 7 أكتوبر
تناقش آراء كيف تحوّل الخيار العسكري إلى رافعة سياسية تُدار من مكتب رئيس الحكومة بقصد حجب الإخفاقات في السابع من أكتوبر. فاستناداً إلى ميرون رافوفورت، قدّم نتنياهو للرأي العام سردية مفادها أنّ توجيه النار إلى قلب العاصمة القطرية يعيد تعريف “الردع” ويُرمّم صورة قوة الدولة.
هذا التوظيف السياسي ينطلق من توجه لهندسة وعي جماعية تؤكد عدم جدوى أي خيار سوى القوة فقط في التعامل مع الشرق الأوسط. يستخدم نتنياهو هذا الادعاء لإعادة إنتاج هيبة شخصية توفر له حزام نجاة داخلياً في مواجهة احتجاجات عائلات الأسرى وحركات الشارع التي تُحمّله مسؤولية كارثة أكتوبر. وعلى الرغم من اتساع رقعة عدم الثقة الشعبية فيه، يُظهر رافوفورت الكاتب في “سيخا مكوميت” أنّ قطاعات واسعة ما زالت تشتري الخطاب الذي يصوّر إسرائيل شرطياً أوحد للمنطقة، وهو خطاب يعيد توجيه الغضب العام بعيداً عن إخفاقات المؤسسة السياسية والأمنية، ويحوّله إلى مطالبة بمزيد من الحسم العسكري.
يتكامل هذا البعد، استناداً لرأي آخر منشور في “والا”، مع نمط شخصي يميز نتنياهو حيث يسعى إلى احتكار الفضل والتنصّل من الأخطاء. يسارع نتنياهو إلى الظهور في كل لحظة إنجاز، كما فعل بعد عملية إنقاذ الأسرى في النصيرات، حين اندفع إلى مستشفى شيبا لالتقاط الصور منفرداً في المشهد، بينما يترك للمتحدث العسكري إعلان الخسائر في العمليات الفاشلة. ويصف شهود من داخل دائرته هذا السلوك بأنّه “هوس كريدت” أو هوس تحصيل النقاط، يحكمه منطق أنّ النجاح يُحتكر لرئيس الحكومة بينما يُلقى الفشل على كتفي المؤسستين العسكرية والأمنية.
يقارن رافوفورت هجوم الدوحة بمحاولة اغتيال خالد مشعل عام 1997، حين كان نتنياهو – يومها أيضاً – رئيساً للحكومة، لكنه على الأقل استشار “تُفّه” المؤسسة قبل التنفيذ. أما اليوم فيُعطي انطباعاً بأنه “فوق أولئك التفه”، إذ تجاهل تحفظات رئيس الأركان ورئيس الموساد، مدفوعاً بقناعة مسيحانية بأنّه يجسّد التاريخ اليهودي بأكمله، ولا تُلزمه تحذيرات “صغار الإيمان” كما يسميهم. يضاف إلى ذلك أنّ العملية نسفت إحدى الذرائع الدفاعية التي كان مستشارو نتنياهو يستخدمونها في واشنطن للترويج لدور قطر الوسيط، وخلقت تناقضاً صارخاً بين سنوات تحويلات الدوحة لحماس، وبين الشيطنة الآنية لها على خلفية الضربة، ما يؤكد أنّ الدافع لم يكن إستراتيجياً خالصاً بل جزءاً من مناورة سياسية داخلية.
أحدثت الضربة، بحسب رافوفورت، قلقاً خليجيّاً جماعيّاً من نموذج إسرائيلي لا يعترف بأي حصانات سياديّة، الأمر الذي ساعد في إعادة التقارب بين خصوم إقليميين تقليديين مثل قطر والإمارات، ودفع القاهرة إلى التلويح بخفض مستوى علاقاتها مع تل أبيب أو السعي لتحالف دفاع عربي بديل. بذلك تنتقل تكلفة التسييس من الحقل الداخلي إلى الحقل الإقليمي، الأمر الذي يفاقم عزلة إسرائيل بدلاً من تعزيز هيمنتها كما يبشر نتنياهو.
يُظهر النقاش كيف تحوّلت العقيدة الأمنية الإسرائيلية إلى أداة في خدمة البقاء السياسي الشخصي، حيث يُعاد إنتاج “أسطورة القوة” كبديل عن المساءلة الحقيقية حول إخفاقات السابع من أكتوبر. تكشف ديناميّة “احتكار النجاح وتصدير الفشل” عن نمط حُكم يُفرّغ المؤسسات من جوهرها المهني، ويُحوّلها إلى أدوات في مسرح سياسي يُخرجه رئيس الحكومة منفرداً، مُستنداً إلى قناعة مسيحانية تضعه فوق المشورة المؤسسية وتُبرر تجاوز التحفظات المهنية باسم “الرؤية التاريخية”.
غير أن المفارقة تكمن في أن هذا التوظيف السياسي للقوة يُنتج تآكلاً إستراتيجياً على المستوى الإقليمي، حيث تتحوّل إسرائيل إلى “المُهدِّد” لكل أشكال الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك استقرار حلفائها المُفترضين. هذا الأمر يضعنا أمام تساؤل مركزي: هل نشهد لحظة تاريخية يتحوّل فيها “فائض القوة” الإسرائيلي إلى عبء وجودي، حيث يُصبح الانتصار التكتيكي المتكرر مساراً نحو الهزيمة الإستراتيجية الشاملة؟
صراع السرد والمسؤولية داخل المؤسسة الأمنية والسياسية
يسلط باراك سري الكاتب في “والا” الضوء على مسألة منطق السردية الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، ويرصُد مفارقةً مركزية: الأطراف نفسها التي سوّقت لضربة الدوحة بوصفها إنجازاً ردعياً بادرت إلى صناعة سردية جديدة تعتبر العملية ناجحة حتى لو لم يتم تصفية قيادات حماس، بحجة أنها أفقدتهم مكاناً آمناً، وأرسَت معادلة ردع إقليمية. هذا التكييف للمعايير يُنتج ما يمكن نعته بالنسبية الإنجازية. تكمن المفارقة الثانية في إغفال الخطاب العام تحذيرَ رئيسيْ الأركان والموساد من توقيت الضربة وتأثيرها المحتمل على مفاوضات الأسرى، الأمر الذي لم يبرز في البيانات الرسمية الأولى، ثم استُحضر لاحقاً كوسيلة لتحميلهم قسطاً من الإخفاق.
يستكمل نير كيبنس الكاتب في موقع “والا” أيضاً هذه الصورة من خلال توضيح دوائر الترويج للسردية الرسمية. الدائرة الأولى: تتكون من ناطقين شبه رسميّين ونماذج رقمية “بوتات رقمية” تقوم بمهمة ضخ سردية الإنجاز؛ الدائرة الثانية: تتمثل في نوّاب الصفوف الخلفية الذي يرمون بالونات اختبار لقياس القبول الشعبي قبل أن يتبنّى الوزراء الصيغة الأكثر تداولاً. يمنح هذا الترتيب صانع القرار القدرة على تعديل الخطاب دون تحمّل كلفة الانعطاف العلني له؛ فما يُقال في الدائرة الرقمية يُسحب أو يُنمَّط وفق استجابة الرأي العام، ثم يصاغ في بيان حكومي بمجرد اكتمال اختبار السوق السياسي.
يرصد بين كاسبيت الكاتب في “والا” تآكل استقلالية الجيش وتحوله إلى أداة تنفيذ تُستدعى عند الحاجة ثم تُترك في مهب النقد الشعبي إذا انقلبت النتائج. يتجلّى هذا في استعراضٍ إعلامي يُهمِّش آراء العسكريين الميدانيين، في حين تُتخذ القرارات المفصلية في دوائر ضيقة يديرها رئيس الوزراء ووزير دفاعه مع حفنة من المستشارين السياسيين. وعندما يبرُز التناقض، تُصنَّف تحفّظات الجيش والموساد بوصفها جبناً أو افتقاراً إلى الخيال العملياتي كما ظهر في الحملات الرقمية عقب تسرّب أنباء الفشل الجزئي.
على المستوى المؤسساتي، يُفضي استمرار هذا النموذج من هندسة الرواية إلى نتيجتين: الأولى، ترسُّخ ثقافة الخوف من اتخاذ موقف مهني يعارض رغبة القيادة السياسية، لأن التحفّظ على القرارات قد يُترجَم لاحقاً إلى اتهام بالتخاذل أو تسريب معلومات لإحراج صاحبه؛ والثانية، تآكُل المُساءلة بعدما بات الفشل يُعاد صياغته بوصفه نجاحاً بالتأثير أو كخطوة ضرورية في معركة الوعي.
يصل براك سري إلى خلاصة مفادها أن الجيش انتقل من كونه مؤسسة ذات رأي مستقل إلى مزود خدمة ناريّة تُحرَّك وفق حسابات البقاء السياسي. وبذلك يتّضح أن صراع السرد ليس جدلاً نظرياً حول لغة الخطاب، بل معركة على من يمتلك سلطة القرار ومن يدفع ثمنه، وعلى حدود التداخل بين الشرعية السياسية والمسؤولية العسكرية.
تكشف التوضيحات المطروحة حول آليات إنتاج السردية الرسمية عن أزمة بنيوية تتجاوز مجرد التلاعب بالخطاب إلى طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية، حيث يعاد تعريف النجاح والفشل وفق مقتضيات البقاء السياسي لنتنياهو. يشير هذا الانزلاق نحو “عسكرة السياسة وتسييس العسكر” إلى تآكل محتمل في جوهر المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، خاصة عندما تحل ثقافة الخوف والمُجاملة محلّ النقاش المؤسسي الصريح.