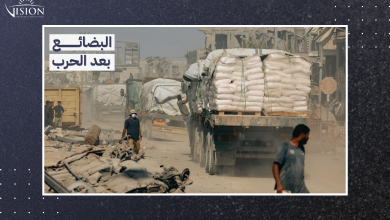حين يغدو العطش سياسة: الضفة الغربية في مواجهة الحصار المائي

يخوض المجتمع الفلسطيني منذ عقود معركة يومية من أجل الوصول إلى أبسط مقومات الحياة: الماء. وفي الخلافات الجيوسياسية، غالبًا ما تتحول المياه من مورد طبيعي إلى أداة صراع وهيمنة، ووسيلة للتحكم في الإيقاع الحيوي اليومي للسكان. فمنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، حوّل الاحتلال الموارد المائية إلى أداة سيطرة استراتيجية، من خلال أوامر عسكرية تمنع الفلسطينيين من حفر الآبار أو استخدام مياههم دون تصاريح شبه مستحيلة، مقابل توسّع غير محدود في وصول المستوطنات إلى تلك الموارد.
هذا الاحتكار الممنهج للمياه قوّض الإمكانات الزراعية والريفية، وفاقم الفجوة بين الفلسطينيين والمستوطنين في الحصص المائية. ومع تصاعد اعتداءات المستوطنين والجيش على ينابيع وعيون الماء، لم تعد المياه مجرد مورد طبيعي، بل أصبحت ساحة مواجهة مركزية في صراع يومي على البقاء، وعلى الحق في الحياة فوق أرضٍ تُستنزف مواردها عن سبق إصرار.
تُظهر الوقائع أن المياه لم تكن يومًا مسألة خدماتية أو بيئية فقط، بل أداة سياسية يُوظفها الاحتلال لإعادة هندسة المكان والإنسان الفلسطيني. ومع تصاعد اعتداءات المستوطنين على ينابيع وعيون الماء، أصبحت المعركة على المياه تجسيدًا حيًّا للصراع الوجودي اليومي الذي يعيشه الفلسطيني في الضفة الغربية.
أولا: القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالماء
منذ احتلال عام 1967، شرع الاحتلال في سنّ سلسلة من الأوامر العسكرية التي هدفت إلى فرض السيطرة الكاملة على موارد المياه في الأراضي الفلسطينية. وقد بدأت هذه القوانين بتجريد الفلسطينيين من ملكيتهم لمصادر المياه، باعتبارها ملكًا لدولة الاحتلال، ومنحت الاحتلال صلاحيات مطلقة في إدارة المياه، بما في ذلك رفض التراخيص دون تبرير. وتم وضع جميع الآبار والينابيع تحت سلطة الحاكم العسكري، وفرضت تراخيص مشروطة لاستخدام المياه، وحددت الكميات المسموح بها للضخ. هذه الأوامر ترافقت مع سلسلة من الإجراءات العملية على الأرض، شملت منع حفر الآبار الجديدة، ومصادرة آبار الفلسطينيين لصالح المستوطنات، وتقييد العمق المسموح به للحفر، وحرمان الفلسطينيين من حصتهم من مياه نهر الأردن. كما قام الاحتلال بحفر العشرات من الآبار داخل المستوطنات، وبناء سدود صغيرة لاحتجاز مياه الأودية، ونقل المياه من المستوطنات إلى داخل إسرائيل.
وصولا إلى توقيع اتفاق أوسلو، والذي اعترف “نظريًا” بحقوق الفلسطينيين في المياه[1]، إلى أن هذه الحقوق أُجّلت إلى مفاوضات الحل النهائي دون ضمانات تنفيذية. وفي المرحلة الانتقالية، أبقى الاحتلال السيطرة الفعلية على موارد المياه، حتى في المناطق المصنفة (أ) والتابعة إداريًا للسلطة الفلسطينية، حالها حال المناطق (ب) و(ج)، حيث يتطلب أي مشروع مائي موافقة إسرائيلية غالبًا ما تُقابل بالرفض أو التقييد الشديد. كما تجاهل الاتفاق تقاسم الموارد المائية، وأبقى على التوزيع غير العادل للمياه، إذ يحصل الإسرائيليون على 84% من الموارد المائية مقابل 16% فقط للفلسطينيين. أي أنه ما زال يحكم قطاع المياه الفلسطيني حتى اليوم، دون أي تغيير فعلي في موازين السيطرة أو الحصص.
ثانيا: سياسات التمييز والإقصاء في توزيع الماء
تشير البيانات الحديثة إلى فجوة عميقة في واقع المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تعكس ليس فقط اختلافًا في الموارد المتاحة، بل أيضًا في البنى التحتية والسياسات. إذ تُقدر الإحصاءات أن متوسط استهلاك الفرد الإسرائيلي للمياه يصل إلى 247 لترًا يوميًا، في حين لم يتجاوز متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية 82.4 لترًا، أي ما يعادل ثلث ما يستهلكه الفرد الإسرائيلي، وتزداد الفجوة حدة في المناطق الريفية الفلسطينية، حيث يُستهلك نصف هذه الكمية تقريبًا في الزراعة.
كما تعتمد فلسطين بشكل رئيسي على المياه الجوفية التي تشكّل نحو 79% من إجمالي مصادر المياه المتاحة، ويُعزى ضعف الاعتماد على المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال على نهر الأردن والبحر الميت. وما يزيد الأمر سوء أن نسبة الفاقد من المياه في الضفة الغربية ما تزال مرتفعة، حيث تتجاوز 35%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تهالك البنية التحتية لشبكات المياه.
تمثل سيطرة الاحتلال على مصادر المياه أحد أبرز مظاهر الإقصاء الممنهج للفلسطينيين، إذ يُجبر الفلسطينيون على شراء نحو 20% من احتياجاتهم المائية من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”، نتيجة الحدّ المتعمد لقدرتهم على استغلال مواردهم المائية الطبيعية. ويتجاوز هذا الإقصاء حدود التوزيع الكمي ليطال نوعية المياه نفسها، إذ يساهم الاحتلال في تلويث الخزان الجوفي الفلسطيني عبر تصريف مياه الصرف الصحي من المستوطنات نحو الأودية القريبة من التجمعات الفلسطينية، ما يحوّل أزمة المياه إلى أداة حصار يومي تعمّق التبعية وتُضعف مقومات الصمود.
وانعكست سياسات الإفقار المائي على أنماط الزراعة التي باتت تسعى لتتناسب مع ندرة الموارد لا مع متطلبات الاكتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي. حيث يعاني قطاع الزراعة في الضفة الغربية من تراجع المساحات الزراعية وتقلص إمكانية الاعتماد على الزراعة كمصدر معيشة مستدام، بعد أن اضطر المزارعون إلى التحول نحو زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي المنخفض، ما انعكس سلبًا على تنوع المحاصيل وأدى إلى تقليص زراعة الأنواع ذات الطلب العالي على الماء، دون الالتفات لحاجة السوق المحلي
هذه التحولات الجذرية فرضتها سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تكثيف نزع الملكية وتحويل المزارعين الفلسطينيين، الذين تنظر لهم كعقبات جغرافية يجب إزالتها، ضمن استراتيجية متعمدة تهدف إلى خلق بيئة غير صالحة للعيش تدفع نحو النزوح القسري دون الحاجة إلى أوامر طرد رسمية. وبالتالي لم يقتصر تأثير شح المياه على الإنتاج الزراعي فقط، بل امتد ليُضعف الإرادة الجماعية الفلسطينية في الاستمرار بالتمسك بالأرض.
ثالثا: تفاقم اعتداءات الاحتلال على مصادر المياه بعد السابع من أكتوبر
في أعقاب السابع من أكتوبر، تصاعدت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه في الضفة الغربية بشكل ملحوظ، إذ استهدفت بشكل منهجي البنية التحتية المائية في عدد من المناطق الحيوية. وبرزت منطقة عين سامية، شرق رام الله، كمثال صارخ على هذا التصعيد، حيث تعرضت عين الماء هناك لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، شملت تخريب شبكات الكهرباء، وتدمير معدات الضخ، وأنظمة الاتصالات، وكاميرات المراقبة.
وقد أسفر ذلك عن فقدان السيطرة التقنية والإدارية على المنظومة بأكملها، وتوقف ضخ المياه إلى عشرات القرى والبلدات الفلسطينية، ما يهدد أكثر من 100 ألف فلسطيني بحرمانهم من مصدرهم الرئيسي للمياه. ويُضاف إلى ذلك استمرار الاحتلال في هدم آبار تجميع المياه، حيث تجاوز عدد الآبار المهدمة 500 بئر، كما سيطر المستوطنون على 45 عين ماء بين شرق رام الله والأغوار، مما حرم المزارعين من مصادر حيوية كانت تُمكّنهم من الاستمرار في أراضيهم، ضمن سياسة ممنهجة لإضعاف قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى مواردهم المائية والتحكم بها.
وقد فاقم الانقطاع الأخير أزمة المياه في الضفة الغربية، خاصة في صيف هذا العام، حيث أُجبر السكان على تقنين استهلاكهم اليومي والاكتفاء بكميات محدودة للشرب والطهي على حساب النظافة الشخصية والزراعية. وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف الصحية نتيجة صعوبة الحفاظ على شروط الصحة العامة، وظهور مؤشرات على انتشار أمراض جلدية ومعوية مرتبطة بانخفاض معايير النظافة.
أما في القرى والبلدات التي كانت تعتمد على العيون والآبار المدمرة، فقد وثّق السكان لجوءهم إلى جلب المياه من مسافات بعيدة عبر صهاريج مكلفة أو حتى من ينابيع غير آمنة صحياً، وهو ما ضاعف من معاناة النساء والأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر في نقل المياه. وتُجسّد قرية سوسيا جنوب الخليل مثال لهذا الواقع، حيث قطع المستوطنون في يوليو 2025 خطوط المياه عن القرية، مما دفع سكانها إلى وصف ما يعيشونه بـ”أزمة عطش لا تُحتمل”.
كما انعكس شح المياه على قطاع الزراعة بشكل حاد؛ إذ اضطر العديد من المزارعين في شمال الضفة الغربية، خصوصًا في جنين، طولكرم وطوباس، إلى ترك أراضيهم بورًا أو تقليص المساحات المزروعة بشكل واسع، نتيجة تدمير أنظمة الري وشبكات الكهرباء التي تغذّي مضخاتهم، مما أدى إلى اضطرار البعض إلى توقّف النشاط الزراعي تمامًا. وكان الانقطاع في الإمدادات المائية مرتبطًا بمخاطر تمس بتربية المواشي أيضًا، إذ أوقف العديد من القادمين من مصادر الرزق الأساسية عن الوفاء باحتياجات مواشيهم من المياه والأعلاف. تشير أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى أن هذه الضغوط البيئية والخدمية حدّت بشكل كبير من الإنتاج المحلي ودفع البعض نحو الاعتماد على المساعدات أو التخلي عن أرزاقهم الزراعية والرعوية.
خاتمة
إن أزمة المياه في الضفة الغربية لم تعد تُختزل في إطار خدماتي أو إنساني، بل أضحت أداة استراتيجية في يد الاحتلال تُستخدم لفرض معادلات السيطرة والهيمنة على الأرض والسكان. فالحرمان الممنهج من الوصول إلى الموارد المائية، وما يتبعه من تدمير للآبار والعيون وشبكات الضخ والري، لا يستهدف تعطيل الحياة اليومية للفلسطينيين وحسب، بل يهدف إلى إعادة تشكيل الجغرافيا السكانية بما يخدم مشروع الضم الاستيطاني الزاحف. إن سياسات “الخنق المائي” هذه تعمّق الأزمات الصحية والمعيشية، وتدفع المزارعين إلى ترك أراضيهم، والأسر إلى التخلي عن مصادر رزقها، ما يفتح الطريق أمام توسع المستوطنات على حساب التجمعات الفلسطينية. ومن خلال تحويل الماء، باعتباره حقًا أساسيًا وحيويًا، إلى وسيلة ابتزاز وضغط.
يرسّخ الاحتلال واقعًا من التهجير الصامت الذي لا يقل خطورة عن أدوات العنف العسكري المباشر. وبذلك يصبح العطش سياسة بحد ذاته؛ سياسة تقوم على تحويل أبسط مقومات البقاء إلى وسيلة لإخضاع الفلسطينيين وإعادة هندسة وجودهم في الضفة الغربية على نحو يخدم أهداف الضم والاقتلاع.
[1] المادة 40 – المياه والمجاري: “اعترافًا بالحاجة إلى تطوير مصادر مياه إضافية لمختلف الاستخدامات، وبضرورة تحديد حقوق الفلسطينيين المائية في الضفة الغربية، فإن “إسرائيل” تعترف بحقوق الفلسطينيين المائية في الضفة الغربية. وسيتم التفاوض حول هذه الحقوق في مفاوضات الوضع النهائي، وتسويتها في اتفاق الوضع الدائم.”