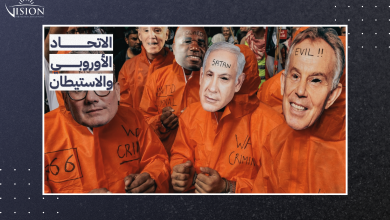العدالة المؤجلة… فلسطين بين تحلل المرجعية الدولية وهيمنة واشنطن

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، اعتمدت الولايات المتّحدة لسنواتٍ وخاصّةً بعد الحرب على العراق عام 2003 سياسةً تجمع بين النفوذ غير المباشر والتحالفات الإقليمية لضمان مصالحها. فعلى الرغم أنَّ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وما تبعها من حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي حتّى اللحظة، فإن واشنطن لم تغير الأطر الاستراتيجية الكبرى لسياستها الخارجية في المنطقة (أهمّها احتواء إيران ودعم إسرائيل والابتعاد عن حلٍّ عادلٍ للقضية الفلسطينية). غير أنّها مثّلت لحظةً فارقةً أعادت رسم ملامح تحولٍ في استراتيجيات الولايات المتّحدة للحفاظ على هيمنتها.
فقد بدا أنّ السياسات الأميركية التقليدية لم تعد كافيةً لمواجهة التحولات الجارية، ما دفع واشنطن إلى تحولٍ واضحٍ في سياستها الإقليمية. في السياق ذاته، تتناول المقالة التحوّلات التي طرأت على السياسة الأميركية بعد السابع من أكتوبر عام 2023، وكيف أثّرت تأثيرًا مباشرًا في تعاطيها مع القضية الفلسطينية، بما يعكس تبدّلاً في منطق الهيمنة والدور.
السياسة الأميركية قبل 7 أكتوبر: تثبيت الأمر الواقع وتعطيل المسار السياسي
اعتمدت الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط، حتّى ما قبل السابع من أكتوبر 2023، على توازنٍ دقيقٍ بين أدوات الردع العسكري وبين أدوات المشروعية السياسية والرمزية. وهو ما يسمى في العلاقات الدولية النظام الدولي القائم على القواعد (rules-based international order)، والدعوة إلى هذا النظام يعتبر حجةً للحفاظ على الاستقرار الدولي، في حين أنّه أداة للتحكم والسيطرة، وهي أداةٌ يحكمها مبدأ “قواعد لكم وليس لنا”.
يُجسّد الدور الأميركي في النظام الدولي مفارقةً جوهريةً: فهو يجمع بين كونه فاعلًا مندمجًا في المنظومة متعددة الأطراف، وكونه في الوقت ذاته قوّةً استثنائيةً تحتفظ لنفسها بحقّ تجاوز هذه المنظومة حين تتعارض مع مصالحها الحيوية.
تبنت الولايات المتّحدة نمطًا من الهيمنة يقوم على الدمج بين القوّة الصلبة (الردع والوجود العسكري) والقوة الناعمة من خلال (التحالفات، الخطاب الحقوقي، النفوذ الثقافي)، ما يمنح سلوكها الخارجي شرعيةً ضمن النظام الدولي. فمن خلال شراكاتٍ استراتيجيةٍ، تُظهر واشنطن التزامًا شكليًا بالقواعد الدولية، مع احتفاظها بهامشٍ واسعٍ لتجاوزها عند تعارضها مع مصالحها الحيوية. تكمن أهمّية هذا النمط من الهيمنة في قدرته على تحقيق استمرارية الهيمنة، وتخفيف كلفة المواجهة المباشرة، إذ يوفّر للولايات المتّحدة أدوات النفوذ طويل الأمد، من دون الحاجة إلى فرض السيطرة بالقوّة الصريحة، ما يعزز موقعها العالمي بوسائل أكثر قبولًا، وأقلّ كلفةً.
تآكل “الكلفة المنخفضة” للهيمنة بعد السابع من أكتوبر
أحدثت عملية المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر عام 2023، وما تلاها تحوّلًا جوهريًا في الطريقة التي فعّلت بها الولايات المتحدة هيمنتها في الشرق الأوسط. فلم يكن الأمر تراجعًا في نفوذها، بل بالأحرى إعادة ترتيب الأولويّات الاستراتيجية، إذ تمثّلت في الانتقال من توازنٍ مدروسٍ بين أدوات الردع والمشروعية، إلى تغليب أدوات الردع المباشر والسيطرة بالقوّة العسكرية. كانت واشنطن قبل ذلك التاريخ حريصةً على دمج الهيمنة العسكرية ضمن إطارٍ مؤسسيٍ يجعلها أكثر قبولًا؛ لكنها، بعد السابع من أكتوبر، اتجهت نحو نمطٍ أكثر وضوحًا وصداميةً في تأكيد هيمنتها، من دون الحاجة إلى تغليف قراراتها بخطابٍ ليبرالي أو تبريراتٍ قانونيةٍ.
بمعنى؛ كانت الهيمنة الأميركية ما قبل السابع من أكتوبر مدعومةً بمنطق “الهيمنة منخفضة الكلفة”، واعتمدت على نمط إسقاط القوّة (Power Projection) الذي اتّسم بالمرونة والردع عن بُعد، إلى نمط حماية القوّة (Power Protection) القائم على الانتشار العسكري المادي في نقاط التماس، بما يعكس تراجع ثقة واشنطن في فعالية الردع غير المباشر وحده. هذا التغير يُشير إلى ميلٍ متزايدٍ لاعتماد القوّة الصلبة اعتمادًا مباشرًا، وهو ما يحمل دلالاتٍ استراتيجيةٍ على اهتزاز قدرة الولايات المتّحدة على إدارة التوازنات بالوسائل غير القسرية.
تراجع قدرة أميركا على إدارة التوازنات الإقليمية الدقيقة
أيضًا؛ أدارت الولايات المتّحدة تناقضات الشرق الأوسط عبر ضبط العلاقات المتوازنة بين أطرافٍ متنافرةٍ، تراجع هذا الدور كـ”مديرٍ للعبة” بعد السابع من أكتوبر، حين انحازت كليًا للاحتلال الإسرائيلي ودعمته في جرائم الإبادة ضدّ الفلسطينيين، وأقحمت نفسها عسكريًا، وساهمت في خلق التوترات في المنطقة. هذا لا يُفقدها النفوذ، لكنه يجعلها فاعلًا منخرطًا لا طرفًا مسيطرًا، يحتفظ بمسافةٍ استراتيجيةٍ عن ديناميات الصراع.
مع تصاعد الإبادة في قطاع غزّة، أصبحت دولًا غربيةً مثل فرنسا وإسبانيا وأيرلندا أكثر جرأةً في انتقاد السياسة الأميركية، كما وجدت دول الجنوب العالمي، مثل جنوب أفريقيا والبرازيل، وتحالفاتٍ أخرى مثّل مجموعة لاهاي، مبررًا للتموضع في موقع القوى الأخلاقية البديلة. هذا يُضعف الإجماع الليبرالي حول القيادة الأميركية، ويغذي نمو أنماطٍ تفتح الباب لتحدياتٍ أوسع أمام موقع أميركا في النظام الدولي.
مرجعيةٌ أميركيةٌ بدل الدولية: كيف تتحكم الوساطة في مسار القضية الفلسطينية
تعاني المرجعية الدولية للقضية الفلسطينية من خللٍ بنيويٍ عميقٍ، نشأ نتيجة ارتهانها الطويل لإرادة “الوسيط” الأميركي، الذي لم يكن محايدًا. فمن المفترض أن تقوم العملية السياسية على مرجعيةٍ دوليةٍ مستقلةٍ، تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتّحدة، لا إلى سياسات طرفٍ ثالثٍ. فحصر المرجعية الدولية في إرادة الوسيط الأميركي جرّدها من مضمونها القانوني والأخلاقي، وحوّلها إلى أداةٍ تكرّس التفوق الإسرائيلي.
ارتهان تنفيذ المرجعية الدولية لإرادة الولايات المتّحدة أدى إلى غياب الإطار السياسي والدبلوماسي الذي يمنح السلطة الفلسطينية وظيفتها الوطنية، التي تتمثّل في قيادة المشروع الوطني، إدارة العملية السياسية، وتمثّيل الشعب الفلسطيني في الساحة الدولية تمثّيلًا فاعلًا وشرعيًا. من دون هذا الإطار، تحولت السلطة إلى كيانٍ إداريٍ بحت، يقوم بمهامٍ يوميةٍ داخل الأراضي الفلسطينية فقط، بعيدًا عن أيّ دورٍ سياسيٍ وطنيٍ قادرٍ على تحقيق أهداف التحرر والاستقلال.
مع تراجع دور السلطة الفلسطينية الرسمي، برز قطاع غزّة رمزًا للمقاومة، ونقطةً محوريةً بالنسبة للقضية الفلسطينية، إذ سلطت عملية السابع من أكتوبر وما بعدها من حرب الإبادة الضوء على قطاع غزّة، ليس منطقةً محاصرةً هامشيةً، بل ممثّلًا حيًا لصمود شعبٍ يواجه حصارًا ومقاومةً غير متكافئةٍ مع آلة الإبادة الإسرائيلية. هذه الأحداث أثارت موجات تضامنٍ عالميةً عبر احتجاجاتٍ شعبيةٍ، حملات مقاطعةٍ، ومواقف ثقافية أعادت بناء الهوية الفلسطينية على أسسٍ نضاليةٍ.
يمكن القول؛ حققت حركات التضامن تحولًا سياسيًا بارزًا لصالح القضية الفلسطينية، فقد أعادت هذه الحركات تعريف مفهوم “الشرعية”، الذي يعني تحديد من يملك الحقّ الحقيقي في تمثيل المظلومين والدفاع عن قضيتهم، سواء عبر الجهات الرسمية التقليدية، مثل الحكومات والمؤسسات الدولية، أو من خلال حركات التضامن الشعبية والمنظمات غير الحكومية التي ترفع صوت المظلومين من خارج هذه الأطر. إضافةً إلى ذلك، ساهمت هذه الحركات في استعادة الاعتبار للقانون الدولي مرجعًا أساسيًا في العلاقات الدولية، متجاوزةً التوافقات/ التواطؤات السياسية التي غالبًا ما تتجاهل حقوق الضحايا.
ساهمت حركات التضامن في تسييسٍ جديدٍ للرأي العام العالمي، فالمواقف المتقدمة في الجامعات والنقابات والعديد من القطاعات، تُظهر أن فئاتٍ مؤثرةً من المجتمع المدني العالمي لم تعد تتماشى مع الموقف الرسمي لحكوماتها. ما يفتح المجال أمام الضغط على صانعي القرار، ويُدخل القضية الفلسطينية في صلب النقاشات المحلية حول السياسة الخارجية.
أما على مستوى التأثير، فإن حركات التضامن لا تغيّر موازين القوى مباشرةً، لكنها تؤدي إلى تحوّلٍ في الوعي العالمي تجاه القضية الفلسطينية، وتُحرج القوى الغربية التي تدّعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا الضغط السياسي والمعنوي بدأ يُترجم في مساراتٍ عمليةٍ، مثل دفع بعض البرلمانات إلى مراجعة صفقات الأسلحة، وفتح ملفاتٍ قانونيةٍ في المحاكم الدولية والمحلية، ومعايير الازدواجية في تطبيق العدالة الدولية، أو حتّى تغيير لغة الخطاب الإعلامي في المؤسسات الكبرى.
السيناريوهات المستقبلية المحتملة للقضية الفلسطينية
مع استخدام الولايات المتّحدة القوّة العارية في المنطقة لتثبيت هيمنتها، ودعم الاحتلال الإسرائيلي غير المحدود، فهي أيضًا دمرت المرجعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بل تعاملت مع هذه المرجعيات باعتبارها نقيضًا لهيمنتها، ومع تصاعد حركات التضامن والاحتجاجات العالمية، فإن سيناريوهات القضية الفلسطينية المستقبلية ستعتمد على نتائج ما ستسقر عليه شكل هيمنة الولايات المتّحدة، وعلى النتائج التي ستحققها حركات التضامن، ومن المتوقع أن تكون السيناريوهات على النحو التالي:
• الدولة الواحدة ثنائية القومية: إقامة دولةٍ واحدةٍ ديمقراطيةٍ مشتركةٍ للفلسطينيين واليهود تتمتع فيها كلّ المكونات بحقوقٍ سياسيةٍ مدنيةٍ متساويةٍ. تقوم هذه الرؤية على فرضية فشل “حلّ الدولتين”، واستحالة الفصل الجغرافي التام. غير أنّ تنفيذها يواجه رفضًا إسرائيليًا واسعًا لخشيته من فقدان “الطابع اليهودي” للدولة، ويتطلّب تفكيكًا كاملاً للاستعمار الاستيطاني، ما يجعل التطبيق أمرًا صعبًا.
• حل الدولتين المُعدّل: يُعيد هذا السيناريو إحياء صيغة “حلّ الدولتين”، لكن بتعديلاتٍ لا تمنح الفلسطينيين دولتهم المنشودة، بحيث يكون لهم كيانٌ من دون سلاح، ولا حدود، مع وجودٍ رمزيٍ في “القدس الشرقية”، وبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى. قد يحظى هذا الخيار بدعمٍ أوروبيٍ باعتباره مسارًا براغماتيًا مرحليًا، لكنه يحافظ على تفوقٍ إسرائيليٍ بنيويٍ ويهمش حقوقًا مركزيةً مثل حقّ العودة والقدس والسيادة الكاملة.
• الكانتونات/الباستونات المُدارة: من خلال فرض الوقائع من دون تسويةٍ نهائية، فبينما تمنح الضفّة الغربية حكمًا ذاتيًا موسعًا، تدار غزّة أمنيًا عبر جهةٍ ثالثةٍ (مثلاً الدولة المصرية أو جهةٍ دوليةٍ) ضمن إطار الاحتواء. تحتفظ إسرائيل بسيطرتها الإستراتيجية من دون إعلان الضم رسميًا، فيما تصبح السلطة الفلسطينية جهازًا إداريًّا هزيلاً.
• اللا حلّ والمقاومة طويلة الأمد: في هذا السيناريو يُستبعد الحل السياسي؛ وتتركز الجهود على مقاومةٍ سياسيةٍ وعسكريةٍ وقانونيةٍ تمتد طويلاً. يراهن هذا المسار على استنزافٍ إسرائيليٍ طويل الأمد، يشبه حروب التحرير السابقة، لكنّه يتطلّب قدرةً استثنائيةً على الصمود الشعبي والتنظيم الداخلي.
يتطلّب السيناريو الأخير، إعادة بناء جسمٍ تمثيليٍ فلسطينيٍ من الصفر، كما يقتضي تأسيس كيانٍ تحرريٍ جديدٍ يجمع الفلسطينيين تحت قيادةٍ موحدةٍ بعيدًا عن الوصاية الأميركية. يواجه هذا الخيار تحدياتٍ تنظيمية وضغوطًا دوليةً، لكنه قد يضخ ديناميكيةً تمثيليةً جديدةً في المشروع الوطني، ويعيد الاعتبار للفلسطينيين في أماكن ودجودهم، ويوحد جهودهم النضالية.
تُظهر الحالة الفلسطينية، كما تتكشف اليوم، حجم التصدع في المنظومة الدولية، إذ لم تعد المرجعيات القائمة قادرة على حفظ الحدّ الأدنى من العدالة والحقوق للفلسطينيين. هذا الخلل لا يكشف أزمة الوساطة الأميركية فحسب، بل يشير إلى تحللٍ أوسع في شرعية النظام الدولي، عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تتحدى موازين القوى، وأولها قضية فلسطين.
تُهيمن الولايات المتّحدة على مسار القضية الفلسطينية، ما يحد من فرص الحلّ العادل، لكن حركات التضامن والنضال العالمي تفتح آفاقًا جديدةً للشرعية والمساءلة، وهذا يشير إلى أنّ مستقبل فلسطين مرتبطٌ بتحولاتٍ جذريةٍ في موازين القوّة الدولية، وتصاعد حركات التضامن والنضال العالمي، وإعادة إحياء جسمٍ نضاليٍ ممثّلٍ للفلسطينيين.
نُشرت هذه المادّة على موقع “العربي الجديد” أولًا بتاريخ 28 يوليو 2025