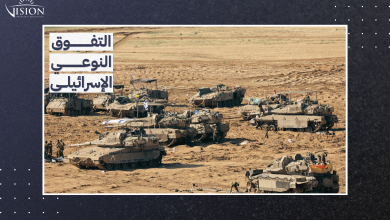المعارضة داخل المؤسسة الإسرائيليّة: مقاربة تحليليّة في حدود النقد وتأثيره

مقدمة
في السنوات الأخيرة، تصاعدت في “إسرائيل” أصوات معارضة تنتقد سياسات حكومة نتنياهو، خصوصًا في ظل تغوّل اليمين القومي والديني، والتعديلات القضائية المثيرة للجدل، وتدهور العلاقة مع الفلسطينيين، وتآكل الأسس الديمقراطية. ورغم أن المعارضة كانت جزءًا أصيلًا من النظام السياسي الإسرائيلي منذ تأسيس الدولة عام 1948، إلا أن ما يميز المرحلة الراهنة هو انخراط شخصيات بارزة من “النواة الصلبة” للمؤسسة الحاكمة، مثل رؤساء سابقين للشاباك والموساد، وقادة عسكريين، وقضاة، في هذا الحراك النقدي.
شهد العقدان الأخيران تحولًا في طبيعة هذه المعارضة، من تحفظ داخل غرف مغلقة، إلى نقد علني يتبنى خطاب “إنقاذ الدولة” من الداخل، كرد فعل على صعود التيارات الدينية–القومية، وتراجع القيم الليبرالية داخل المنظومة؛ وهي قيم ظلت، في جوهرها، تخدم مصالح المشروع الصهيوني، وتوفر له الغطاء “الديمقراطي” أمام العالم.
يقدم هذا التقرير مقاربة نقدية لمواقف هذه الشخصيات، محللًا السياقات التي دفعتها للظهور، وحدود تأثيرها، وطبيعة علاقتها بالنظام السياسي الإسرائيلي ومشروعه الكولونيالي.
خلفيّة: التحوّلات السياسية وصعود اليمين المتطرّف في “إسرائيل”
شهدت “إسرائيل” خلال العقد الأخير تحولات سياسية عميقة أعادت رسم المشهد الحزبي، وخلقت بيئة سياسية واجتماعية برزت فيها أصوات معارضة من داخل المؤسسة نفسها. في صلب هذه التحولات، يبرز استمرار بنيامين نتنياهو في قيادة الحكومات الإسرائيلية منذ عام 2009، باستثناء فترات انقطاع قصيرة، ليصبح بذلك الزعيم الأطول بقاءً في هذا المنصب.
خلال هذه الفترة، رسّخ نتنياهو تحالفًا قويًا بين حزب الليكود وعدد من الأحزاب الدينية والقومية، مثل “شاس” و”يهدوت هتوراه” و”الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت”. ويقوم هذا التحالف على رؤية أيديولوجية متشددة، تستهدف تقويض استقلال الجهاز القضائي داخليًا، وتسريع الاستيطان، وتهميش أي أفق لتسوية سياسية مع الفلسطينيين.
ويمثل صعود هذا اليمين لحظة مفصلية في تطور المشروع الصهيوني، حيث انتقل من مرحلة إدارة الاحتلال وتعزيزه، إلى مرحلة السعي نحو حسم الصراع بصورة نهائية، من خلال تسخير أدوات الدولة لتكريس مشروع “أرض إسرائيل الكاملة”، بما يحمله من مضامين قومية ودينية واجتماعية. ولم يأتِ هذا التحول من فراغ، بل تزامن مع انحسار نفوذ الأحزاب اليسارية والمركزية التقليدية، كـ “العمل” و”ميرتس”، وتفكك المعسكر المناهض لنتنياهو إلى قوى متفرقة وغير متجانسة، ما أضعف قدرتها على بلورة بديل حاكم.
كما ساهمت سلسلة الانتخابات المتكررة بين عامي 2019 و2022، في ترسيخ حالة من الاستقطاب السياسي الحاد، حيث باتت الاصطفافات تُبنى على أساس الموقف من نتنياهو، أكثر من أي برنامج سياسي واضح. في هذا المناخ، بدأت نخب أمنية وقضائية سابقة، ترى في هذه التحولات خطرًا جديًا على البنية الديمقراطية، ودفعها ذلك إلى التعبير العلني عن معارضتها، ليس فقط من منطلق مهني، بل أيضًا انطلاقًا من شعور بمسؤولية تاريخية تجاه مستقبل الدولة ونظامها السياسي.
توفر هذه الخلفية السياسية والهيكلية إطارًا ضروريًا لفهم بروز المعارضة من داخل المؤسسة الإسرائيلية، وتُفسر لماذا اتخذت هذه المعارضة في السنوات الأخيرة، طابعًا أكثر علنية وحدة.
“أبناء المؤسسة” كمصدر معارضة: من هم؟ ولماذا الآن؟
في مواجهة صعود اليمين المتطرف وتحولات النظام السياسي في “إسرائيل”، برزت أصوات معارضة من داخل المؤسسة الأمنية والقضائية، وهي أصوات ليست هامشية، بل تنتمي إلى ما يمكن وصفه بـ “النواة الصلبة” للنظام الحاكم سابقًا. يُطلق على هؤلاء في بعض الأدبيات، تعبير “أبناء المؤسسة” أو “حماة الدولة”، لما يمثلونه من رمزية سلطوية سابقة، ولما راكمته سيرهم المهنية من شرعية ووزن جماهيري. ونعرض فيما يلي بعض هذه النماذج:
- قادة سابقون في الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية
على صعيد المؤسسة، شغل كل من يوفال ديسكن (2005–2011) وعامي أيلون (1996–2000) منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، واليوم يجسدان نموذجًا لما يُعرف بـ”النقد من الداخل”، حيث انتقلا بعد تقاعدهما إلى توجيه انتقادات صريحة للقيادة السياسية، محذرين من انزلاق الدولة نحو تفكك داخلي وانحراف سلطوي خطير.
منذ خروجه من المنصب، حذّر ديسكن من تفكك المجتمع الإسرائيلي بفعل تغلغل النزعة الدينية القومية في مؤسسات الحكم، ومن تحوّل “إسرائيل” إلى “دولة يهودية متطرفة”. وانتقد الازدواجية تجاه الفلسطينيين، ورفض استدعاء مفاهيم دينية لتبرير السياسات. كما اتهم نتنياهو بالتصرف بدوافع “مسيحانية”– أي الاعتقاد بمجيء المخلّص المنتظر في نهاية الزمان لإنقاذ شعب “إسرائيل”– واعتبارها دافعًا للقرار السياسي. ووصف الحكومة بـ “حكومة الإرهاب“، محذرًا من صدام داخلي محتمل على خلفية تفكيك الجهاز القضائي. وأدان أيضًا عنف المستوطنين، داعيًا إلى محاسبتهم.
أما أيلون، فتبنى خطاب “اليسار الأمني”، الذي يدمج الخلفية الأمنية مع الدعوة لتسوية سياسية. وفي 2003، أطلق مع سري نسيبة مبادرة لحل الدولتين، محاولًا خلق توافق شعبي على أساس حدود 1967. وقد عبر لاحقًا عن خشيته من تحول الشاباك إلى أداة احتلال دائم، محذرًا من أن الديمقراطية لا يمكن أن تصمد في واقع من العنف والسيطرة. وفي السنوات الأخيرة، شدد على أن “إسرائيل” تواجه “أزمة وجودية“، محذرًا من خطر “عنف مدني واسع النطاق”، في حال استمرت محاولات تقويض القضاء، وإعادة هندسة مؤسسات الدولة.
ومثّل تمير باردو، الذي ترأس “الموساد” بين 2011 و2016، حالة مفصلية في انخراط “رجال الظل” في النقاش العام. فعلى الرغم من الطابع السري لعمل الجهاز، خرج باردو بتصريحات علنية اتهم فيها الحكومة بتهديد النظام الديمقراطي، ووصف سياسات الضم والاستيطان بأنها شكل من أشكال “الفصل العنصري“، ما أثار جدلًا واسعًا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، واصل باردو انتقاداته الحادة، فاعتبر أن استئناف الحرب “فتح بوابات الجحيم” على الرهائن، متهمًا الحكومة بإهمالهم وخداع الجمهور. وفي مقابلة لاحقة، وصف الحرب بأنها “هدر للوقت والأرواح والمستقبل”. كما شارك في نيسان/ إبريل 2025 بالتوقيع على رسالة مع أكثر من 250 من كبار مسؤولي الأمن، طالبوا بوقف العمليات العسكرية، وتركيز الجهود على إنقاذ الرهائن بدلًا من مواصلة التصعيد.
وبخصوص المؤسسة العسكرية، برز كل من غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الأسبق (2015–2019)، وموشيه يعالون، وزير الدفاع الأسبق ورئيس الأركان (2002–2005)، كأصوات معارضة بارزة من داخل المؤسسة العسكرية. فقد وجه آيزنكوت انتقادات حادة لحكومة نتنياهو، خصوصًا في ظل التحقيقات المرتبطة بقضية “قطر غيت“، التي طالت مقربين من مكتب رئيس الحكومة، كما شكك في الرواية الرسمية بشأن الحرب على غزة، متهمًا الحكومة بتضليل الرأي العام.
من جهته، عبر يعالون عن رفضه لطريقة إدارة الحرب، معتبرًا أن الحكومة تفتقر إلى رؤية إستراتيجية متماسكة، وأن ضعف التنسيق بين المؤسسات الأمنية والسياسية، أضرّ بالردع وأساء إلى مكانة “إسرائيل” الدولية. كما انتقد تعاطي الحكومة مع ملف الأسرى، واصفًا إياه بالتراخي والخضوع لحسابات سياسية. وفي لهجة غير مسبوقة، وصف يعالون حكومة نتنياهو بـ “النازية”، محذرًا من مستقبل قاتم يهدد “إسرائيل” من الداخل، ودعا إلى عصيان مدني لمواجهة ما اعتبره انحرافًا سلطويًا خطيرًا.
- قضاة سابقون
ظهرت مواقف نقدية قوية من داخل الجهاز القضائي الإسرائيلي، لا سيّما من قضاة سابقين في المحكمة العليا، على خلفية ما يُعرف بـ”خطة إضعاف القضاء“. من أبرز هؤلاء دوريت بينيش، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، التي اتهمت الحكومة بالسعي إلى “التخلص من مبدأ فصل السلطات وتقويض استقلال القضاء”، ووصفت الإصلاحات بأنها “وصفة لمحو الديمقراطية”، محذّرة من تركيز السلطة في يد الحكومة وحدها. كما أصدر 18 قاضيًا سابقًا في المحكمة العليا، بيانًا موحدًا أكدوا فيه أن هذه الإصلاحات، تمثل “تهديدًا جسيمًا للنظام القضائي وللطبيعة الديمقراطية لإسرائيل”، محذرين من أنها قد تُقيّد حماية الحقوق الأساسية. يُعدّ هذا التدخل العلني من قبل قضاة سابقين، حدثًا غير مسبوق في تاريخ الجهاز القضائي الإسرائيلي، ويعكس حالة طوارئ يرون أنها تهدد استقلال القضاء، ومكانة المحكمة العليا كأساس للحكم الدستوري.
- رؤساء الحكومة السابقون
برزت مواقف معارضة قوية لحكومة نتنياهو من قبل عدد من رؤساء الحكومات السابقين، الذين انتقدوا بشدة السياسات الداخلية والخارجية، خاصة إدارة الحرب على غزة والتعديلات القضائية.
فقد عبر نفتالي بينيت، الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية ما بين 2021- 2022، عن رفضه الحاد لمشروع قانون “إلغاء معيار المعقولية”، واصفًا إياه بأنه “تدمير للديمقراطية” و”تصفية للرقابة القضائية”. كما دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف التيارات، منتقدًا أداء الحكومة في الحرب على غزة، وواصفًا إياها بـ “غير الفعالة وغير الشفافة”، مشددًا على ضرورة تغيير إستراتيجي في التعامل مع حماس، يوازن بين الردع وحماية المدنيين.
أما يائير لبيد، الذي شغل رئاسة الحكومة لفترة انتقالية في 2022، فقد هاجم بشدة إدارة الحرب، متهمًا الحكومة بانعدام الكفاءة والشفافية، ودعا إلى حكومة بديلة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، وإحياء مسار التسوية مع الفلسطينيين.
بدوره، برز إيهود أولمرت، الذي ترأس الحكومة ما بين 2006- 2009، كأحد الأصوات الناقدة للحكومة الحالية، متهمًا إياها بأنها “عصابة إجرامية” تهدد النظام السياسي والديمقراطية في “إسرائيل”.
أما إيهود باراك، رئيس الحكومة الإسرائيلية ما بين 1999- 2001، فتبنى خطابًا أكثر تصعيدًا، داعيًا إلى “عصيان مدني” و”انقلاب سياسي” لإسقاط حكومة نتنياهو، محذرًا من انزلاق “إسرائيل” نحو الفاشية الدينية، وتفكك الدولة من الداخل.
تفكيك نقدي لمواقف “أبناء المؤسسة” المعارضين
تعكس مواقف قادة الأجهزة الأمنية السابقين – مثل يوفال ديسكن، عامي أيلون، وتمير باردو – نمطًا من “النقد من الداخل”، يقوم على تحذيرات شديدة اللهجة من انزلاق الدولة نحو التفكك أو السلطوية، لكنه لا يتجاوز في جوهره السعي إلى ترميم المشروع الصهيوني، لا مساءلته. فخطابهم، وإن بدا راديكاليًا في نبرته، يظل محكومًا بمنطق وظيفي يركز على الأداء والأدوات، لا على البنية الأيديولوجية أو الأخلاقية للنظام. ويصبح هذا التناقض أكثر حدة حين يُقارن خطابهم الحالي بسجلهم المهني المثقل بانتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين خلال إدارتهم لأجهزة الشاباك والموساد، ما يطرح تساؤلًا حول دوافع هذا النقد: هل يعكس يقظة ضمير متأخرة، أم أنه تحرر انتقائي من قيود الموقع بعد التقاعد؟
ينسحب هذا النموذج كذلك على قيادات المؤسسة العسكرية مثل موشيه يعالون وغادي آيزنكوت، اللذين باتا يُعرفان بانتقاد سياسات الحكومة الحالية، رغم دورهما المحوري سابقًا في تكريس الإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية المبنية على القمع والتدمير. فآيزنكوت هو واضع “عقيدة الضاحية” التي تبرر الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين، ويعالون من أبرز رموز المقاربة العسكرية التي ترفض أي تسوية سياسية جادة. بالتالي، فإن خطابهما المعارض اليوم لا ينبثق من مراجعة شاملة، بل من رغبة في إعادة إنتاج المشروع ذاته ضمن نموذج أكثر “انضباطًا”، لا أكثر عدالة.
وبالمثل، فإن مواقف قضاة المحكمة العليا السابقين، الذين تصدوا لخطة “إضعاف القضاء”، لا تمثل خروجًا على المنظومة، بل دفاعًا عن صيغتها المؤسسية. فالمحكمة، في مسيرتها، لم تكن يومًا أداة لمساءلة النظام، بل إحدى ركائزه القانونية في شرعنة الاحتلال، وهدم البيوت، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم. اعتراض هؤلاء القضاة ينبع من الخوف على توازنات السلطة لا من قناعة بضرورة تفكيك المنظومة أو تصحيح علاقاتها الاستعمارية.
ولا يختلف المشهد عند التطرّق إلى رؤساء حكومة سابقين مثل إيهود أولمرت ويائير لبيد وإيهود باراك، الذين باتوا من أبرز الأصوات المعارضة في المشهد الإسرائيلي الراهن. فقد شارك أولمرت في قيادة حرب لبنان الثانية وعدوان “الرصاص المصبوب” على غزة (2008–2009)، بينما أيد لبيد معظم العمليات العسكرية في الضفة وغزة خلال وجوده في الحكومة، محافظًا على خطاب أمني تقليدي لا يخرج عن الثوابت. أما باراك، فقد كان أحد أبرز مهندسي السياسات العسكرية الإسرائيلية، وارتبط اسمه بقرارات مفصلية، من بينها انتفاضة الأقصى وعدوان “السور الواقي” على الضفة الغربية، ناهيك عن دوره في عمليات اغتيال وتصفية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها خلال توليه رئاسة الحكومة ووزارة الأمن. وعليه، فإن التحاق هؤلاء بصفوف المعارضة لا يعكس في جوهره مراجعة سياسية أو أخلاقية، بل تحولات في التموضع داخل الخارطة السلطوية، تفرضها الظروف والتوازنات، لا قناعات مبدئية.
إن هذا المشهد المركب يفرض إعادة نظر في مفهوم “المعارضة المؤسسية” داخل “إسرائيل”، لا بوصفها مشروعًا بديلًا، بل تجليًا لصراع داخلي على إدارة السلطة دون المساس بجوهر النظام. فغالبًا ما يُروّج لهذه الأصوات كبديل، بينما هي في الحقيقة تعبير عن خلاف داخل النخبة حول أدوات الحكم وتوزيع القوة، لا حول طبيعة الدولة أو مشروعها الصهيوني. ومن ثم، فإن هذه المعارضة، رغم ثقلها الرمزي وحضورها الإعلامي، تبقى امتدادًا لمن أسّس النظام وصاغ آلياته القمعية، لا قطيعة معه. إنها باختصار: معارضة من داخل المؤسسة – بين نقد الأداء وتثبيت الهيمنة.
حدود التأثير وفعالية المعارضة
رغم الزخم الذي حظيت به الأصوات المعارضة في “إسرائيل”، سواء من داخل المؤسسة أو في الشارع، فإن قدرتها على إحداث تغيير جذري تبقى محدودة، بسبب تموضعها داخل الإجماع الصهيوني لا خارجه. إذ ثمة قضايا تشكل نقاط اتفاق شبه كاملة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، بل وحتى بين المنتقدين من “النواة الصلبة” للمؤسسة الأمنية والقضائية. في مقدمة هذه القضايا، تأتي الحرب على إيران ومنعها من امتلاك سلاح نووي، بوصفها “تهديدًا وجوديًا” يفوق الخلافات السياسية. كما ينسحب هذا التوافق على مفاهيم “أمن الدولة”، و”الردع العسكري”، و”إدارة الصراع مع الفلسطينيين” من منظور أمني صرف.
حتى أكثر الأصوات حدة في النقد تبقى متمسكة بهذا الإطار، ولا تختلف عن السلطة القائمة في الأهداف، بل فقط في الوسائل والتكتيكات. وهذا ما يجعل المعارضة أقرب إلى تصحيح داخلي للنظام لا مساءلة لبنيته.
جوهر الخلاف بين هذه التيارات لا يدور حول وظيفة الدولة أو مشروعها الكولونيالي، بل حول شكل الحكم وطبيعته. ففي حين تسعى النخب الليبرالية–العلمانية إلى الحفاظ على “إسرائيل” كدولة يهودية “ديمقراطية” وفق النموذج الغربي (لليهود فقط)، تدفع النخب اليمينية–القومية والدينية نحو إعادة تعريف الدولة على أسس توراتية، بما يشمل تحويلها إلى كيان ديني–ثيوقراطي (“دولة هلاخاه”). بعض التيارات في الصهيونية الدينية تذهب أبعد من ذلك، بالدعوة إلى إلغاء النموذج الجمهوري، وإقامة “مملكة إسرائيل” تحكمها سلطة ملكية مستمدة من الشريعة اليهودية.
وفي أوقات التهديدات الأمنية أو الحروب، تتراجع المعارضة بشكل ملحوظ تحت عباءة “الوحدة الوطنية”، ما يكرس حقيقة أن جوهر الخلاف يدور حول توازن السلطات داخل النظام، لا حول بنيته الاستعمارية أو طبيعة علاقته بالفلسطينيين. هذا التمايز يفقد المعارضة القدرة على تشكيل بديل جذري، ويجعلها تلعب دور صمام أمان للنظام، لا أداة لتفكيكه أو إعادة بنائه.
ورغم الحراك الشعبي الواسع الذي صاحب خطة إضعاف القضاء، فإن نتائجه السياسية ظلت هامشية؛ إذ واصلت الحكومة تنفيذ أجندتها دون تراجع حقيقي. تنوعت أدوات المعارضة بين المقالات، والتصريحات، والمشاركة في التظاهرات، لكنها ظلت محكومة بسقف “المهني المسؤول” البعيد عن الانخراط الحزبي المباشر، ما حد من قدرتها على تحويل المواقف إلى قوة سياسية مؤثرة.
هذه المعارضة تحظى باهتمام إعلامي واسع، وتلقى صدًى خاصًا لدى فئات من الطبقة الوسطى الليبرالية، التي ترى في الأزمة السياسية تهديدًا لتوازن النظام الذي يكفل امتيازاتها، لا فرصة لتفكيكه أو مساءلته. في المقابل، ينظر جمهور اليمين إلى هذه الأصوات باعتبارها امتدادًا لـ “الدولة العميقة” التي تُعرقل إرادة الناخب، وهو ما يقيّد انتشارها خارج دوائر النخبة. بهذا المعنى، يعكس حضورها مفهوم “الدولة العميقة” في السياق الإسرائيلي، لا بوصفها مؤامرة، بل كمؤسسة تسعى لحماية النظام لا إلى تغييره.
أما على الصعيد الفلسطيني، تتجنب المعارضة الإسرائيلية عادةً نقض جذور السيطرة الاستعمارية، مكتفية بنقد السياسات بوصفها “إخفاقات إدارية”، أو نتائج لغياب رؤية سياسية. وحتى في مواقفها الأكثر تقدمًا، لا تتعدّى الدعوات حدود الحلول الأمنية أو السياسية، التي تحافظ على الطابع اليهودي للدولة، وتُعيد إنتاج التراتبية القائمة. أما قضايا الفلسطينيين في الداخل، من العنف الشرطي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، إلى التمييز البنيوي والتجريم السياسي، فتظل مهمشة وغير محلولة، حيث يُنظر إليهم كمجموعة يُراد احتواؤها وليس إشراكها، ويُعاملون كعبء ديمغرافي لا كطرف سياسي شريك.
من هنا، فإن ما تخلقه هذه الأصوات من كسر نسبي للصورة الأحادية في المشهد الإسرائيلي لا يرتقي إلى مستوى البديل السياسي. فالمعارضة تظل قوة تصحيحية تتحرك ضمن الإجماع الصهيوني، ولا تسعى إلى تفكيكه أو مساءلته عن جوهره العرقي والاستيطاني. قدرتها على التأثير الفعلي مرهونة بارتباطها بتحالفات تتجاوز منطق “الإنقاذ من الداخل”، وتتجه نحو مساءلة شاملة للبنية الحاكمة.
لقد كانت المعارضة جزءًا أصيلًا من البنية السياسية الإسرائيلية منذ تأسيس الدولة عام 1948، لكنها لم تخرج يومًا عن الإطار اليهودي–الصهيوني. فرغم تعدديتها الداخلية بين اليمين واليسار، والديني والعلماني، والأمني والليبرالي، فإنها تظل تعددية تخص اليهود وحدهم، وتُقصي الفلسطينيين من معادلة المواطنة الفعلية والتمثيل السياسي الحقيقي. هذا النموذج من “الديمقراطية اليهودية” مكّن من تداول السلطة وحرية نسبية للإعلام والمعارضة، لكنه لم ينتج معارضة بنيوية تطعن في منطق الدولة أو في وظيفتها الاستعمارية.
وعليه، فالمعارضة في “إسرائيل”، من منظور نقدي، لم تكن في يوم من الأيام قوة تغيير جذري، بل أداة لإدارة التوازنات الداخلية، وتعديل السياسات ضمن الثوابت، دون المساس بجوهر النظام القائم على الامتيازات العرقية والسيطرة على السكان الأصليين.
خاتمة
مع تصاعد صوت المعارضة من داخل المؤسسة الأمنية والقضائية في “إسرائيل”، يبرز سؤال جوهري: هل تمثل هذه الأصوات مؤشرًا على تحول جذري يخدم الفلسطينيين والعرب والمعارضين الدوليين لسياسات “إسرائيل”، أم أنها مجرد محاولة لإنقاذ المشروع الصهيوني من أزماته الداخلية؟
تكشف القراءة التحليلية لهذا التقرير، أن هذه المعارضة، رغم نبرتها الحادة ووزنها الرمزي، لا تنقلب على النظام القائم بقدر ما تسعى إلى تصويبه من الداخل. فهي صادرة عن قلب المؤسسة، وتتحرك ضمن سقوف تحافظ على أسس الهيمنة، دون مساءلة جوهرية للبنية الاستعمارية، أو للعلاقة مع الفلسطينيين.
لذا، لا يمكن بناء مشروع سياسي مناهض للمشروع الصهيوني اعتمادًا على هذه الأصوات، لا سيما وأنها تدور في فلكه ولا تخرج من عباءته، بل تظل جزءًا من منظومته السياسية والأمنية. وعليه، يظل الرهان على هذه الأصوات كمؤشر لتحول يخدم قضايا التحرر والعدالة، محدودًا، بل قد يكون معدومًا في جوهره، ما لم يقترن بمسار نقدي أوسع يُسائل المنظومة برمتها، لا يقتصر على صيغ إدارتها فقط.