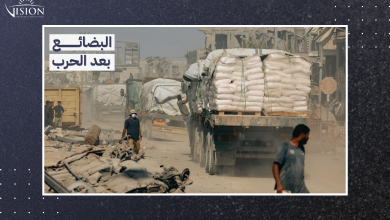موتٌ بلا طقوس: كيف يتحكّم الاحتلال في ممارسات الوداع والدفن عند الفلسطينيّين؟

سجود عوايص
على مدى عمر الإبادة في غزّة، عملت الآلة العسكرية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية على تحطيم أشكال الحياة عند الفلسطينيين، وتكثيف عقودٍ من القمع والممارسات العنصرية تحت مبرّرات انتقامية بعد نزع صفة الآدميّة عنهم، وجعل خيار إفنائهم مقبولًا. وقد أعْمَلَ المحتل جهده في التحكّم في الفلسطينيين، منذ اللحظة التي تسبق الولادة، وحتى اللحظة التي تتجاوز الموت.
يأتي هذا التقرير مسلّطًا الضوء على الموت، لا باعتباره خطًا فاصلًا يُنهي حياة الفلسطيني، بل بصفته ساحةً أخرى يمارس فيها الاحتلال عبثه وتخريبه بحق ما بقي من أجساد الفلسطينيين. يكشف التقرير التحوّلات التي طرأت على مراسم التشييع والدفن في فلسطين، بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي، بدءًا من النكبة الأولى عام 1948م، مرورًا بتاريخ الفلسطينيين الطويل مع الممارسات القمعيّة للاحتلال، وصولًا إلى النكبة بنسختها المحدّثة 2023-2025، والسياسة المكثّفة لانتهاك الأجساد، وكيف انعكس الانتهاك الذي أصبح بُنية استعمارية قائمة بذاتها، على ممارسات الدفن والوداع للشهداء الفلسطينيين.
وداعٌ مؤجّل وجثامين حبيسة
بالنسبة للفلسطينيين، فالموت له قاموسه الخاص الذي يتكرّر بينهم دون اتفاق، ويخفي داخل نفوسهم ألم مواجهته، وإذا كان الموت خاتمةً لمرحلة أو لحظة في مواجهة الاحتلال نفسه، حينها يغدو من الصعب تعريفه بوصفه “نهايةً لحياة”، بل يغدو بدايةً لمرحلة أخرى، تتطلع إلى أن تملأ الوادي سنابل.
يتكرر ذلك في الوعي الفلسطيني العام في العديد من المترادفات الشعبية والثقافية والدينية، التي تتردّد في لحظات العزاء والمواساة بدْءًا من “بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون”، و”لا بُكاء على الشهداء”، و”الشهداء لا يموتون، دماؤهم تزهر ثورة”، و”الشهداء أكرم منا جميعًا” وغيرها، ونتيجة لهذا المكنون الذي كثيرًا ما كان حافزًا لمراحل أخرى في النضال والصمود والمواجهة، كان الاحتلال معنيًا باستهداف الموت نفسه. بدءًا من لحظته الأولى، مرورًا بألمه ووداعه، وحتى باب القبر، وفي أحيانٍ كثيرة أخرى، تجاوز الاستهداف باب القبر إلى رفات الجسد ومعالم الضريح، هذا الاستهداف لم يرتبط يومًا بفترة زمنية معينة في تاريخ القضية الفلسطينية، بل كان دومًا مرافقًا لسياسات السيطرة والتحكم، بوصفه تحكمًا في رمزية الشهداء، وقمعًا لتجددهم، وعقابًا جماعيًا باعثًا على الرعب لمن حولهم وخلفهم.
فمع تاريخها المبكر في استهداف الموتى الفلسطينيين، بدأت الهجمات المنظمة للعصابات الصهيونية على البلدات الفلسطينية -قبل وإبان النكبة-، وأقدمت خلالها على تمزيق جثامين الفلسطينيين، وبتر أجزاء من أجسادهم، وإحراق جثامينهم، ورميها في الآبار وبرك المياه، وتجريف المقابر والأضرحة، والبناء عليها، في كلٍ من دير ياسين والطنطورة والدوايمة وغيرها.
واستمر الاحتلال في سياساته وصولًا إلى مرحلة “النكسة”، والتي انتهت باحتلال “إسرائيل” للضفة الغربية وقطاع غزة، ليضيف الاحتلال في هذه المرحلة سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين بشكلٍ رسمي، وأُنشئت على إثرها “مقابر الأرقام”، التي استُخدمت لاحتجاز جثامين شهداء العمليات الفدائيّة، ومنع تشييعهم.
ومع تطاول سنوات الاحتلال، وارتفاع عمليات احتجاز الاحتلال للجثامين، حاول الفلسطينيون إنتاج رد فعل مقاوم لذلك، ومن الحوادث التاريخية؛ ما جرى مع جثمان الشهيد حاتم السيسي الذي استُشهد في 9/12/1987، ثم أُخفي تحت أسِرّة مشفى الشفاء في غزة، وهُرّب إلى بيته الذي داهمه الاحتلال بعد ذلك، ثم هُرّب منه إلى بيت الجيران، وتم تشييع نعش فارغ لتضليل الاحتلال ريثما يتم دفنه على عجل وحادثة تهريب جثمان الشهيد حسني عيّاد الذي استشهد في مشفى رام الله، فهُرّب جثمانه من بيت إلى بيت، حتى تمكّنوا من تأمين سيارة توصله إلى أهله في بلدة سلواد، وأسندوه داخلها كأنه راكب عادي في رحلةٍ استمرت خمس ساعات عبر الجبال لتجاوز حواجز الاحتلال، حتى تمكنوا من دفنه.
ارتفعت لاحقًا وتيرة احتجاز الأجساد، فمنذ اندلاع انتفاضة السكاكين عام 2015، أصبح أسر جثامين شهداء العمليات الفردية، ومنع أهاليهم من فتح بيوت عزاءٍ لهم روتينًا إسرائيليًّا، وحتى عندما سُلّمت بعض الجثامين إلى عائلاتها، اشتُرِطَ الدفن ليلًا، بمشاركة عدد قليل من أفراد العائلة، ومن دون مسيرات شعبية، ودفن الجثمان من دون إخضاعه للتشريح، ما حدا ببعض العائلات لرفض استلام جثامين أبنائها، كما في حالة الشهيدة أشرقت قطناني.
ثم تعاظمت إهانة الجسد الفلسطيني ومحاصرة خاتمته، بوضع الجثامين في الثلاجات، وتسليمها للعائلات مجمدة وفي حالةٍ غير إنسانية، كما في حالة الشهيد بسيم صلاح الذي سلمه الاحتلال إلى عائلته بجسدٍ مجمّد منحنٍ بزاوية 45 درجة، وبقدمين منحنيتين بزاوية 60 درجة، ما دفع عائلته لانتظار “ذوبان” جسده لبضع ساعات قبل تشييعه ودفنه.
وبالنظر إلى حصيلة أعداد الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، فما بين عام 2015 وحتى 2019، كان عدد الشهداء المحتجزين في الثلاجات يصل إلى 72 شهيدًا، ارتفع عام 2021 إلى 93 شهيدًا، وعام 2022 إلى 105 شهداء. أما المحتجزون في مقابر الأرقام، فقد وصل عددهم حتى نهاية عام 2022 إلى 256 شهيدًا ، فيما أعلن الاحتلال عن فقدانه جثمان 121 شهيدًا، بدعوى أن شركات خاصة كانت مسؤولة عن الدفن، وأن إحداها أغلقت وتخلصت من أرشيفها.
بالنتيجة فإن التحكم في الموت، وإهانة الروح والجسد، ومصادرة كرامة الشهداء، وسرقة لحظات الوداع الأخيرة لعائلاتهم، هي سياسة ثابتة في النهج الاستعماري الإسرائيلي، تعمل بوتيرة واحدة مع الترانسفير والاعتقال والهدم والمصادرة وغيرها، وإن كانت تحمل نتائجها أبعادًا مختلفة ترتكز على الإمعان في قطع مسار التجدد وتواصل الانتهاك لما بعد الموت لكل من يقف في وجه المنظومة الاستعمارية، إلا أنّها تهدف إلى الغرض نفسه في تعزيز سطوة المحتل وإرهاب الروح الفلسطينية الجمعية، وإظهار تحكّمٍ غير منقطع.
المحو عبر الإبادة: لا وداع لا كفن ولا ضريح
مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما رافقها من حملاتٍ عسكرية متواصلة على الضفة الغربية، وصلت سياسة استهداف طقوس الموت، إلى مراحل غير مسبوقة لتصبح جزءًا من البُنية الاستعمارية الإسرائيلية نفسها، من خلال عدة مظاهر: أولها؛ كثافة الموت، وثانيها؛ القوة النارية، وثالثها؛ الانتشال، ورابعها؛ استلاب كرامة الجسد اجتماعيًا ونفسيًا، وأخيرًا؛ اقتلاع الجسد من مرقده الأخير، ولكل منها تفاصيله.
تظهر “كثافة الموت” من خلال الارتفاع السريع والمهول في أعداد الشهداء، والذي فاق 51 ألف شهيد، هدف إلى ضرب النسيج المجتمعي للفلسطينيين، فاستُهدفت عائلات بأكملها، ووصل عدد العائلات التي مُحيت من السجل المدني بالكامل، حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، 1410 عائلات، قوامها 5444 شخصًا، بالإضافة إلى 3463 عائلة أبيدت بالكامل، ولم يتبق منها سوى ناجٍ واحد، وصل عدد أفرادها إلى 7934 فلسطينيًا، وهو ما يندرج في إطار “إبادة الأنساب ومحوها”
ومع صدمة الحرب الأولى، بدأ الفلسطينيون اختبار أساليب جديدة في استهداف طقوس الموت، مثل اختفاء الأكفان، وصعوبة توديع الراحلين أو الصلاة الجماعية عليهم، واستحالة تنظيم مراسم دفنٍ لائقة بالشهداء حتى على مستوى العائلة المصغّرة، واكتظاظ المقابر وعدم القدرة على تجهيزها، لا سيما مع تركز اهتمام الخدمات البلدية والهندسية (الحفر والتعبيد) على استخراج الجثامين العالقة تحت طبقات الردم والركام.
فعلى صعيد اختفاء الأكفان، اضطُرت الطواقم الطبية لاستخدام الملاءات والأغطية والملابس الممزقة، والستائر والأقمشة الملونة، وأكياس البلاستيك السوداء والبيضاء والزرقاء كأكفانٍ بديلة، تستُر بها الأجساد وتُسبغ عليها بقية من كرامة الموت.
أما مراسم الوداع والصلاة، فقد اتخذت شكلًا جماعيًا، وانزواءً مكانيًا، أمام الأعداد المتزايدة التي فاقت قُدرة ثلاجات الموتى على الاحتمال، ومساحات المشافي على الاستيعاب، وهُنا غُيّب الوداع مع استحالة التعرّف والوصول إلى الجثامين، فالقصف السجادي المكثف الذي طال القطاع حال دون التعرف على كثيرٍ من الضحايا. ما أنتج شكلًا جديدًا من الدفن، عبر استحداث المقابر الجماعية، وقد مارسه الفلسطينيون في محاولة لمواراة الشهداء بسرعة بسبب استمرار القصف، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن الاحتلال نفسه قام بإنشاء مقابر جماعية أثناء العمليات العسكرية، خاصة في محيط المشافي (الشفاء وناصر والإندونيسي مثالًا)، والبؤر العسكرية المُحدثة، وذلك لهدف التغطية على جرائمه، وحماية لجنوده خوفًا من انتشار الأمراض والأوبئة، فراكم الجثث وغطاها بالتراب بشكل لا يليق بآدمية البشر.
وإن كان الحصول على كفنٍ أبيض يُعدّ امتيازًا، فإن القدرة على توديع الراحلين، واحتضان أجسادهم كاملة، كانت ميزةً لا تقل أهمية عن الكفن، لا سيما وأنّ انقطاع خطوط الاتصال بين العائلات، وسقوط ضحايا في الطرقات والأماكن العامة، جعل مصطلح “شهيد مجهول” دارجًا جدًا، ومفزعًا بالنسبة للفلسطينيين، حيث دُفن في أول أسبوعين من الحرب 43 شهيدًا مجهول الهوية، وخلال الثلاثة أشهر الأولى ارتفع العدد إلى 281 شهيدًا، ومع وصول الحرب إلى منتصف عامها الأول وصل عددهم إلى 1400 شهيد
أما القوة النارية ثلاثية الأبعاد، المتمثلة بالقصف الجوي والبحري والبري، فقد تجاوزت سعيها في تحقيق الموت، إلى محو بقايا الأجساد بأكملها، حيث أنتجت رفاتًا متناثرة لألوف من الشهداء الفلسطينيين، وغيّبت مفهوم “الجثمان” تمامًا عن وصفهم، لصالح مصطلح “الأشلاء” الذي ترافق مع كل قصف، ونتج عنه ميكانيزم فلسطيني غريب في تعريف حدود الجسد في ظل غياب ملامحه وأبعاده الطبيعية، يقوم على وزن الأشلاء وتحديد تبعيتها وفقًا لوزن الجسد المتشظي نفسه [1]، وهُنا غاب الكفن تمامًا واستُبدل بأكياس بلاستيكية وغذائية، وحتى بحقائب مدرسية. وقد أكدت بيانات الدفاع المدني في غزة تبخر أكثر من 2842 شهيدًا، نتيجة استخدام قنابل تُطلق حرارة عالية لحظة الانفجار، كفيلة بتذويب المعادن وتفتيت الأجساد إلى دقائق صغيرة تتطاير مع رماد الاستهداف وتنطفئ مع حرائقه، وهو ما محا أي أثر للشهداء وأجسادهم.
أمّا ما يتعلق بتدمير بنية الانتشال والوصول، فيتوافق مع المبدأ الاستعماري الهادف إلى خلق الفوضى وتغذيتها، واقتناص الاستقرار والروتين والقضاء عليه، بما يُمهّد لأشكالٍ أخرى من الهيمنة، تبدأ بالسيطرة النفسية وتمتد إلى التهجير، فخلال الحرب سعى الاحتلال لاستهداف المنظومة الصحية والخدماتية، فقطع الوقود والكهرباء، وقصف طواقم الإسعاف والدفاع المدني، وكرر استهدافه للمناطق المستهدفة سابقًا بعد تجمهر السُكان حولها.
وحتى في الهدنة الأخيرة، لم يُصار إلى تحقيق الكثير من رفاهية -ما بعد الموت- لهم، فالمعدّات الموجودة لرفع الركام واستخراج الرفات لا تتجاوز الـ 10 جرافات في عموم القطاع، ما يجعل الانتشال واقعًا تحت مقصلة وقتٍ، يُقدر الخبراء أن يتطاول إلى قرابة 3 سنوات.
وهُنا، يعتبر الاحتلال الجنائز مظهرًا من مظاهر الحياة الاعتيادية، فيصب جميع أدواته الاستعمارية في تعطيله، بدءًا من التهجير، ومرورًا بالحصار وقطع الكهرباء والماء والدواء، وإغلاق المعابر، واستهداف التجمعات، والأعيان المدنية مثل المشافي ودور الجنازات والمقابر والمساجد، ما أفرز استيلاءً على الطقوس الدينية والاجتماعية المرتبطة بالموت، حتى تلك الخاصة بالجانب النسوي من المواساة والتشاركية في بيوت العزاء، على الرغم من ذلك، فإنّ عموميّة تجربة الموت في غزة، لم تساهم في التخفيف من مرارته، أو تحويله لحدث عاديّ بالنسبة لأيٍ من الفلسطينيين، بل ظل دومًا مرتبطًا بالاحتلال في مقابل رغبة شرسةٍ منهم في انتزاع الحياة والتشبث به، والاستمتاع بالقليل منها.
أمّا المظهر الرابع، المتمثّل باستلاب كرامة الجسد اجتماعيًا ونفسيًا، فقد بلغ أشده بالاجتياح البري، الذي فكك البنية الاجتماعية والنفسية والمؤسساتية في القطاع؛ نتيجة لاستهدافه أي فعلٍ إنساني معززٍ لها، بدءًا من انقضاضه على محاولات مساعدة الجرحى، أو إنقاذ المسنين والعالقين تحت حصار الدبابات، ومرورًا بلهو جنوده في الجسد الفلسطينيّ، بانتزاع روحه قصفًا بالطائرات المسيّرة، أو قنصًا بالقذائف والرصاص، أو تفخيخًا بالمتفجّرات، وترك ما بقي منه فريسة للكلاب.
ووفقًا للتقارير، فبينما أسهمت الهُدنة في انتشال مئات الجثامين والرفات، والتي قُدر عددها حتى شباط/ فبراير 2025م، بـ 458 جثمانًا، ما تزال التقديرات ترجح وجود ما بين 4-5 آلاف جثمان، تنتظر انتشالها، وتعريفها، وإعادة دفنها بشكلٍ لائق
ارتبط استلاب كرامة الجسد، بالاحتجاز الإسرائيلي لأكثر من 259 جثمانًا من القطاع، دون تزويد الفلسطينيين بأي معلومات أو تفاصيل عنهم، والذي تكشّف هوله بعد تسليم دفعة من 88 جثمانًا إلى الصليب الأحمر، بحالةٍ مزرية، في أكياسٍ زرقاء وبدون تفاصيل، وبالكثير من الانتهاكات التي شملت سرقة الجلود والعظام وقرنيات العين.
في الواقع، فإن مشاهد أجساد الشهداء في الشوارع وساحات المشافي، وأمام عتبات البيوت والأزقة، وتحت أنقاض المباني المدمرة، والتي بقيت لأسابيع وأشهر ملقاة هنا وهناك، لم يتمكن الفلسطينيون من دفنها بسبب استهداف كل من يتحرك في تلك المناطق من قبل جيش الاحتلال؛ كان أكثر من محطمٍ للفلسطينيين، وترك في دواخلهم ردود أفعالٍ شرسة أمام نهايات مُستلَبة بهذه الطريقة، فتعالت رغباتهم بموتٍ كريم، غير مجهول، ولا هائم على قارعة طريق، وأطلق العشرات منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمنياتٍ توثق موتًا بكفنٍ وصلاةٍ ووداعٍ وقبرٍ في مكانٍ مخصصٍ للموت، بشاهدة قبرٍ تحمل اسمه واسم عائلته، وتتيح لمن خلفه زاويةً لبث الحنين إلى غائب، والبُكاء بأناقةٍ على راحل.
أما المظهر الأخير، والمتمثل في اقتلاع الجسد من مرقده الأخير، فقد اتخذ ثلاثة اتجاهات؛ أولها تجريف وقصف الاحتلال للمقابر بحجة البحث عن عيون الأنفاق، وثانيها نبش القبور وسرقة الجثامين منها، وثالثها سرقة الجثامين من المشافي والمراكز الطبية، وهدف الاتجاهان الأخيران للبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال الإبادة، وتوسيع بنك الأعضاء والجلود الإسرائيلي
وأقدم الاحتلال على تدمير 19 مقبرة في القطاع، ونبش أكثر من 4300 قبر، وسرق ما يزيد عن 2400 جثمان من مقابر متعددة[2]، حيث طال أجساد الشهداء الجُدد والتاريخيين، وعبث بقيمة الشهداء وأضرحتهم، ونزع الارتباط النفسي بين الضريح وعائلة الفقيد، في محاولة للتأكيد على هيمنته الاستعمارية على الأرض بما فيها من رُفات، وطمس للذاكرة ومكانها، وفرض نوعٍ من “الموت المزدوج” على الفلسطيني الحي، قبل الفلسطيني الراحل.
وأمام ذلك، لم يكن أمام الفلسطينيين سوى محاولة لملمة رفات أقربائهم، وإعادة دفنها من جديد، وتعريفها وجمعها برفات الراحلين الجدد، من المحزن جدًا القول هُنا إن المفقود الفلسطيني، قد يكون أسيرًا، أو شهيدًا قضى تحت الردم أو في زاوية شارع، أو رفاتًا اقتلعه الاحتلال، ففقد أهله بوصلة ضريحٍ له، ومتكأً للتعبير عن فقدانهم وشوقهم له.
ختامًا:
وعلى مدى أكثر من عامٍ ونصف من الإبادة، تداخلت أساليب الاحتلال في استهداف الموت وفقًا لأغراضه السياسية والعسكرية والاقتصادية، وتحوّلت غزّة لمرادفٍ فعلي لنهاية التاريخ والحياة، سعت المستويات السياسية الإسرائيلية لاستعادة الردع فيها بفرض الرعب عليها. ينفصل الفلسطينيون في إبادتهم عن الموت، يحاولون التعايش معه فيغلبهم، فيفضلون تجاهله بالتأمل في مصائب أخرى أكبر من قدرتهم الذاتية على الاستيعاب، يخفّفون بها من صدمتهم، بعضهم يرثي الروح، وبعضهم يرثي الجسد، وآخرون فاقدون للروح والجسد والقبر والوداع، وجميعهم لديهم مصائب وقصص وحكايات، لا يكفيها وداع، ولا يسعها قبرٌ، ولا يمحوها موت. ففي زمن الحرب والإبادة، صار الفلسطيني يبحث عن موتٍ له، كما يبحث عن حياة.