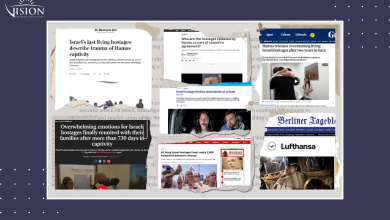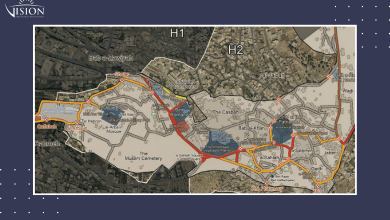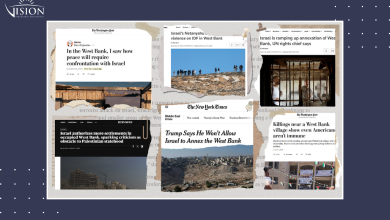فلسطينيو أراضي 48: السياق التاريخي للنضال في مواجهة المنظومة الاستعمارية

ثمة مقولة راجت منذ عقود، تقول “إن للعرب في الداخل خصوصيتهم”، في محاولة لتحييدهم عن مسار ومصير باقي أبناء شعبهم الفلسطيني بحكم مواطنتهم الإسرائيلية. هذه المقولة ليست صحيحة إلا بالمقلوب، “خصوصية” العرب في الداخل هي خصوصية بنظر إسرائيل كـ “مواطنيها” و”أعداء محتملين” لها في الوقت نفسه. وليسوا كفلسطينيين، لأنه ليس هناك وضع فلسطيني عام يُبقي العرب في الأراضي المحتلة عام 48 على هامشه أصلا، إذ قطّعت الدولة العبرية أوصال الجغرافيا الفلسطينية إلى قطع جغرافية، ترتب عليها إعادة تعريف من عليها تعريفا كولونياليا بحكم مكانتهم القانونية التي فرضها الصهاينة عليهم قسرا. فالعرب في الداخل مواطنون في دولة إسرائيل بينما المقادسة – السكان العرب في القدس الشرقية – يُعرّفوا كـ “مقيمون” فيها منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، فيما فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة هم مواطنو دولة فلسطينية لم تقم بعد، وها هم الغزيين بعد محاولة إبادتهم على مدار سنتين، يُدفع بهم وبقطاعهم نحو وجهة خاصة بهم مجهولة على المستويين السياسي والإداري.
وُلد العرب في الأراضي المحتلة عام 48 لثنائية متناقضة ما بين هويتهم العربية – الفلسطينية وبين مواطنتهم الإسرائيلية، تناقضٌ تولد عن نكبة عام 1948، وقد كُتب في ذلك الكثير. غير أن اللحظة الفارقة التي تحول فيها العرب في الداخل إلى محط أنظار ومحل سؤال لدى باقي الفلسطينيين والعرب عموما، كانت مع ما يُعرف في قاموس الداخل السياسي بـ “هبة أكتوبر 2000” مع اندلاع الانتفاضة الثانية “انتفاضة الأقصى” حين خرجت مظاهرات غاضبة في عدة مدن وقرى عربية في الأراضي المحتلة عام 48، احتجاجا على مذبحة الأقصى التي اقترفتها القوات الإسرائيلية على أثر اقتحام زعيم حزب الليكود في حينه ورئيس الحكومة الأسبق أريئيل شارون مجمع الحرم القدسي الشريف في القدس في أواخر أيلول/سبتمبر 2000، ما أطلق شرارة الانتفاضة الثانية.
لم تكن تلك المرة الأولى التي ينتفض فيها العرب في الداخل احتجاجا على سياسات الحكومات الإسرائيلية، لكنها كانت أول مرة يلتحق فيها أبناء الداخل للالتحام احتجاجا مع باقي أبناء شعبهم في القدس والضفة والقطاع. وقد ارتقى في هبة أكتوبر 2000، ثلاثة عشر شهيدا من مدن وقرى عربية مختلفة في الداخل برصاص قوى أمن حكومة حزب العمل الإسرائيلية بزعامة “إيهود باراك”. ولم تكن المرة الأخيرة، لكن فصلا جديدا كان قد بدأ من حياة المجتمع العربي داخل أراضي الـ 48.
في سياق تاريخي
أُخضع العرب الباقين والناجين من فعل التطهير العرقي الذي مارسه الصهاينة في النكبة، للحكم العسكري منذ عام 1948 وحتى عام 1966، بعد أن تحولوا إلى أقلية في بلادهم، ومُنحوا الجنسية الإسرائيلية “المواطنة” كحلٍ وسط للبقاء فيها.[1] نذَكر في هذه المرحلة لأهميتها في وضع أسس نظام الرقابة والتحكم من قبل المؤسسة العسكرية – الأمنية الصهيونية في حينه، وقد أفرد لها الباحث أحمد سعدي كتابه “الرقابة الشاملة …” مؤصلاً فيه لجذور الفكر الأمني الذي أسست له وطبقته المؤسسة الإسرائيلية سياسيا وأمنيا على العرب في الداخل.[2]
ومع أن الخوف والإرباك إلى حد الإذعان هو ما كان يحكم إيقاع علاقة عرب الداخل بالمؤسسة الإسرائيلية طوال فترة الحكم العسكري، إلا ان ذلك لم ينف قيام حالات احتجاج جماعي وصلت حد الصدام مع أجهزة أمن الدولة العبرية. ومع أنها حالات متقطعة وبؤرية اقتصرت على قرية هنا وبلدة هناك، وليست هبات جماهيرية، إلا انها أسست لذاكرة الاحتجاج والتمرد على سياسات المؤسسة الإسرائيلية، في ظل ظرف أمني وقانوني كان يحول دون إمكانية التنظم والاحتجاج.
كان أشهرها في بلدة شفاعمرو في الجليل عام 1959، التي عُرفت بـ “طوشة الباصات” في اللهجة الفلسطينية، أي عِراك الحافلات. وقد كتب عنها الباحث خالد عنبتاوي سلسلة من 3 مقالات بعنوان “هبة الباصات…” في موقع عرب 48. وذلك عندما احتج عمّال من شفاعمرو على شركات الباصات (الحافلات) الإسرائيلية “إيغيد” التي كانت تقلهم من بلدتهم يوميا إلى ورشات العمل في حيفا والبلدات اليهودية الساحلية. ولم تكن الباصات متوفرة بالشكل الذي يتيح لجميع عمّال البلدة الوصول إلى ورشات عملهم، ما أدى إلى سلسلة اعتصامات واحتجاجات نظمها العمّال ضد الشركة، كانت ذروتها في يوم التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 1959، إذ تدخلت يومئذ قوات الشرطة الإسرائيلية لفض اعتصام العمّال وذويهم باستخدام الرصاص الحيّ، وارتقى يومها محمد أبو رعد شهيدا.
احتلت قوى أمن سلطات الحكم العسكري بلدة شفاعمرو، واعتقلت العشرات من عمّالها في الأيام التي تلت يوم الاعتصام. وليس صدفة، ان تتصل هذه الهبة المحلية بالباصات وسؤال التنقل في ظل حكم عسكري كان التنقل فيه مشروطا بتراخيص تمنحها سلطات الحكم العسكري، ما جعل لحاق العامل بالحافلة والركوب فيها، لحاقا بلقمة عيشه في حينه.
إلى الحدث الجامع: يوم الأرض
غير أن اللحظة التاريخية الفارقة، التي تحرك فيها العرب في الأراضي المحتلة عام 48 جماعيا وكجماعة سياسية وأقلية قومية – مدنية، كانت في 30 آذار/مارس 1976، أي بعد نحو عقد من الزمن على رفع الحكم العسكري. ويعتبر يوم الأرض الحدث الجامع الذي أجمعت عليه كل القوى السياسية والوطنية في أراضي الـ 48، وأول صدام عنيف مع السلطات الحاكمة. اندلعت أحداث يوم الأرض مما صار يُعرف بـ “مثلث يوم الأرض” القرى الثلاث في الجليل: سخنين وعرابة ودير حنا، على خلفية سياسة مصادرة الأراضي العربية في الجليل التي تعاقبت الحكومات الإسرائيلية على ممارستها منذ مطلع الخمسينيات، وقد اشتدت مصادرة الأراضي في أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات مع ما عُرف صهيونيا بمشروع “تهويد الجليل”.
امتدت مظاهرات واحتجاجات يوم 30 آذار/مارس إلى مختلف المدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني، بعد إعلان الإضراب العام يومها، والذي اتخذ في بعض البلدات شكل العصيان المدني. وقد اصطدمت بقوات الشرطة والأمن الإسرائيليتين، ما أدى إلى ارتقاء ستة شهداء في قرى سخنين وعرابة وكفركنا في الجليل والطيبة في منطقة المثلث. كان سؤال الأرض وحده ما جمّع العرب في الداخل في حينه، سياسيا واجتماعيا، ومن ردهم في الوقت نفسه إلى وحدتهم الطبيعية والتاريخية مع أبناء شعبهم على كامل التراب الفلسطيني. ما جعل يوم الأرض يوما يتجاوز جغرافيا الداخل، إلى كامل الوجدان والوعي الفلسطينيين كذكرى سنوية يُحييها كل الفلسطينيين في كل عام.
“لقد أحس العرب في الأراضي المحتلة عام 48 أنفسهم في يوم الأرض أقوياء، لكنهم خافوا من قوتهم، فخشوا أن يمضوا قدما، واستخلصت النتائج من ذلك اليوم بألا يتكرر ذاته إلى كذكرى سنوية…” يقول الدكتور عزمي بشارة في كتابه الخطاب السياسي المبتور.[3] إذ سارعت المؤسسة الإسرائيلية بالتعاون مع قوى سياسية عربية – محلية إلى احتواء الظاهرة بما يمنع تكرارها، ليس عبر العدول عن سياسة مصادرة الأرض التي ظلت قائمة على قدمٍ وساق، إنما من خلال سياسة الاحتواء وتحسين شروط مواطنة المواطنين العرب في الداخل في مجالات مختلفة، الاقتصاد وقطاع الخدمات خصوصا، وتحول المؤسسات العربية – الجماهيرية التي قادت يوم الأرض إلى غاية في حد ذاتها، إذ لم تذهب باتجاه تطوير عمل جماهيري احتجاجي – مدني منظم، إنما قامت في موازاة هذه المؤسسات هيئات محلية وقطرية، ذات طابع محلي.[4] وذلك بما يمنع أي عمل جماهيري – جامع في الداخل، كمحاولة لقطع الطريق على أي مسار يؤسس لفكرة تحرك العرب كجماعة سياسية – قومية.
ستظل ثيمة “العودة خطوة إلى الخلف” بعد كل هبة جماهيرية، هي القاعدة التي تحكم سلوك العرب في الداخل في هباتهم وانتفاضاتهم منذ هبة أو انتفاضة يوم الأرض. وهذا ما تحاول هذه المقالة السؤال فيه: لماذا يخشى فلسطينيو الداخل كلما تحركوا جماهيريا تحركهم؟ حيث سرعان ما يجري احتواء كل هبة جماهيرية – وطنية يتحرك فيها العرب في الداخل كفلسطينيين، تصل حد المواجهة العنيفة مع أجهزة الأمن الإسرائيلية لإعادة ضبط هذا التحرك وموضعته تحت سقف المواطنة الإسرائيلية. وذلك من قبل المؤسسة الحاكمة بالتعاون مع قوى سياسية محلية كانت دائما ما تأخذ هذه القوى على عاتقها مهمة إعادة الناس من الشارع إلى الرصيف سياسيا. وهذا ما سيظلُّ يتكرر مع احداث ومحطات أخرى لاحقا مثل هبة تشرين الأول/أكتوبر 2000، وكذلك في هبة أيار/مايو 2021، التجرؤ والتقدم على الفعل الجماعي ثم العودة خطوة إلى الخلف.
تاريخ موازي – مغيّب
تعتبر احتجاجات العرب في الداخل، التي اتخذت أشكال مختلفة ما بين الاحتجاج المدني والاعتصام المحلي “البؤري” في ظل فترة الحكم العسكري 1948-1966، وما بين الهبة الجماهيرية الجامعة التي تجلت ذروتها في يوم الأرض 1976، وما بعده من مرحلة استهلاك سياسي ليوم الأرض كذكرى سنوية من قبل قوى وأحزاب سياسية منذ أواخر سبعينيات وحتى مطلع تسعينيات القرن الماضي بمثابة ذاكرة جمعية حاضرة على شكل فلكلورٍ ثقافي لكنها منزوعة من فاعليتها السياسية إلى يوم فلسطينيي الداخل هذا.
غير أن هذه المرحلة الممتدة ما بين خمسينيات ومطلع تسعينات القرن الماضي، تتضمن تاريخا كفاحيا موازيا للنضال الجماهيري المدني في الداخل، والذي جرى اسقاطه من ذاكرة أبنائه وبناته. هو ذلك المتصل بـ “كفاح بعض فلسطينيي الداخل المسلح في ظل المواطنة الإسرائيلية” وقد اتخذ شكل المبادرات الفردية أو خلايا مشكلة من مجموعة أفراد في مناطق الجليل والمثلث، نفذ بعضها عمليات ضد أهداف إسرائيلية في مراحل مختلفة على مدار النصف الثاني من القرن العشرين.
كان أشهر تلك الخلايا المسلحة في الداخل، ما عُرف بـ “المجموعة 778” أو “مجموعة عكا 778″،[5] التي تأسست في مدينة عكا، كمجموعة فدائية في ستينيات القرن العشرين، ومن أبرز مؤسسيها كان فوزي النمر من مواليد مدينة عكا، والذي اعتقل في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 1969، بعد سلسلة عمليات ضد أهداف ومرافق إسرائيلية عامة ما بين حيفا وعكا.
تكاد لا تخلو مدينة أو بلدة أو قرية في الداخل من حكاية عن أحد أبناءها الذي التحق بمنظمة التحرير الفلسطينية من ستينيات القرن حتى مطلع التسعينيات، أو تنظم بالمنظمة وبقي يعمل لصالحها سرا من الداخل. وهذا غير حكايات المطاردين والفدائيين الذين جرت تصفية بعضهم وأسر بعضهم الآخر في سيرة ما تزال مغيبّة من ذاكرة الداخل أو جرى تغييبها من نفس المنظومة السياسية – الأمنية الحاكمة، وبنفس الأدوات المحلية. فبعض القوى والقيادات العربية المحلية التي عملت بالوكالة على احتواء الاحتجاجات الشعبية والهبات الجماهيرية لتأديبها تحت المواطنة، ونقصد المواطنة بشرطها الإسرائيلي – الصهيوني، هي ذاتها من عملت على تغييب كل سيرة لفعل المناهضة والتمرد خارج شروط وقواعد العمل في الداخل من ذاكرة أجياله.
مع انتهاء الانتفاضة الأولى في مطلع تسعينيات القرن الماضي، والتي أسفرت عن أكبر منعطف في تاريخ الشعب الفلسطيني، والمتمثل في اتفاق أوسلو في أيلول/سبتمبر 1993، فان فصلا آخرا جديدا من الحركة والحِراك السياسيين والجماهيريين سيبدأ في تاريخ فلسطينيي الداخل، بما سيجعلهم محل سؤالٍ أكثر من أي وقت مضى بعيون الفلسطينيين والإسرائيليين معا.
[1] عن ذلك راجع: جريس، صبري، العرب في إسرائيل، منظمة التحرير الفلسطينية – مركز الأبحاث، ط1، 1967، ج1. وأيضاً، بشارة، عزمي، العرب في إسرائيل: رؤية من الداخل، مركز دراسات الوحدة العربية، ط2، بيروت، 2000.
[2] سعدي، احمد، الرقابة الشاملة: نشأة السياسات الإسرائيلية في إدارة السكان ومراقبتهم والسيطرة السياسية تجاه الفلسطينيين، ترجمة: الحارث محمد النبهان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، بيروت، 2000. وانظر أيضا: ماتسا، دورون، سياسات إسرائيل إزاء مواطنيها العرب: جذور الفكر الأمني وتطوره، ترجمة: محمد قعدان، مجلة قضايا إسرائيلية، عدد 84، ص118-125.
[3] بشارة، عزمي، طروحات في النهضة المعاقة ودراسات أخرى، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، ط1، رام الله، 1998، ص34.
[4] المرجع السابق، ص34.
[5] عن ذلك راجع: فياض، توفيق، مجموعة عكا 778، وزارة الثقافة الفلسطينية، ط3، 2000.
ملاحظة: هذه المقالة هي من جزئين تنشر تباعا.