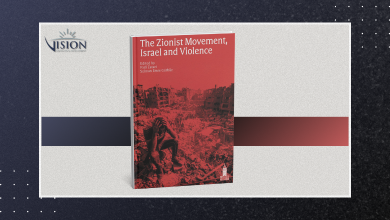عرض كتاب: الاقتصاد السياسي في فلسطين: منظورات نقدية مناهضة للاستعمار ومتعددة التخصُّصات

إخلاص طمليه
باحثة فلسطينية متخصصة في القضايا الاقتصادية
الكتاب من إعداد مجموعة من الباحثين، وتحرير: علاء ترتير، وطارق دعنا، وتيموثي سيدل.
صدر في عام 2021 باللغة الإنجليزية عن دار بالجريف ماكميلان في سويسرا.
عدد صفحات الكتاب 335 صفحة.
الملخص
تعرض هذه المراجعة كتاب “الاقتصاد السياسي في فلسطين”، الصادر عن دار بالجريف ماكميلان في أيار/ مايو 2021. يمثِّل الكتاب جهدًا أكاديميًّا جماعيًّا في تأسيس مقاربة جديدة لدراسة الاقتصاد السياسي الفلسطيني، حيث يحلِّل الوضع الراهن للاقتصاد الفلسطيني في ضوء علاقات القوة والاستعمار والصراع الاجتماعي. ينطلق الكتاب من مبدأ ارتباط السياسة ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد، ويشدِّد على أن المقاربات الاقتصادية التي لا تراعي البُعْد السياسي لا تكفي لفهم البنى الاستعمارية والاستيطانية، بل تُسهِم في مفاقمة الخطر واستمرار الاستعمار.
الاقتصاد السياسي الفلسطيني: معطيات ومقاربات
يستكشف هذا الكتاب الفريد، الواقع في ثلاثة أجزاء وأربعة عشر فصلًا، سياق الاقتصاد السياسي لفلسطين، يبدأ من اختيار تصميم للغلاف بزخرفة إسلامية تضفي طابَع البحث عن الأصالة، والحفاظ على وجود الشعوب الأصيلة على أرضها.
يقدِّم الفصل الأول الذي أعدَّه محررو الكتاب، علاء الترتير وطارق دعنا وتيموثي سيدل، والمعنون بـ “الاقتصاد السياسي في فلسطين خلال النضال ضد الاستعمار الإحلالي، والرأسمالية العنصرية، والنيوليبرالية”، يقدِّم لمحةً عامةً عن الكتاب، ويستعرض نظرة المؤلفين للاقتصاد السياسي الفلسطيني، وتحليله للتكامل والتجزئة، واكتشافه للعديد من جوانب الاقتصاد السياسي في فلسطين في ظلِّ غياب السيادة.
يؤكِّد الفصل أن المنظورات النقدية متعدِّدة التخصُّصات توفر إطارًا قويًّا لفهم الاقتصاد السياسي لفلسطين المحتلة، كما يوضِّح مدى التزام المؤلفين بالتضامن مع النضالات الشعبية في فلسطين المحتلة، ويبيِّن تأثير محاولات السلام الاقتصادي، مثل اتفاقية الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في الاقتصاد السياسي الفلسطيني.
يستخدم الفصل نهجًا نقديًّا لدراسة الاقتصاد السياسي الفلسطيني في ربع قرن، أي منذ اتفاقية أوسلو وحتى صفقة القرن التي تبنَّاها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك بهدف الحصول على تحليلٍ أكثر عمقًا للاستعمار والرأسمالية والنيوليبرالية، وتحليل كيف تأثرت فلسطين بعمليات الاستغلال والسَّلْب من قِبَل “إسرائيل”، والشركات العالمية، والنُّخب الفلسطينية.
كما يشرح هذا الفصل -بشكل مقتضب- اتفاقية أوسلو وما تبعها من أوهام بناء دولة دون سيادة، وبناء المؤسسات، والتأثُّر بإملاءات البنك الدولي والمانحين، ويشرح كيف أثَّر هذا في الأبحاث والكتابات الفلسطينية، وتحوُّلها من دراسة آثار الاستعمار الاستيطاني إلى تحليل آليات بناء الدولة الفلسطينية، وإصلاح مؤسسات الأمن ضمن خطط مختلفة، ويأمل مُعدّو الفصل أن يُسهِم جهدهم الأكاديمي في إنتاج المعرفة، وتحويلها إلى قوة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
أما الفصل الثاني من الكتاب، الذي جاء بعنوان “الهيمنة والتهدئة: تحديد سياق الاقتصاد السياسي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967″، وهو من إعداد طارق دعنا، فيدرس كيف أثَّر استخدام الاستعمار الإحلالي في فلسطين لآليتَيْن مزدوجتَيْن في السيطرة في الاقتصاد الفلسطيني، حيث استخدم الاحتلال منذ عام 1967 أساليبَ الإخضاع القسرية والناعمة في الوقت نفسِه، وذلك للسيطرة على أوسع مساحة من الأرض بأقل عدد من السكان الأصليين.
لقد استخدم الاحتلال منذ عام 1948 أساليبَ الهيمنة العنيفة والقسرية والتطهير العِرقي، إلا أنه منذ عام 1967 بدأ باستخدام أساليب سيطرة هادئة ومبتكرة للسيطرة على أرض فلسطين، حيث هدفت هذه الأساليب للتعامل مع الوجود الفلسطيني بوصفه تهديدًا ديموغرافيًّا، ومن ثَمَّ حرصت على تضييق حياة الفلسطينيين أينما حلوا، لدفعهم للهجرة الداخلية أو الخارجية. ويوضِّح دعنا في هذا الفصل أثر استخدام أساليب السيطرة الهادئة والعنيفة في المؤسسات الفلسطينية، والتنمية الاقتصادية، والتحولات الاجتماعية والطبقية داخل المجتمع الفلسطيني.
ويكشف دعنا أن استخدام الأسلوبَيْن بشكل متوازٍ عمل على تطبيعٍ جزئيٍّ للنظام الاستعماري في الأراضي الفلسطينية، حيث إن الهيمنة الاقتصادية مشابهة لممارسات الاستعمار الكلاسيكية، التي تدمر الاقتصاد المحلي من خلال نزع الملكية، ومصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، ومن ثَمَّ هي في مجملها أساليب إقصائية للسكان الأصليين، من خلال تدمير مواردهم ومساكنهم وسُبل عيشهم، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى احتجاج السكان، وثورتهم لاستعادة حقوقهم وملكياتهم.
إلا أن ثورة أصحاب الحق تصبح -بسبب استخدام الاحتلال مبدأ التهدئة الاقتصادية- ضعيفة الأثر، ومن ثَمَّ يستفيد المحتلُّ من التهدئة في إخماد الثورة ضده، والناتجة عن الممارسات القاسية للهيمنة الاقتصادية، ومن ثَمَّ تخفِّف ممارسات التهدئة من ردود الأفعال الثورية على المحتل، وتقوِّض أساليب الدفاع السلمية والمسلحة، من خلال توظيف مجموعة من الآليات والحوافز، مثل توفير العمالة الرخيصة من السكان الأصليين لصالح الاقتصاد الاستعماري، ودعم بعض المشاريع محدودة التأثير في فئة معيَّنة، وتعزيز طبقة النخبة. ومهما تعدَّدت هذه الآليات واختلفت، إلا أنه يجب أن تنتج فوائد اقتصادية للمحتل، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبعد 27 عامًا من عملية أوسلو، يستنتج دعنا أن الإصلاح الداخلي للمؤسسات الفلسطينية في ظل شروط أوسلو لن يردع الهيمنة الاستعمارية الإسرائيلية، ولا يمكن مجابهته بنفس إطار اتفاقية أوسلو، ولا بدَّ من انتهاج مبدأ المقاومة المنظَّمة ضد الاحتلال، وتقرير الفلسطينيين مصيرهم.
أما الفصل الثالث الذي أعده إبراهيم الشقاقي، بعنوان “تبعية الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية، والتكوين الطبقي منذ عام 1967″، ففيه يرى أن إطار العمل المناسب لفهم الاقتصاد الفلسطيني يكون من خلال نظرية التبعية مصحوبًا بفهم التكوين الطبقي. ويشرح الشقاقي الفترة التي أعقبت احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة حتى بدء عملية أوسلو (1967-1993)، حيث كان الاعتماد على أسواق العمل والسلع الإسرائيلية في تلك السنوات اعتمادًا كاملًا. أما الفترة التي أعقبت أوسلو حسب الشقاقي، فقد شهدت استمرار التبعيات السابقة، وخلق تبعياتٍ جديدة، وكذلك طبقات اجتماعية واقتصادية جديدة في فلسطين.
ويقدِّم تيموثي سيدل في الفصل الرابع بحثًا بعنوان “الصراع القائم على الأرض والاستعمار الاستيطاني”، ويتناول فيه عنصرًا مهمًّا من عناصر الاقتصاد السياسي، وهو المقاومة التي تعتمد على الأرض، والتي تأخذ شكل الزراعة والعمل الزراعي، والسيادة الغذائية، والاعتماد على الذات، والتبادل التجاري. وينظر سيدل إلى النضال من أجل السيادة الغذائية بوصفه مفتاحًا لاقتصاد سياسي مقاوم، في ظل القيود المفروضة على حرية التنقل، والهجمات المنظَّمة من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين ضد المزارعين ومحاصيلهم، والقيود المفروضة في بروتوكول باريس الاقتصادي، التي تكلف الاقتصاد الفلسطيني 2.2 مليار دولار سنويًّا، وتحويل المزارعين الفلسطينيين إلى عمالة رخيصة داخل الخط الأخضر.
ومن وجهة نظر الكاتب، فإن النضال المبني على الأرض يُعَدُّ أمرًا مهمًّا، ليس فقط لخلق بدائل عن المساعدات الغذائية، أو تعزيز النضال ضد الاحتلال، وإنما لأنه يرتبط بنضال أوسع ضد الرأسمالية، حيث تؤمّن الزراعة المستدامة العدالةَ الاجتماعية في مواجهة السياسات الليبرالية، التي تحارب صغار المزارعين بمنافستها غير العادلة، وتجبرهم على بيع أراضيهم.
ويناقش وليد حباس في الفصل الخامس قضية “التكامل الاقتصادي بين الضفة الغربية وإسرائيل: التفاعل الفلسطيني مع الحدود والتصاريح الإسرائيلية”. حيث يرى حباس أن دراسة العلاقة التكاملية بين الاقتصادَيْن الفلسطيني والإسرائيلي تؤخذ في العادة من منظور التبعية الفلسطينية للهيمنة الإسرائيلية، وهو منظور قاصر لا يأخذ بعين الاعتبار العديد من الأنشطة التكاملية الاقتصادية، مثل التعاقد من الباطن، وتهريب الفلسطينيين للبضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات، والوساطة وغسيل بضائع المستوطنات، والاستثمارات المباشرة للرأسماليين الفلسطينيين في “إسرائيل” والمستوطنات اللاشرعية، ومن ثَمَّ فإن المتعاملين الفلسطينيين ليسوا بالضرورة عاجزين ومستغَلين، وإنما هم باحثون عن الربح. ولذا يسلِّط الفصل الضوءَ على استراتيجيات التكيف، التي ابتكرها الفلسطينيون لتحويل الهيكل الاقتصادي المعقَّد إلى فرصٍ لتحسين حياتهم ومستوى معيشتهم.
ويختم هذا الفصل بوصف طبقة اجتماعية ظهرت في المجتمع الفلسطيني، وتتغذى كالطفيليات على النظام الاستعماري، مستغلةً الثغرات والتعارضات في هياكل الاحتلال لتنمية مصالحها الشخصية، وهذه الطبقة هي من أكثر المشجعين على استمرار هذا النوع من التكامل الاقتصادي الفلسطيني الإسرائيلي، ومن ثَمَّ يعزز بعض الوسطاء الفلسطينيين من تبعية الاقتصاد الفلسطيني، كما أن بعض هؤلاء الوسطاء يتمتعون بطابع مؤسسي، ومن ثَمَّ فإن أيَّ حديث عن انفكاكٍ اقتصاديٍّ عن الاحتلال لا ينبغي أن يستبعد علاقات القوة التي لا تُعد ولا تُحصى، والتي تُصنَّف بأنها غير رسمية، إلا أنها أكبر سبب لتعميق التبعية الاقتصادية.
ويناقش الفصل السادس -الذي عنونه أحمد تنيرة بـ “الاقتصاد السياسي لقطاع غزة تحت حكم حركة حماس”- التداعيات السياسية والاقتصادية لانتصار حركة حماس الانتخابي، كما يبحث في اقتصاد الأنفاق وتأثيره في إعادة هيكلة اقتصاد قطاع غزة، ويسلِّط الضوء على الاختلالات الهيكلية التي اجتاحت رأس المال المادي والبشري لقطاع غزة، نتيجة الحصار والانقسام الداخلي الفلسطيني.
ويرى تنيرة أنه عقب فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، توقَّع المحللون أن تكون هذه النتيجة فرصة رئيسة للحركة؛ لتنفيذ أجندات سياسية واقتصادية من شأنها زيادة شعبيتها داخليًّا وخارجيًّا. ومع ذلك، أدت التطورات السياسية التي حدثت لاحقًا إلى اختلالاتٍ هيكلية نتيجةً للديناميات السياسية والاقتصادية الجديدة.
ومنذ عام 2012، ازداد مقدار الرسوم المالية على القطاع الخاص في قطاع غزة، ووقع هذا القطاع في مأزق التعامل مع نظام الازدواج الضريبي والجمركي، حيث تجمع “إسرائيل” الضرائب نيابةً عن السلطة الفلسطينية، وتقوم الحكومة في غزة (حماس) أيضًا بجمع الضرائب عند وصول البضائع إلى المعبر.
وحسب أحمد تنيرة، فقد عانى القطاع من عدم الاتساق في السياسات واللوائح، التي كان لها تأثير مباشر في عمل القطاع الخاص، مثل إلغاء تراخيص العديد من الوكالات التجارية، بحجَّة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الاحتكار، كما نفذت حكومة القطاع بعضَ السياسات التي أدت إلى مزاحمة القطاع الخاص، مثل تنفيذها مشاريع استثمارية زراعية كبيرة لا يستطيع القطاع الخاص منافستها، ومشاريع تنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تخفيض النفقات الموجَّهة من وزارة المالية في رام الله إلى قطاع غزة، مما أدى إلى أزمة سيولة حادة في قطاع غزة، للمواطنين وللقطاع الخاص، أدت إلى انخفاض الطلب على الكثير من الأنشطة التجارية.
لذا يرى تنيرة أن الاقتصاد السياسي تحت حكم حركة حماس قد شهد تغيُّرات مهمَّة، منها ظهور نخبة اقتصادية جديدة سيطرت على عمل القطاع الخاص، ومساعدة اقتصاد الأنفاق لمجموعة من التجار ورجال الأعمال غير التقليديين، والمعتمدين على علاقاتهم السياسية (انتمائهم لحركة حماس)، في الاستفادة من الفوضى لبناء رأس مال في وقت قياسي، والاستحواذ على قطاعات اقتصادية مهمة.
وتتناول هبة الله طه في الفصل السابع موضوعًا آخر بعنوان “الفلسطينيون في “إسرائيل”: الخلافات النيوليبرالية والتكوين الطبقي”، حيث تناقش الاقتصاد السياسي لفلسطينيي 1948، وتركز على الطرق التي أعادت بها النيوليبرالية هيكلة رأس المال والعمل الفلسطيني.
لقد عملت السلطات الإسرائيلية منذ عام 1948 على إفقار الفلسطينيين تحت ذرائع متعدِّدة، حيث فُرضت قيود على العمل في الأماكن التي يسكنها الفلسطينيون، لا سيما في مجال الزراعة، عن طريق الأحكام العرفية التي وصفها المسؤولون الإسرائيليون بأنها لتنظيم الوضع، إلا أنها في الحقيقة لضمان السيطرة على الأرض.
كما يناقش الفصل كيف تفاعلت الجماعات الفلسطينية المستعمَرة مع مبدأ الرأسمالية والسوق الحر، التي عملت “إسرائيل” على تغييب الفلسطينيين عنها، وكيف تكونت طبقات اجتماعية جديدة بين فلسطينيي الداخل تبعًا لهذا التفاعل. كما يبيِّن هذا الفصل كيف عملت سياسات العمل الإسرائيلية على إنشاء طبقة بروليتاريا من الفلسطينيين، تعتمد بشكل أساسي -في عملها وسكنها وحصولها على البنية التحتية- على الدولة، حيث منعت نشوء أي شكلٍ من حركات التحرُّر الداخلية. ولإنشاء طبقة البروليتاريا أهمية كبيرة في تأسيس الاستعمار والمصالح الرأسمالية، حيث إن استعمار الأرض والعمل معًا أمرٌ بالغ الأهمية في إحكام السيطرة.
أما الفصل الثامن الذي أعدَّه شير هيفير تحت عنوان “نحو فهم لسياسة الفصل العنصري وعدم المساواة في “إسرائيل”/ فلسطين”، فيقترح الابتعاد عن إطار الدول والحدود، والبحث عن إطار من الناس: أفرادًا وجماعات، بدلًا من مقارنة دَخْل الفرد بالاعتماد على الحسابات القومية، ومن ثَمَّ توضيح مقدار عدم المساواة نتيجة التمييز، والفصل العنصري. وحدَّد الكاتب ثلاث مجموعاتٍ من مواطني “إسرائيل”، وثلاث مجموعاتٍ من مواطني المناطق الفلسطينية، موضحًا في النهاية مقدار التشرذم الاجتماعي بين الطبقات المهيمنة والطبقات التابعة.
وحسب هيفير، فإن 75 كيلو مترًا فقط بين مخيم جباليا ومرتفعات تل أبيب لا توضِّح حجم التفاوت المذهل بين المنطقتَيْن في الدَّخْل، ولا يمكن قياسه فقط بالبيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، التي تستخدم مقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى الكاتب أن حسابات الأجور اليومية تبيِّن أن هناك اتجاهًا مستمرًّا لزيادة عدم المساواة بمرور الوقت، وذلك حسب هوية الفرد، ومكان ولادته، وما هو عِرقه، وجنسيته، ودينه، وأصبحت هذه المعايير أكثر أهميةً في تحديد المبلغ الذي يمكن أن يكسبه الشخص، وأصبحت مهاراته وتعليمه وجهده وتفانيه أقلَّ أهميةً.
ويبحث الجزء الثالث من الكتاب موضوع “الاقتصاد السياسي في غياب السيادة”، ويبدأ بالفصل التاسع، الذي كتبته كاثرين شاريت بعنوان “غزة وفلسطين ومستقبل الاقتصاديات السياسية للشعوب الأصيلة”. ينطلق هذا الفصل من افتراض انعدام احتمالية أي مستقبل أو تنمية اقتصادية في قطاع غزة، كأساس للدراسة وليس نتيجة، كما يكتشف من خلال تحقيقات تجريبية أن ازدياد عمليات العنف الدائم وغير المبرر ضد اللاجئين وسكان قطاع غزة، الذي وُثق في القصف الوحشي والقناصة ضد المتظاهرين العزل، أنتج اقتصادًا قائمًا على تجارة الأسلحة، واحتمالية التخلُّص من المقاومة في أي وقت، ومسح السكان الأصليين. كما بيَّن كيف تقف حركات المقاومة في غزة ضد أهداف السلطة الفلسطينية، وكيف تستغل “إسرائيل” هذا في تكتيكات “فرِّق تسُد”.
وتشبّه الكاتبة الكيفية التي يسيطر بها المانحون على موارد غزة عبر مؤسسات ذات طابع حديث، بالاستعمار الأوروبي في حقبة ما بعد الإمبراطورية، حيث تحاول هذه المؤسسات تصوير حركات المقاومة في غزة بأنها هي المشكلة، وأن المانحين يحاولون “إنقاذ” غزة من خلال أساليب التهدئة الاقتصادية، مثل مشروع تحلية المياه.
ويتناول الفصل العاشر -الذي كتبه جيري وايلدمان وعلاء الترتير- موضوع “الاقتصاد السياسي للمساعدات الخارجية في الأراضي المحتلة”، حيث يدرس إنفاق الباحثين على بناء المؤسسات، الذي بلغ حسب إحصاءات عام 2020 نحو 40 مليار دولار، منها 30 مليارًا -أي حوالي 75%- تمَّ جمعها بين عامي 2007 و2019. ويستكشف هذا الفصل العلاقة بين تلقي فلسطين للمساعدات الخارجية، وبين تراجع التنمية، حيث يستنتج أن نموذج إطار عمل أوسلو للتنمية قد زوَّد السلطة الفلسطينية بإيرادات عامة، لكنه في المقابل زوَّدها بقدر ضئيل من النفوذ للسيطرة على السياسة المالية، حيث ركَّزت السياسة المالية الإسرائيلية وإطار اتفاقية أوسلو على إمداد السلطة بالدَّخْل والإيرادات، مع الحرص على منع قيام أي تنمية اقتصادية حقيقية للفلسطينيين.
وفي هذا الفصل، تمَّ تحديد أربعة مناهج رئيسة استخدمها صانعو السياسات والباحثون في تحليل المساعدات الخارجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث سيطر المنهج البراغماتي “الذرائعي” على الكثير من التحليلات، بالرغم من أنه فشل في تفسير اللاتنمية في الأراضي الفلسطينية رغم تدفق المساعدات الخارجية، والذي يعود -حسب الكاتبَيْن- إلى ابتعاد هذه المقاربة عن المتغيرات السياسية، حيث لا تأخذ بعين الاعتبار شروط العملية السياسية والاستعمار الاستيطاني بوصفها مؤثراتٍ في التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
أما المقاربة الثانية فتقوم على المنهج البراغماتي الانتقادي، الذي يؤكِّد أن السياسة الجيدة للمساعدات يمكن أن تؤدي إلى تغيير اجتماعي واقتصادي إيجابي، لكنه يختلف عن الأول في أن حدوث التغيير الإيجابي لا يكون إلا بمواجهة الاحتلال والحدِّ من الاستيطان. وترى المقاربة النقدية أن المساعدات الخارجية هي جزء من المشكلة، حيث إنها تعزز السياسة القمعية، وخاصةً الاستيطان، وتُضعف المقاومة. أما المنهج الأخير، الذي يمثل الاستعمار الحديث، فلا يرى أيَّ مشكلة في وجود الاحتلال الاستيطاني وترسيخه، وإنما يرى أن المشكلة الأساسية تكْمُن في كيفية إيجاد طرق للمساعدة في تطويع الفلسطينيين مع سياسة “إسرائيل”. ومن ثَمَّ يؤكِّد كاتبا الفصل أن أيَّ تدفق للمساعدات -مهما بلغ حجمه- لن يكون فعَّالًا أبدًا في ظل الأُطر السياسية الحالية، وأن مزيدًا من الأموال يمكن أن تؤدي إلى الضرر عند إنفاقها في أوجه لا تتناسب مع أولويات المرحلة.
أما الفصل الحادي عشر، الذي كتبه أنس قتيت بعنوان “الاقتصاد السياسي للسلطة الفلسطينية: بنية الرقابة المالية”، فيعتمد نهج المالية العامة المتمحور حول الريعية، ويؤكِّد أن على السلطة الفلسطينية أن تصمِّم استراتيجيات لتحصيل إيرادات محلية تضمن بقاءها المالي. ويعتقد الكاتب أن الأموال المتاحة بسهولة في شكل مساعدات خارجية وعائدات مقاصة قد أعفت السلطة من إبرام عقد اجتماعي حقيقي مع شعبها، وخلقت تفاوتًا طبقيًّا ملحوظًا بين كبار الموظفين وبين المجتمع الفلسطيني، كما أظهرت أن اتفاق أوسلو قد زوَّد السلطة الفلسطينية بالقدرة على تحصيل الإيرادات العامة، إلا أنه منحها قدرًا ضئيلًا من النفوذ، أو السيطرة على السياسات المالية العامة.
ويرى أنس قتيت أيضًا أنه بعد إنشاء السلطة الفلسطينية، وفي ظل امتثال قرارات السلطة المالية للشروط الإسرائيلية، وغياب السيادة عن جزء من منظومة الضرائب، وتوصيات الجهات المانحة بتنفيذ الإصلاحات المالية بما لا يتناسب مع مبادى العدالة الاجتماعية، مثل رفع الدعم عن السلع الأساسية، وفرض ضرائب تنازلية، فإنه من دون شكٍّ تُعَدُّ دراسة نظام الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية امتدادًا لدراسة الاستعمار النيوليبرالي، والاقتصاد السياسي في الأراضي الفلسطينية.
وفي الفصل الثاني عشر، الذي كتبته تهاني مصطفى بعنوان “الاقتصاد السياسي والتدخل في نظام الأمن في الأراضي المحتلة”، ترصد الكاتبة التدخلات الخارجية في البنى الأمنية الفلسطينية ضمن سياق “بناء السلام”. وحسب الكاتبة، فإنه تمَّ تطبيق الحكم الليبرالي في الحكومة الفلسطينية تحت مظلة برنامج إصلاح قطاع الأمن (SSR)، وتعتبر الكاتبة فلسطين مثالًا على التدخل الخارجي الواضح في بناء دولة في العصر الحديث.
وتؤكِّد تهاني مصطفى أن عمليات إصلاح قطاع الأمن في السلطة الفلسطينية برعاية الغرب، هدفها تحقيق الاستقرار لإسرائيل، والتوسُّع الغربي النيوليبرالي. وتشير أيضًا إلى أن مفاوضات المرحلة الأولى في عام 1994، ومقترحات تعديل بنيتها التحتية والأمنية في عام 1995، وخارطة السلام في عام 2003، قد أعادت تعريف الأمن الفلسطيني وغاياته، وكشفت كيف تمَّت تشكيلاته بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين.
ويُظهر الفصل أن المجتمع الدولي يوافق ضمنًا على نموذج “السلام الليبرالي” لحلِّ النزاعات، وأن الليبرالية السياسية والاقتصادية تقدِّم مفتاحًا لحلِّ مجموعة واسعة من المشكلات، كالتخلُّف والمجاعة والصراعات. وفي السياق الفلسطيني، عكس كلٌّ من اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقيات، مثل بروتوكول باريس، وخارطة الطريق، وخطة الإصلاح الفلسطيني التي انتهجها رئيس الوزراء السابق سلام فياض، عكس كل ذلك مسارًا مشابهًا لنموذج السلام الليبرالي.
ويناقش الفصل أيضًا أثر فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وكيف اعتبرته “إسرائيل” بمثابة تهديد وجودي يجب التخلُّص منه، والذي يعود -حسب الكاتبة- إلى استناد حركة حماس إلى الرؤية الإسلامية والحقوق الوطنية بوصفها مرجعيةً لقبول أو رفض أي مسار للعمل السياسي أو الاقتصادي، بما يتنافى مع المبادئ الليبرالية.
وفي الفصل الثالث عشر بعنوان “قوة الدفع المسبق والاقتصاد السياسي للتخلُّص من النفايات”، تبحث صوفيا روبنز في الاقتصاد السياسي للنفايات، حيث تخلَّصت “إسرائيل” بعد أوسلو من مسؤوليتها عن الخدمات العامة، وجعلت مهمَّة التخلُّص من النفايات التي ينتجها الفلسطينيون في مناطق “أ” و”ب” على عاتق السلطة الفلسطينية.
قامت السلطة الفلسطينية بحصر التخلُّص من النفايات الصلبة في مكبَّيْن رئيسَيْن في جنين والخليل، وأغلقت المئات من مكبات البلدية في جميع أنحاء الضفة، مما أدى إلى زيادة تكلفة التخلُّص من القمامة على البلديات، وتحويل النفايات إلى عبء مالي، حيث يقع عبء سداد قروض الدولة للبنى التحتية الجديدة للمكبات على عاتق البلديات المثقلة أصلًا بالديون.
ويركِّز هذا الفصل على الوسائل التي استخدمتها البلديات لإيجاد إيراداتٍ تخدم فاتورة التخلُّص من النفايات المتزايدة، حيث مع اقتراب الانتفاضة الثانية من نهايتها، بدأت البلديات في شمال الضفة الغربية وجنوبها بربط رسوم إدارة النفايات بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، فيتم استخراج رسوم النفايات في كل مرة يعبئ فيها السكان بطاقات شحن الكهرباء، حيث تتحكَّم العدادات مسبقة الدفع في تدفق الطاقة الكهربائية إلى الوحدة السكنية أو التجارية، ومن ثَمَّ لا تسمح أبدًا بتدفق الكهرباء دون دفع مسبق.
وفي الفصل الأخير بعنوان “خاتمة: فلسطين غير معروفة”، تؤكِّد سارة روي أنه بالرغم من كل الحقائق المثبتة، والأبحاث المنشورة حول اضطهاد الفلسطينيين، فإن موقفهم الدولي أصبح أضعفَ مع مرور الوقت، ثم طرحت الكاتبة التفسيرات السياسية لذلك. كما ناقشت الكاتبة لماذا فشل الإنتاج الكبير من البيانات والإثباتات في تحسين ظروف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإمكانية الوصول إلى حلٍّ عادلٍ للصراع.
وختامًا، يمكن القول إن الكتاب احتوى في فصوله وأجزائه على العديد من النقاط المهمَّة التي عبَّر عنها الباحثون من خلال التطرق إلى جوانب مهمَّة في الاقتصاد السياسي الفلسطيني، وتأثيراته الداخلية والخارجية. وهو ما يجعل الكتاب مرجعًا مهمًّا للباحثين حول القضايا المعاصرة ذات العلاقة بالاقتصاد السياسي الفلسطيني.
يعبِّر الكتاب إلى حد كبير عن الواقع الفلسطيني، حيث اهتمَّ بالوصول إلى شرح تفسيري للواقع كما هو، وابتعد عن الإسهاب في شرح المفاهيم والتعريفات، والنظريات الاقتصادية. كما تميز الكتاب بالحيادية والموضوعية في طرح العديد من القضايا، التي تؤثر في العديد من الأطراف الفاعلة، دون انحياز إلى أي طرف.
لكن في المقابل، لم يقدِّم الكتاب صورةً كاملةً بشأن أهمية تفعيل منهجية الديمقراطية السياسية، وتأثيرها في الاقتصاد السياسي الفلسطيني، حيث لم يتطرق إلى أثر تعطيل المجلس التشريعي، وتعطيل نظام الانتخابات، في قصور الكثير من القوانين والتشريعات الاقتصادية، وفي تفرُّد السلطة التنفيذية في اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية، وتنفيذ مشروعات دون رقابة أو متابعة.
كما أن الكتاب لم يذكر بعض المؤثرات الفاعلة في الاقتصاد السياسي الفلسطيني، مثل التحويلات المالية من فلسطينيي المهجر، وخروج الفلسطينيين من الكويت، وعلاقات منظمة التحرير الفلسطينية مع الدول المجاورة، وتأثيرها الاقتصادي.