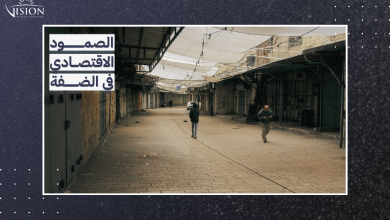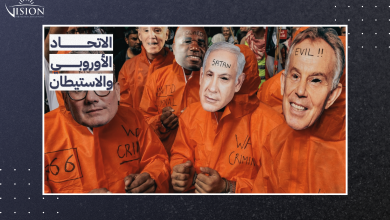ضمّ الضفة الغربيّة عبر الخنق الاقتصادي: تفكيك المجتمع وإعادة هندسة الواقع

رغد عزّام
تتبع الحكومة الإسرائيليّة إستراتيجيّة اقتصاديّة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع معيشي خانق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك كجزء من مساعيها لإنفاذ خطة ضم الضفة غير المعلنة. يتمثل هذا النهج في سياسات اقتصادية وأمنية معقدة، تشمل تقييد الحركة التجاريّة، وعرقلة الاستثمار، وإضعاف القطاعات الإنتاجيّة.
ولا تقتصر تداعيات هذه الإستراتيجية على الاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وذلك من خلال حملات الهدم التي ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهجمات المستوطنين المتكررة على القرى والتجمعات الفلسطينية، وفرض قيود صارمة على البناء في المناطق المصنفة (ج) بهدف عرقلة التوسع العمراني، وزيادة الكثافة السكانية في الأحياء والمدن الفلسطينية، إلى جانب تدمير البنى التحتية الأساسية، ما يعزز حالة الضغط والتضييق على السكان، وخلق بيئة معيشية طاردة تجبر الفلسطينيين على الهجرة “الطوعية”، أو البقاء في حالة خوف وعدم يقين.
يهدف هذا التقرير إلى تحليل السياسات الإسرائيلية المتلاحقة في الضفة الغربية، وبيان أثرها على الواقع الاجتماعي فيها.
أوّلًا: أزمة رواتب الموظفين العموميين
تعكس أزمة رواتب الموظفين العموميين في فلسطين اختلالات هيكليّة متعددة الأبعاد، إذ تتداخل فيها عوامل سياسية واقتصادية ومالية، مما يجعلها أزمة مركبة يصعب حلها دون معالجة جذور الخلل في الإيرادات العامة. إلا أنّ قرصنة أموال المقاصة من قبل “إسرائيل” تبقى العامل الأهم، إذ تشكل إيرادات المقاصة 54.2% من إجمالي الإيرادات العامة، مما يجعلها المصدر الأساسي لتمويل الرواتب. يضاف إلى ذلك تراجع إيرادات الجباية المحلية التي تمثل 24.9% من الإيرادات، نتيجة الانكماش الاقتصادي الحاد في الضفة الغربية وقطاع غزة بفعل الحرب المستمرة. كما ساهم انخفاض المنح والمساعدات الخارجية، التي بلغت مساهمتها 20.9% من الإيرادات، في تعميق الأزمة، حيث لم تعد كافية لتغطية فاتورة الرواتب والأجور، مما زاد من الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، وفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشيّة لسكان الضفة الغربية.
تشكّل إيرادات المقاصّة العمود الفقري لتمويل الحكومة الفلسطينية، وفي ذات الوقت، تعتبر بمثابة سيف مسلّط على رقاب الفلسطينيين. فاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجازها بشكل متكرر ومتصاعد، يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للخزينة الفلسطينية، ويفاقم الأزمة المالية. فقد تمكنت السلطة الفلسطينية من تسديد حوالي 71% من المبالغ المستحقة عليها مع نهاية الربع الثالث من عام 2024، كان النصيب الأكبر منها موجّهًا نحو فاتورة الرواتب والأجور، وعلى الرغم من ذلك، لا زالت المبالغ المستحقة أعلى بكثير مما تم دفعه بشكل فعلي. ما يعني المزيد من تراكم المتأخرات على الحكومة.
ومع أن استرجاع أموال المقاصة المحتجزة قد لا يمثل حلّاً جذريًّا نظرًا للخلل البنيوي في هيكل المالية العامة، في ظل تقلص الدعم الخارجي، سواء العربي أو الدولي، إلى مستويات متدنية. إذ أظهرت بيانات الربع الثالث من عام 2024 أن العجز المالي الحكومي بلغ نحو 96 مليون دولار. أما الدين الحكومي، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 21.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليار دولار، وهو ما يعادل 32.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تزايد أعباء الدين، أصبحت الحكومة غير قادرة على الحصول على تمويل إضافي من البنوك، إذ تُصنَّف ديونها الآن ضمن الديون المتعثرة وفق معايير التدقيق الخارجي، مما يعمّق أزمتها المالية، ويحدّ من قدرتها على إدارة التزاماتها.
وقد كان آخر ما تم صرفه، إلى حين كتابة هذه الورقة، 70% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون ثاني/ يناير 2025، والمستحقات المتبقية ستظل ديونًا مستحقة لصالح الموظفين. يُنذر تعثر صرف الرواتب بمشكلات متعددة في الاقتصاد المحلي، حيث يعاني الموظفون من تراجع قدرتهم على تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والسكن والتعليم، مما يزيد من معدلات الاعتماد على الاقتراض سواء من البنوك أو الموردين، ما يؤدي إلى ارتفاع المديونية الفردية. ومع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، تتأثر قطاعات التجارة والخدمات بشكل مباشر، مما يهدّد استدامة المشروعات الصغيرة، ويؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
اجتماعيًا، يعمّق هذا الوضع حالة عدم اليقين لدى شريحة واسعة من المجتمع، مما ينعكس على الاستقرار الأُسري، ويزيد من مستويات القلق والتوتر. كما أن تراجع القوة الشرائية للموظفين يؤدي إلى تآكل الطبقة الوسطى، مما يعزز التفاوت الاجتماعي، ويفاقم معدلات الفقر. في ظل هذه الظروف، تصبح الاحتجاجات والإضرابات خيارًا متوقعًا للموظفين، كما حصل عام 2023، وهو ما قد يؤثر على أداء المؤسسات العامة والخدمات الحيوية المقدَّمة للمواطنين، ويخلق مزيدًا من التدهور الاقتصادي والاجتماعي.
ثانيًا: تدهور القطاع الخاص
شهد القطاع الخاص في الضفة الغربية تراجعًا حادًّا نتيجة تداعيات الحرب على غزة والتصعيد العسكري الإسرائيلي، مما أدى إلى انكماش واسع في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية. تأثرت آلاف المنشآت الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص، حيث توقفت 29% منها عن العمل كليًا أو جزئيًا، في حين انخفض الإنتاج الكلي بنسبة 27%، ما يعادل خسارة قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي منذ اندلاع الحرب بحسب بيانات منظمة العمل الدولية.
أحد أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الانكماش الاقتصادي كان الحواجز العسكرية، والإغلاقات التي فرضتها قوات الاحتلال على المدن والقرى الفلسطينية، مما صعّب حركة العمال والتجار، وأعاق النشاط الاقتصادي. أدت هذه القيود إلى تراجع النشاط التجاري، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التنقل بين المدن، مثل التجارة والخدمات اللوجستية. كما أثّر تقييد الحركة في قدرة الأفراد على الوصول إلى أماكن عملهم، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية، وتعطيل النشاط الاقتصادي في العديد من المناطق الحيوية. إلى جانب ذلك، انقطعت سلاسل التوريد للمواد الخام والمنتجات، مما أدى إلى تراجع القدرة التشغيلية للعديد من المنشآت الصناعية والتجارية، وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية نتيجة انخفاض المعروض.
شهدت نسب التوظيف في القطاع الخاص انخفاضًا حادًا، حيث فقد هذا القطاع، في الضفة الغربية على وجه الخصوص، نحو خُمس الوظائف المتاحة، ما يعادل انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بالفترة السابقة للحرب. إذ تراجعت أعداد العاملين في قطاع الإنشاءات بنسبة 21%، وقطاع الصناعة بنسبة 22%، أما قطاع التجارة والخدمات فقد شهد تراجعًا بنسبة 15%. هذا التراجع أثر بشكل مباشر على مستوى الدخل للأسر الفلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وفي ظل هذه الظروف، تفاقمت أزمة سوق العمل بشكل غير مسبوق. فقد أدى إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين، إلى ازدياد معدلات البطالة في السوق المحلية. فكان القطاع الخاص، رغم معاناته من الأزمة الاقتصادية، هو الملجأ الأبرز للعمال المسرّحين، إلا أنه لم يكن قادرًا على استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، مما أدى إلى ارتفاع المنافسة على الوظائف المتاحة، وانخفاض الأجور، وانتشار العمالة غير المنظمة التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية الاجتماعية.
مع استمرار هذه الأزمة، بات من الواضح أن الأثر الاقتصادي للحرب سيمتد لفترة طويلة، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية. هذا التراجع لم يقتصر على الأرقام فحسب، بل انعكس على الحياة اليومية للمواطنين، حيث أصبح من الصعب على العاملين وأصحاب المشاريع الصغيرة، الحفاظ على مصادر دخلهم وسط هذه الظروف المتدهورة.
ثالثًا: التحكم في سوق العمل
يعكس منع العمال الفلسطينيين من العمل في السوق الإسرائيلية، مدى هشاشة الاقتصاد الفلسطيني، واعتماده الهيكلي على هذا المصدر الحيوي للدخل. وقد ترتب على تقييد إصدار التصاريح للعمال الفلسطينيين، تبعات اقتصادية واجتماعية كثيرة. وبحسب الإحصائيات المتاحة، فقد شكل العمّال الفلسطينيون في “إسرائيل” قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، نحو 17% من القوى العاملة في الضفة وغزة، ومع تقييد تصاريح العمل، تفاقمت البطالة بشكل حاد لتصل إلى 51% بحلول نهاية 2024، مع بلوغها 80% في غزة. إلى جانب ذلك، فقدت السلطة الفلسطينية نحو 50 مليون دولار سنويًا من الإيرادات التي كانت تتحصل عليها من ضرائب العمال في السوق الإسرائيلية. علاوة على ذلك، تسبب توقف تحويلات العمال، التي شكّلت مصدرًا رئيسًا للسيولة في السوق الفلسطينية، في تباطؤ الاستثمار، وضعف المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
لم يتمكن السوق المحلي من استيعاب العمال المُسرّحين، فأدت خسارة عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية لمصدر دخلها الأساسي، إلى تراجع قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية، وتتفاقم هذه التحديات بفعل الضغوط التضخمية، التي تُضعف القدرة الشرائية للأفراد، مما انعكس على مستويات الصحة والتعليم والتغذية، لا سيما بين الفئات الأكثر ضعفًا. مما أدى إلى تراجع الأجور، وانتشار العمالة غير المنظمة، وتدهور ظروف العمل، في ظل غياب الحماية الاجتماعية.
أدى انخفاض الدخول وتزايد فقدان الوظائف إلى زيادة القروض المتعثرة، مما رفع المخاطر المصرفية، وأدى إلى أزمة سيولة حادة. إلى جانب ذلك، دفع انعدام الفرص لدى عديد من الشباب، إلى الهجرة أو البحث عن مصادر دخل غير مستقرة، بما في ذلك العمل في ظروف استغلالية أو غير قانونية. كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية، وزيادة العبء على مظلات الحماية الاجتماعية، مما يهدد الاستقرار المجتمعي، ويعمّق التحديات التي تواجه الفئات الضعيفة، لا سيما النساء.
رابعًا: الهجمة الشرسة على شمال الضفة الغربية
تشهد مدن شمال الضفة الغربية، وخاصة جنين وطولكرم، هجمة إسرائيلية غير مسبوقة، تتجلى في عمليات عسكرية عنيفة تشمل اقتحاماتٍ متكررة، وقصفًا عنيفًا، وهدمًا واسعًا للمنازل والبنية التحتية، وذلك بهدف فرض واقع جديد في الضفة الغربية، يتمثل في زيادة الاستيطان، وتفريغ المناطق الفلسطينية من سكانها، وفرض مزيد من السيطرة الأمنية والعسكرية، والأهم من ذلك، إحداث واقع ديموغرافي طويل الأمد. هذه الاعتداءات، التي تستهدف مدن شمال الضفة الغربية، بما في ذلك المخيمات التي تشكل رمزًا حيًا لمعاناة الفلسطينيين منذ النكبة، تسببت في نزوح مئات العائلات بعد تدمير منازلها، أو تحويلها إلى مناطق غير صالحة للسكن. لم تقتصر الأضرار على المباني السكنية، بل امتدت لتشمل الطرق الرئيسة وشبكات الكهرباء والمياه، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين وحياتهم اليومية، وزاد من صعوبة وصولهم إلى أماكن عملهم أو مؤسساتهم التعليمية.
في ظل هذا الواقع، باتت العائلات الفلسطينية النازحة تواجه تحديات معيشية قاسية، بعد تغير أنماط الاستقرار السكاني، حيث اضطر الكثير منها إلى اللجوء لمناطق أخرى أكثر أمانًا، في ظل عدم توفر مساكن بديلة، أو تعويضات عن المنازل المدمرة. هذا النزوح القسري أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للأسر، إذ فقد العديد من الفلسطينيين مصادر دخلهم نتيجة هدم المحال التجارية، وتعطيل الأنشطة الاقتصادية بسبب الإغلاقات والحصار المفروض على بعض المناطق. وقد زادت معدلات الفقر والبطالة بشكل ملحوظ، خاصة مع تدمير الأسواق والمصانع والورش، ما أدى إلى انهيار قطاعات اقتصادية حيوية.
إلى جانب الأضرار الاقتصادية، انعكس هذا التصعيد العسكري على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، إذ وجدت العديد من الأسر نفسها مجبرة على مغادرة مجتمعاتها الأصلية، والتفرق في مناطق متباعدة، مما أدى إلى ضعف الروابط الاجتماعية، وتآكل بنية المجتمع المحلي. كما تسبب النزوح في ضغوط نفسية واجتماعية هائلة، وتزايدت حالات التوتر الأسري والاضطرابات النفسية نتيجة نزوح الأسر، وما ترتب عليه من ضائقة اقتصادية ومعيقات معيشية.
إن هذه السياسات الإسرائيلية لا تأتي بمعزل عن أهداف إستراتيجية أوسع، بل تندرج ضمن مخطط ممنهج لإعادة تشكيل الديموغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية. فمن خلال تكثيف الهدم والدمار، يسعى الاحتلال إلى تفريغ بعض المناطق من سكانها الفلسطينيين، وإجبارهم على الانتقال إلى مناطق أخرى أكثر ازدحامًا، مما يسهل السيطرة على أراضيهم، وضمها للمستوطنات الإسرائيلية المتزايدة. كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تكريس واقع جغرافي جديد يحشر الفلسطينيين في جيوب معزولة، أشبه بكانتونات، بينما يتم توسيع المستوطنات، وربطها بشبكة طرق حديثة تعزز الهيمنة الإسرائيلية على الأرض.الضفة
خامسًا: خطة ضم الطاقة
في 31 تشرين أول/ أكتوبر 2024، قررت الحكومة الإسرائيلية بناء محطتين لتوليد الطاقة في الضفة الغربية، وتخصيص 2000 دونم لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. هذه المشاريع الجديدة تتضمن بناء محطتين لتوليد الكهرباء بسعة إجمالية لا تقل عن 1300 ميغاوات، تهدف إلى تلبية احتياجات إسرائيل والمستوطنات، مع تخصيص جزء من الكهرباء للفلسطينيين.
يأتي هذا القرار في إطار “الخطة الاقتصادية لعام 2025″، التي تهدف إلى “تعزيز أمن الطاقة في إسرائيل”، وذلك من خلال توسيع البنية التحتية للطاقة داخل المناطق الفلسطينية وضم المزيد من الأراضي لمصلحة الاحتلال، والتي سيتم استغلالها لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، مما يزيد من اعتماد الفلسطينيين على الكهرباء الإسرائيلية. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة “ضم الطاقة”، التي تستغل الموارد الفلسطينية لصالح الاحتلال، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يحظر استغلال الأراضي المحتلة لمصالح السلطة القائمة بالاحتلال[1].
يشكل استهلاك الفلسطينيين حوالي 10% من إجمالي الكهرباء المنتجة في إسرائيل، وتستفيد إسرائيل من بيع الكهرباء للسلطة الفلسطينية بأسعار مرتفعة. وبالرغم من محاولات الاستغناء عن الطاقة الإسرائيلية عبر استيرادها من الأردن، أو إنشاء محطة طاقة في جنين، فإن إسرائيل تواصل احتكار قطاع الكهرباء في الضفة الغربية.
تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تخصيص 2000 دونم لحقول الطاقة الشمسية في الضفة الغربية لصالح المستوطنين ورجال الأعمال الإسرائيليين، بينما يواجه الفلسطينيون صعوبة في إنشاء مشاريع مماثلة؛ بسبب السيطرة الإسرائيلية على 60% من الأراضي في المنطقة C. وتستمر إسرائيل في الاستفادة من هذا الاعتماد الفلسطيني على الطاقة الإسرائيلية، مما يعزز من هيمنتها الاقتصادية والسياسية، ويزيد من قضم الأراضي الفلسطينية وضمها لسيطرتها.
يؤدي هذا الواقع إلى تفاقم الأعباء المعيشية على الأسر الفلسطينية، حيث تتأثر أسعار الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية بالتسعيرة الإسرائيلية، والضرائب المفروضة من قبل الاحتلال. كما أن الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، الناتجة عن سياسات إسرائيلية مقصودة، أو قيود مالية مفروضة على السلطة الفلسطينية، تؤثر سلبًا على المستشفيات، والمدارس، والقطاعات الإنتاجية، مما يعطل الخدمات الحيوية.
الخاتمة
في ظل هذه الظروف القاسية، يواجه الفلسطينيون تحدّيًا مصيريًّا للحفاظ على وجودهم وهويتهم الوطنية، وسط محاولات مستمرة لإجبارهم على التهجير القسري. ورغم كل هذه الممارسات، يواصل الفلسطينيون صمودهم، معتمدين على تماسك مجتمعي داخلي وجهود إغاثية، إلا أن استمرار هذا العدوان دون تدخل دولي حقيقي، سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الضفة الغربية.
فقرصنة أموال المقاصة، أدت إلى أزمة رواتب خانقة انعكست على الاقتصاد المحلي والاستقرار الاجتماعي. كما أن تدهور القطاع الخاص نتيجة الإغلاقات والتضييقات الأمنية، ساهم في ارتفاع معدلات البطالة، بينما زاد منع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل، من تعقيد الأزمة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر، ووسّع الفجوة الاجتماعية.
في المقابل، فإنّ الهجمة الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية، وما يرافقها من عمليات هدم وتهجير، تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الديموغرافي لصالح الاستيطان، في حين تندرج خطة ضم الطاقة، ضمن إستراتيجية أوسع للسيطرة على الموارد الفلسطينية، وتعزيز الهيمنة الاقتصادية للاحتلال. وتسعى “إسرائيل” عبر هذه السياسات كلها إلى إبقاء الفلسطينيين في حالة من العجز الاقتصادي والاعتماد القسري ومواجهة ظروف حياة مستحيلة تجبرهم على خيار الهجرة “الطوعية”، التي يصرّح اليمين الحاكم في “إسرائيل” عنها، ويسعى إلى تنفيذها بشكل حثيث.
[1] ينص القانون الدولي الإنساني على أن تلزم دولة الاحتلال بضمان عدم استغلال الموارد الاقتصادية للأراضي المحتلة إلا لصالح السكان المحليين، وليس لمصلحة الاحتلال. ويُحظر أي تغييرات ديموغرافية أو اقتصادية تفرضها دولة الاحتلال بهدف استغلال الموارد لصالحها.