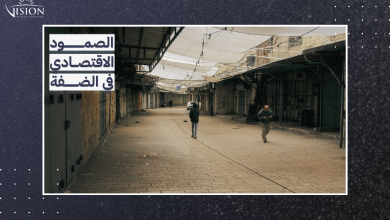مشروع الإمارات: أرخبيل عشائري مقابل المشروع الوطني الفلسطيني

برز الجدل في الوسط الإعلامي مؤخرا عن مبادرة وُصفت بـ”الخارجة عن المألوف”، تسمى “بمشروع الإمارات” أو “خطة العشائر”. تقوم هذه الخطة بشكل أساسي على افتراض استشراقي بأن المجتمع الفلسطيني، لا سيما في الضفة الغربية، قائم على بنى عشائرية يمكن توظيفها لتشكيل كيانات حكم ذاتي تدار محليا دون الحاجة إلى دولة فلسطينية قائمة على أسس حداثية. يقدّم أصحاب الخطة رؤيتهم باعتبارها بديلا عمليا كفيلا بتصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل، فيما ينظر الفلسطينيين إليها كمحاولة لإعادة إنتاج “روابط القرى” بصيغة جديدة، وباعتبارها مسعى إلى تفتيت الهوية الوطنية إلى أرخبيل عشائري موزّع على عدة كانتونات معزولة.
تسعى أطروحة الامارات إلى ترسيخ سلام اقتصادي يستند إلى بنية اجتماعية تقليدية، لكنه لا ينفك عن تمثله كهندسة تفكيك تعزل المدن الفلسطينية عن بعضها أكثر فأكثر، وتفتت مشروعهم الوطني لصالح هويات قبلية ومناطقية سائلة؛ نظرا إلى أن الغاية الإسرائيلية المتمثلة في السيطرة الأمنية الشاملة وتحييد أي تطلعات سياسية فلسطينية حقيقية. وبينما يهلّل قلة من وجهاء العشائر في الخليل لهذه الخطة، فإن حاضنة الرفض أوسع بكثير، والموانع ليست هينة، على اعتبار أن حلا قائما على الكانتونات أو الإمارات العائلية لن يكون سوى تناقض صارخ مع ما راكمه النضال الوطني الفلسطيني وتكريس للمعاناة الفلسطينية طويلة الأمد ولكن في ثوب جديد، ولطالما نُسجت أثواب الاستعمار ومزقتها إرادة التحرر.
ولادة الفكرة: من طرح أكاديمي إلى مخطّط ميداني
تعود الجذور الأولى لـحل الإمارات إلى عام 2012، حين قدّم المستشرق الإسرائيلي مردخاي كيدار، والأستاذ بجامعة بار إيلان، مقترحا يقضي بإنشاء ثماني إمارات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ركّز كيدار على بنية القبائل والعشائر في المدن الكبرى مثل الخليل ونابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية ورام الله وأريحا، وساق حجة قوامها أنّ فشل تجربة الدولة الحديثة والمركزية في دول عربية أخرى سوريا، العراق، ليبيا واليمن يعود إلى غياب الانسجام القبلي، في الوقت الذي تحرز به الدول الخليجية ذات النظام العشائري قدرا عاليا من الاستقرار والازدهار.
الهدف المعلن من هذه الحل هو منح العديد من المدن كامل صلاحيات الحكم الذاتي، من إدارة الاقتصاد والتعليم والقضاء وغيرها. أما المناطق الريفية الفاصلة بين المدن -والتي يعتبرها كيدار قليلة السكان- فستُضم إلى إسرائيل مع منح المواطنين الفلسطينيين هناك جنسية أو إقامات دائمة. وبذلك يمسي الفلسطينيون متقوقعون في جزر ذات استقلال داخلي، وتلتزم إسرائيل بتوفير حرية التنقل بينها وحمايتها أمنيا من “التهديدات الخارجية”، على حد توصيف كيدار.
الخليل: حقل التجربة الأول
رأى مردخاي كيدار في الخليل تحديدا النموذج الأكثر ملاءمة لتطبيق الخطة: لما تمثله من مجتمع محافظ شديد التمسك بعشائره القوية (الجعبري، أبو سنينة، القواسمة، التميمي وغيرهم). هناك، بدأت اتصالاتٌ منذ أعوام بقيادة نير بركات (وزير في حكومة نتنياهو ورئيس بلدية القدس السابق)، الذي استضاف شيوخا من الخليل للحديث حول فكرة إقامة “إمارة مستقلة” تفكّ ارتباطها بالسلطة الفلسطينية وتتعهد “بـالسلام الكامل والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية”.
تعززت اللقاءات مؤخرا، ووصلت إلى حد توقيع وجوه عشائرية بارزة في الخليل (بقيادة الشيخ وديع الجعبري) رسالة موجّهة للحكومة الإسرائيلية في 24 مارس/آذار 2024. في تلك الرسالة، يتعهّد هؤلاء بـنبذ العنف وعدم التسامح مطلقا معه، وإرساء علاقة رسمية مع إسرائيل عنوانها الاعتراف بيهوديتها والانضمام لاتفاقيات إبراهيم. بالمقابل، يطالبون بفصل الخليل عن السلطة الفلسطينية وإعطائها وضع “الإمارة” لتدير شؤونها بعيدا عن الإطار السياسي لمنظمة التحرير والسلطة المركزية في رام الله. وتشير بعض المعلومات إلى أن الجعبري أقام أكثر من 12 لقاء مع نير بركات.
استند الموقّعون على سردية أن السلطة فشلت، وبأن الخطوة ستجلب انتعاشا اقتصاديا عاجلا وقد تحوّل الخليل إلى مدينة تشبه “دبي” في الرخاء. يقول بعضهم صراحة: “لا أحد يحترم السلطة الفلسطينية ولا أحد يريدها”، متهمين السلطة بالفساد والضعف وعدم القدرة على حماية المواطنين من هجمات المستوطنين أو من التدهور الاقتصادي. وعرضوا إجراءات مع إسرائيل عبر مقترح تشغيل آلاف العمّال من الخليل في القطاعات الإسرائيلية مقابل التزام الإمارة عشائريا بمراقبة الحراك الأمني ومنع أي أعمال مقاومة تنطلق من مناطق نفوذها.
هل تمثل الامارات أنموذجا لـ”بنتوستنة” جديدة؟
من منظور العديد من الفلسطينيين، تستحضر فكرة “حل الإمارات” تجارب خطيرة من الماضي. ففي ثمانينيات القرن الماضي حاولت إسرائيل تأسيس ما عُرف بـ”روابط القرى” لخلق قيادات محلية بديلة تحظى بدعم الاحتلال مقابل التخلي عن منظمة التحرير. اصطدمت تلك الروابط بمقاومة شعبية شديدة ومنظمة في الانتفاضة الأولى، وقُبر المشروع، أو تم استبداله باتفاقية أوسلو. ويُرى حل الامارات على أنه مخطط لتقسيم المجتمع الفلسطيني وتجزئته وانه “ليس إلا نسخة محسّنة من روابط القرى”، بل قد يبدو أقرب إلى “بنتوستانات” تُدار بواجهات حسب الطلب وتخضع أمنيا وسياسيا لدولة الاحتلال.
تعبّر هذه الرؤية عن قناعة راسخة بأن الوعي الوطني الفلسطيني قائم على وحدة المصير، سواء في الضفة وغزة والقدس والشتات، وأن أي تجزئة تعني تشتيت مشروع التحرر واستبداله بتحالفات موضعية منفصلة، ضمن ما يُوصف بـ”الأرخبيل العشائري”. بهذا المعنى، لا يُعدّ تمكين العشائر بديلا واقعيا للمشروع الوطني الفلسطيني، إذ إنّ التناقضات العائلية والمعيار الحزبي الديني والجهوي قد تفجر صراعا فلسطينيا داخليا أشد ضراوة. كما أنّ إقامة إمارة واحدة في الخليل، مثلا، قد تحفّز عشائر في نابلس أو جنين على السير في المسار ذاته أو رفضه بقوة وإذا بالحالة الفلسطينية تجر إلى مربع مضاعفة الاستنزاف فوق الاستنزاف.
“السلطة الوكيلة” هو المصطلح الذي يستخدمه الوطنيون الفلسطينيون لوصف أي جسم محلي الحلّول يحلّ محلّ التطلعات الوطنية التي تتبنها الحركة الوطنية الفلسطينية. حيث يؤدي الوكيل الأمني والاقتصادي دور الاحتلال ولكن بتجسيد لنموذج من “النيوليبرالية الأمنية” القائم على قاعدة التطبيع البنيوي. ذلك التطبيع البنيوي الذي يدمج الارتباط بإسرائيل في نسيج الحكم اليومي داخل تلك “الإمارات”، بحيث تنشأ علاقة تبعية اقتصادية وأمنية دائمة. بمعنى آخر، تتحول العشائر إلى حارس محلي للمصالح الإسرائيلية، وربط هذا الدور بامتيازاتهم المالية والتجارية.
هل تكفي وعود الازدهار؟
يطرح المتحمسون القلة لمشروع “الإمارة” في الخليل عن حزمة من “المكاسب الاقتصادية” تجذب شرائح معينة من رجال الأعمال والعاطلين عن العمل والشباب الطامح للمستقبل. يقول أحد الشيوخ: “إذا حصلنا على مباركة أميركية، فستتحول الخليل إلى دبي أخرى”. ويستند هؤلاء إلى الوعود الإسرائيلية المتمثلة بمنح تصاريح عمل قد تصل إلى 50 ألف عامل، وتسهيلات في القطاعات الصناعية والزراعية، وإمكانية إقامة منطقة اقتصادية مشتركة. وهكذا تأتي هذه الوعود بغرض اغراء فئات تبدو مرهَقة من الحصار والتدهور المعيشي وبطالة الشباب في الضفة منذ سنوات.
يدرك المروّجون “لحل الإمارات” أنهم لا يستطيعون إنجاح مشروعهم من دون دعم خارجي أميركي ورعاية إسرائيلية كاملة. من الواضح تعويل تلك القلة من الشيوخ على ما يصلح تسميته “اللحظة الترامبية”، في إشارة إلى امكانية تبني إدارة ترامب موقفا تصفويا لا يضع أي وزن للحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية، وتتماهى في الوقت ذاته مع صيغ تخدم الرؤية الإسرائيلية الأوسع. قد يتيح لهم ذلك حشد تمويل دولي وإعلامي لترويج الفكرة، خصوصا أن الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب سبق أن انضمت إلى اتفاقيات إبراهيم، الأمر الذي يمثل أرضية خصبة كما يعتقدون لانضمام كيان فلسطيني عشائري جديد في الخليل تحت نفس الشعارات.
قد يتصور البعض أن ثمة تربة صالحة لإطلاق “مشروع الإمارات”، إلا أن السياق الأعمق بمجمله يقدّم جملة عقبات أكثر صلابة. إذ إنّ مجرد وجود بنية عشائرية لا يعني امتلاك “تفويض شعبي” بديلاً عن مشروع وطني يرى فيه معظم الفلسطينيين سبيلًا للتحرر وللخلاص من الاحتلال. فما تملكه العشائر من نفوذ اجتماعي أو أمني لا يلغي الثوابت الفلسطينية، كما أنّ “انتقاد السلطة” لا يعني قطعا الانخراط في تسويات من وراء ظهر المكونات الفلسطينية وقواها وفصائلها.
يجدر استحضار تجارب سابقة لوعود الاستعمار المزيفة، وأوسلو ليس بمثل بعيد، حيث تتحول الوعود إلى مجرد جزرة معلّقة بخيط. فرغم الحديث عن فرص العمل، دائما تبقى المفاتيح بيد إسرائيل، التي ما تلبث أن تخرق الاتفاقيات وتنسحب منها ملوحة بمخالب القوة، وتستخدمها مزاجيا للابتزاز ولتحقيق أقل الأثمان الاستعمارية ضمن الجشع الصهيوني المتنكر لكرامة الغير، فلا حد للطمع الاستعماري الإسرائيلي إلا الاستعباد الكامل؛ فمزاج يميني تطرفي قد يلغي أيا من الامتيازات الاقتصادية أو الادارية. علاوة على ذلك، الإنشاء المزعوم لـإمارة سيتطلب رسم حدود إدارية وعسكرية، بما قد يخلق “حواجز سيادية” جديدة بين المدن الفلسطينية المتجاورة، وهو ما يعوق حركة التجارة والنقل. كما لا يملك أي جسم جديد اعترافا دوليا واسعا، ما يهدد الاستثمارات أصلا بالجمود بدل الازدهار. ويعلق ناقدون لـخطة الإمارة بأن ما تعرضه إسرائيل ليس سوى “اقتصاد ريع” مؤقت غرضه التخدير، مقابل انتزاع شرعية سياسية وأمنية تخدم طموحها الاستيطاني الأكبر.
ختاما، يشكل حل الإمارات مزيجا خطيرا من التهديدات على الحالة الفلسطينية، ويمثل بابا واسعا لتأجيج الاحتقان الداخلي كانقسام فوق الانقسام، وتكريس للفوضى أكثر من كونها حلا سحريا يحقق السلام والازدهار. وفي ضوء توازنات القوى الراهنة، لن تمضي الفكرة قدما إلا بشق الأنفس، ولربما لن يكتب لها النجاح أصلا إلا إذا أجبر الفلسطينيون على خيارات ضيّقة وقهرية تفوق طاقة الانسان على المواجهة، في ظل انهيارات ممكنة في البنى السياسية والاقتصادية والأمنية. وهذا سيناريو -إن وقع- قد يجرّ إلى تبعات غير محسوبة؛ ذلك أن “بنتوستنة” الأرض وإحلال الهوية العشائرية محل الوطنية لا يعني سوى تأجيل تدافعات ومواجهات مصيرية قابلة للانفجار ولو بعد حين.