حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية

في نهاية مارس/ آذار الماضي أدت الحكومة الفلسطينية الـ19، برئاسة الدكتور محمد مصطفى، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، وقدم رئيس الحكومة تشكيلة حكومته، والأسس التي يقوم عليها برنامج الحكومة، وسط سيل من التساؤلات حول قدرتها على تحقيق ما جاء في برنامجها.
وقد رافقت تشكيل الحكومة، وتوقيته، نقاشات واسعة، دفعت مركز رؤية للتنمية السياسية و موقع الجزيرة نت، إلى استقراء آراء شريحة من النخب السياسية والأكاديمية، حول الكثير من المحاور، في محاولة لفهم الدلالات السياسية بشأن الذهاب إلى هذه التشكيلة في هذا التوقيت.
كما تناقش الآفاق المستقبلية التي قد تساعد الحكومة على تحقيق برنامجها الفعلي، وتلك التي قد تجعلها تلقى مصير باقي الحكومات التي سبقتها وتعيد إنتاج ذات المنهجيات، دون أن تترك بصمات فعلية في الملفات المطروحة أمامها.
وتم استعراض هذه الآراء من خلال مجموعة من المحاور والأسئلة:
- ما أهداف التشكيل دون توافق وطني، وما الذي قد يميزها عن سابقتها؟
- ما علاقة تشكيل هذه الحكومة بالحديث عن ترتيبات اليوم التالي للحرب على غزة؟
- لماذا خلت الحكومة من شخصيات سياسية بارزة، وتركزت تشكيلتها على التكنوقراط غير المعروفين للجمهور؟
- كيف يمكن لهذه الحكومة أن تتعامل مع الأزمة الوطنية الفلسطينية؟
- وهل تستطيع التعامل فعليًّا مع الحرب على غزة ومخرجاتها دون أي توافق وطني، في ظل موقف غالبية الفصائل الفلسطينية الرافض لطريقة التشكيل، وفي ظل الملفات السياسية والوطنية العالقة؟
ويمكن تلخيص آراء الخبراء بما يلي:
- هناك معضلة أساسية في أي حكومة فلسطينية تتشكل منذ عام 2007 حتى الآن، وهي أن جميع الصلاحيات السياسية والأمنية والتشريعية بيد الرئيس الفلسطيني، وأن تغيير الحكومات لا يعني تغيير البرامج والسياسات، وبالتالي لن يكون بيد الحكومة أي دور جوهري، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة دور الحكومة بشكل واضح وفعال.
- افتقر تشكيل الحكومة إلى الحد الأدنى من الحوار الوطني حتى قبل تشكيلها، وبالتالي قد يكون تعاملها مع الأزمات الفلسطينية صعبًا، وخاصة العلاقة مع الاحتلال.
- من المفترض أن تكون الحكومة جزءًا من النقاش الدائر فيما بعد السابع من أكتوبر، ولكن ذلك لم يكتمل لأسباب تتعلق بالانقسام والضغوط الخارجية.
- جاء تشكيل الحكومة من التكنوقراط لإقصاء الفصائل الفلسطينية عن عملية المشاركة في اتخاذ القرار.
- معظم وزراء الحكومة جاؤوا من القطاع الخاص وقطاع الأعمال؛ مما قد يجعلها بعيدة عن هموم المواطن الفلسطيني، وخاصة في ظل غياب الخبرة في العمل الوطني.
- لم ترافق مشاورات تشكيل الحكومة أي توافقات وطنية، ولا ضمانات دوليّة لمواجهة الأزمات التي كانت تخنق الحكومة السابقة. حتى داخل “فتح” نفسها لم تكن هناك مشاورات عميقة، وبالتالي لن تستطيع الحكومة أن تحدث تغييرًا في الملفات الجوهرية.
- جاء تشكيل هذه الحكومة في ظل الحديث عمّا يسمى “اليوم التالي” في غزة، وتصاعد الضغوط الخارجية لإجراء “إصلاحات” في السلطة حتى تعود إلى غزة. وحتى يتحقق ذلك عليها أن تنشغل بالمهمات الرئيسة التي تريدها إسرائيل وأميركا وبعض الأطراف الدولية، وهي تدمير قدرات المقاومة الفلسطينية، و”استكمال سحب سلاح المقاومة”.
- ما لم يكن هنالك اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فلن تستطيع أي حكومة ممارسة دورها في غزة، وقد تتطلب إدارة قطاع غزة مستقبلا دمج حماس في البنية السياسية الفلسطينية.
- الحرب على غزة وما قد يترتب عليها لاحقا، هي قضية أكبر من هذه الحكومة، وملف دولي يشكّل تحدّيًا على مستوى كبير.
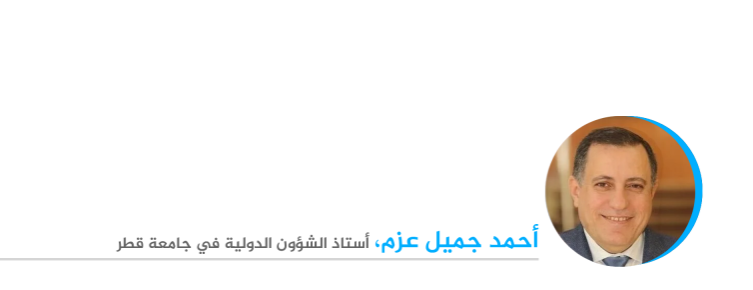
هناك معضلتان متصلتان ببعضهما في حكومة محمد مصطفى، كما في أي حكومة فلسطينية يمكن أن تتشكل حاليًّا، الأولى أنّ مختلف الصلاحيات السياسية والأمنية والتشريعية للحكومة هي الآن بيد شخص واحد هو الرئيس عباس الذي انتُخب منذ نحو عشرين عامًا. والثانية أنّ العلاقة بين “الرئاسة” و”الحكومة” متوترة بنيويًّا منذ استحداث منصب رئيس الحكومة عام 2003.
الرئيس عباس يعلم أنّه يُجري تغييرًا لا تغيير فيه، فالحكومة السابقة كانت تسمى “حكومة حركة فتح”، بحكم النقاشات التي جرت عند تشكيلها، ولأنّ رئيسها عضو في اللجنة المركزيّة للحركة، وكانت “حكومة الرئيس” فقط.
وحكومة محمد مصطفى وهوية رئيسها وطريقة تعيينها، كلها لم تعكس أي شيء يجري في غزة، وجاءت طريقة تشكيلها بقرار واختيار الرئيس لتقطع الطريق على أي تكهنات بأنّ هذه الحكومة مختلفة، أو لديها فرص نجاح مختلفة.
معروفٌ منذ سنوات أنّ محمد مصطفى، سيكون هو خليفة محمد اشتيّة في رئاسة الحكومة، وذلك لأن الرئيس عبّاس يريده رئيسًا “لحكومته”، مثلما أراده وأراد معه زياد أبو عمرو، عضوين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد كان واضحًا أن مصطفى على “لائحة مرشحي الرئيس” منذ أن عُيّن هو و زياد أبو عمرو نائبين لرئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله عام 2013، وكان واضحا في حينه أن لهما علاقة مباشرة مع الرئيس عباس.
لم تسبق تشكيل الحكومة توافقات دوليّة أو محلّية، فلا مشاورات بين الفصائل للاتفاق على برنامج وطني، ولا مفاوضات مع إسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية لحلحلة الأزمات التي كانت تخنق الحكومة السابقة، مثل إعادة أموال المقاصّة. وحتى داخل “فتح” لم يتسرب أي شيء يُشير إلى أنّ اختيار مصطفى خضع لنقاش حقيقي داخل اللجنة المركزية للحركة.
وقد ورثت حكومة مصطفى كل الأزمات التي عانت منها الحكومة السابقة، من الأزمة المالية إلى أزمة توزيع الصلاحيات في المشهد الفلسطيني. فهذه الحكومة لا يوجد لها مرجعية برلمانية، أو انتخابية، أو فصائلية، وبالتالي فمرجعيتها السياسية الوحيدة هي الرئيس. وهذا يوصلنا إلى اقتناع مفاده أن الحكومات الفلسطينية ستبقى خارج إطار جزء كبير من عملية التشريع، التي تقع في يد الرئيس وفريقيه القانوني والإداري، في ظل تعطل المجلس التشريعي وغيابه.
منظمة التحرير هي إطار جبهوي عريض توافقي للقوى الفلسطينية، لذلك فإنّ الانتخابات، أو التوافق الوطني، يجب أن يبقى أساس النظام السياسي الفلسطيني. أمّا التذرع بأنّ القانون الأساسي يعطي الرئيس صلاحية اختيار الحكومة، ومنحها الثقة، في ظل غياب المجلس التشريعي، فهو أمر ينبّه للخلل في النظام السياسي، أكثر مما يعطي شرعية لمثل هذا الوضع.

من المهم الأخذ بعين الاعتبار التوقيت الذي تشكلت فيه هذه الحكومة، إذ إنها جاءت في ظل الحديث عمّا يسمى “اليوم التالي” في قطاع غزة، وتصاعد الضغوط الخارجية على السلطة الفلسطينية لإجراء “إصلاحات”، وجوهر هذه الإصلاحات يعني أن السلطة حتى تعود إلى غزة عليها أن تنشغل بالمهمات الرئيسة التي تريدها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وبعض الأطراف في الاتحاد الأوروبي، أي أن تستكمل المهمة التي بدأها جيش الاحتلال بعد السابع من أكتوبر في قطاع غزة، وهي تدمير قدرات المقاومة الفلسطينية أو “استكمال سحب سلاح المقاومة الفلسطينية”.
ترافق ذلك مع الحديث عن إدخال إصلاحات في جوهرها تقليص صلاحيات رئيس السلطة لحساب رئيس الوزراء، وقد جرى الحديث على المستوى الدولي والإقليمي عن عدة أسماء لتولي هذا المنصب، ولذلك تقدم الرئيس بهذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات؛ ليقطع الطريق على أية محاولات لتحجيم صلاحياته ودوره وتحويله إلى مجرد رئيس فخري، وذلك من خلال اختيار شخصيات تبدو وكأنها تكنوقراط، ولكنها موالية للرئيس في نهاية المطاف.
كما أنه بهذه الخطوة قطع الطريق على أي تدخل داخلي فلسطيني من أجل الوصول إلى توافق حول تشكيل هذه الحكومة، بمعنى أنه اتخذ هذا القرار بشكل منفرد دون التشاور مع الفصائل التي كانت تستعد للحوار في موسكو، ولا حتى مع حركة فتح نفسها، إذ لم تجتمع اللجنة المركزية لحركة فتح لتقرر في الأمر.
لذلك أثارت هذه الخطوة استياءً واسعًا، ليس فقط لدى الفصائل التي اتهمت الرئيس بأنه يتخذ القرارات بشكل فردي دون توافق وطني، أو على الأقل دون ما سمي تاريخيًّا “الشرعية الفصائلية”، ولا من خلال شرعية شعبية عبر الانتخابات، ولا من خلال الحصول على تأييد من داخل حركة فتح؛ مما أظهر استياءً من داخل حركة فتح نفسها من الطريقة التي شُكّلت بها هذه الحكومة.
ولذلك فالسبب الرئيس لتشكيل هذه الحكومة من حيث المعطيات السابقة، هو رغبة الرئيس في الحفاظ على حكمه الفردي في الضفة الغربية تحديدًا.
ينعكس هذا الأمر على تشكيل الحكومة من شخصيات تكنوقراط، وهذا الأمر جاء لإقصاء الفصائل الفلسطينية عن عملية المشاركة في اتخاذ القرار، وحتى لا تشكل عبئًا على قرارات الرئيس والسياسات التي يريد تبنيها، ولذلك فهو يريد حكومة موالية له، وأفضل طريقة لذلك هي تشكيل حكومة تكنوقراط غير منخرطة في الشأن العام؛ مما يمكّنه من تحجيم دور الوزارء.
ويُذكر هنا أن لدى رئيس الوزراء محمد مصطفى رؤية تقوم على الفصل بين الجانب السياسي والجانب الخدماتي، بحيث تتكون الحكومة من كفاءات لإدارة الشؤون الخدمية، أما الشأن السياسي فهو من خارج اختصاص الحكومة، وهو خاضع لمنظمة التحرير.
وهذه الرؤية، في تقديري، محكوم عليها بالفشل. والآن بعد تشكيل الحكومة يثبت أن هذا الأمر غير ممكن، لا سيما أن محمد مصطفى نفسه هو شخصية سياسية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أي أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني؛ مما جعل هذا الأمر يبدو مستغربًا.
جاء في خطاب التكليف الصادر عن الرئاسة الفلسطينية أن من مهام الحكومة العمل على توحيد المؤسسات بين الضفة وغزة. وهذا الموضوع غير ممكن دون التوجه إلى الفصائل وتحديدًا حركة حماس؛ لأن حماس ما زالت باقية ولم تتنازل عن دورها السياسي والإداري في القطاع.
صدرت تصريحات غريبة من الحكومة الحالية تقول بأن موضوع إدارة غزة هو شأن يعود إلى السلطة الفلسطينية والحكومة، ولا أحد يقرره غيرهما، وهذا يعني أن هناك تجاهلا كاملا للواقع الموجود في قطاع غزة.
يجب أن يضع رئيس الوزراء في ذهنه أن القضية الرئيسة هي الاحتلال، الذي يهيمن على الضفة بمختلف تقسيمات أوسلو الجغرافية، وليست العودة إلى قطاع غزة، فالحكومة فعليًّا غير قادرة على العمل في الضفة الغربية، وأخشى أن الحكومة لا تدرك هذه الحقيقة، وتظن أن هناك إمكانية للتفاهم مع الاحتلال، وهو ما ثبت فشله خلال 30 سنة.
ومن جانب آخر، تواجه الحكومة صراعًا على الصلاحيات مع الرئاسة نفسها، فالرئيس يحتكر معظم الصلاحيات، ودون أن يمنح رئيس الوزراء الصلاحيات التي يكفلها له القانون الأساسي لا يمكنه أن يمارس دوره المنوط به.
فالرئاسة الفلسطينية لا تتدخل فقط في تشكيل الحكومة وفرض الشخصيات عليها، وإنما أيضًا في سياسات الحكومة وقراراتها. وقد أثبتت التجارب السابقة أنه بموازاة الحكومة تكون هناك حكومة ظل في المقاطعة، وهي الحكومة الحقيقية التي تحكم وتدير كل شيء.

جاء تشكيل الحكومة الجديدة في توقيت يتطلب إعادة صياغة دور الحكومة الفلسطينية لتكون أكثر تمثيلًا سياسيًّا وجغرافيًّا، ولكن للأسف لم يتم هذا، ولم يقع تشاور وطني عريض، ولربما كان الهدف الأول الاستجابة لمطالب الإدارة الأميركية وأوروبا، المتمثلة بإحداث إصلاح في مؤسسات السلطة، لتصبح أكثر شفافية ومهنية، وكخطوة استباقية للقيام بدورها في إدارة شؤون السلطة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة حسب رغبتهم.
لا شك في أن تشكيل الحكومة الجديدة دون توافق وطني في ظل الحرب على قطاع غزة، يعد قفزة في الهواء ومراوحة في المكان؛ لأنها لن تضيف جديدًا فيما يتعلق بالوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء البيت الفلسطيني على أسس من الشراكة والتمثيل والوحدة والمهنية.
لا يوجد اختلاف كبير بين حكومة اشتية السابقة وحكومة محمد مصطفى الحالية، من حيث الدور الممكن والإمكانيات وبيئة العمل، ولا أتوقع أن تكون هناك نقلة نوعية في أداء الحكومة الجديدة، والسبب في ذلك أن دور السلطة لن يخرج عن نطاق الجغرافيا السياسية والبنية التنظيمية والقانونية التي تمارس فيها نفس الأدوار منذ عام 2007، بل إن الجغرافيا السياسية والفضاء الوطني، يزداد انحسارًا يومًا بعد يوم مع التوسع الاستيطاني وتشدد الحكومة الإسرائيلية الحالية.
لقد شُكّلَت الحكومة من ناحية شكلية من شخصيات مهنية واقتصادية كان بعضها قد شغل مناصب هامة في مؤسسات اقتصادية وتعليمية، أو عمل مع مؤسسات دولية، ولكن مع كل ذلك فإنها كسابقاتها، ستبقى مكبلة بسبب الديون المستحقة، وعجز الموازنة، وعدم وجود أفق سياسي، وكذلك بسبب إغلاق الباب أمام أي فرصة لإنهاء الانقسام.
تميزت هذه الحكومة عن الحكومة السابقة بوجود عدد أكبر من الوزراء من قطاع غزة، وربما يكون ذلك من أجل الاستعداد لإدارة الأوضاع في قطاع غزة بعد الحرب. أعتقد أن هناك رغبة لدى السلطة في أن يكون للحكومة دور رئيس في إدارة الأمور في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
وينسجم هذا مع مطالب الإدارة الأميركية وأوروبا وبعض الدول العربية، وقد تم الحرص على وضع هذا الأمر في تشكيل الحكومة من حيث الأشخاص والجغرافيا والتخصص، ولكن مثل هذا الطموح يصطدم بالواقع الفصائلي والمزاج الشعبي العام في غزة وفي الضفة.


واضح أن هذه الحكومة شُكّلت بضغط دولي، أوروبي وأميركي بخاصّة، وتحت غطاء إصلاح السلطة الفلسطينية.
لا أرى أي شيء مختلف في هذه الحكومة عن سابقتها، باستثناء اعتبارها حكومة تكنوقراط وليست حكومةً فصائلية، وهذه الحكومة تُعاني من نفس الصعوبات التي عانتها الحكومة السابقة، فهي لم تتلق أي وعود بدعم مالي عربي أو غربي، ولم تأت في إطار تحول سياسي مثلما جاءت حكومة الدكتور سلام فياض في سنواتٍ سابقة.
أعتقد أن هذه الحكومة ليست لها علاقة بترتيبات اليوم التالي للحرب على غزة، وتشكيلها جاء بالتوازي مع الحديث عن هيئة دولية لإعمار غزة، والقلق أن يكون تشكيل هذه الهيئة من قبل من سيدفع المال؛ لذلك فإن تدخل هذه الحكومة في ترتيبات اليوم التالي لانتهاء الحرب، يعتّم أيضًا على مخرجات الأمور، ولا يُمكنها بأي حال من الأحوال تجاهل حركة حماس في القطاع.
أعتقد أن خلو الحكومة من أي شخصية حزبية، نابع من رغبة رئيس وزرائها وخلفيته في العمل، وكونه يأتي من القطاع الخاص، وليس من خلفية حزبية، وهذا في اعتقاده يجعلها أكثر مرونة في التعامل معه، ويجعل اللغة المشتركة بين أعضائها أكبر.

هنالك مسألتان تتعلقان بهذه الحكومة، أولًا: الحوار الذي عُقد في موسكو في فبراير/شباط الماضي، حيث كان من المفترض أن تكون الحكومة جزءًا من النقاش، ولكن يبدو أن الأطراف الفلسطينية، بعد أشهر من الحرب على غزة، غير مؤهلة لتشكيل حكومة وحدة حقيقية.
ثانيًا: هذه الحكومة أتت في سياق الرد على وثيقة نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة، وكأنها حكومة اعتراض، إضافة إلى كونها إحدى متطلبات المجتمع الدولي لإصلاح السلطة الفلسطينية.
لا يوجد ما يميز هذه الحكومة عن سابقتها، ومعظم وزراء هذه الحكومة جاؤوا من القطاع الخاص؛ مما قد يجعلها غير قادرة على الانخراط في الشارع، باعتبار وزرائها من خلفيات عمل مكتبي.
حتى لو كان لهذه الحكومة علاقة بترتيبات اليوم التالي للحرب على غزة، أو الرغبة في ذلك، فإني أعتقد أنها لا تستطيع القيام بمهامها، ما لم يكن هنالك اتفاق مع حركة حماس، ولن يستطيع أحد أن يكون له دور في القطاع دون حماس؛ لأن الحكم والإصلاح وإعادة إعمار غزة يتطلب اندماج حماس في المسار السياسي، وحماس ما زالت تحظى بجمهور وقبول ليس بقليل في قطاع غزة.
لا أعتقد أن لهذه الحكومة علاقة بالتعامل مع الأزمات الوطنية الفلسطينية، فهي حكومة إدارية فقط. والمطلوب اليوم إذا كان هناك خطة للتعامل مع الأزمات، النظر بطريقة مختلفة إلى كل من غزة والضفة، وهذا ليس عيبًا، فقد كان هذا ضمن التجربة الألمانية بعد توحيد ألمانيا الشرقية والغربية، وبالتالي لا بُد من الإسراع في إغاثة غزة بشكل كبير، وإنعاش الضفة الغربية.


جاء تشكيل الحكومة في ظل ظرف صعب ومعقد خصوصًا في ظل الحرب على غزة، وما رافق ذلك من ضغوط على الرئاسة الفلسطينية وعلى الحكومة السابقة، ولا سيما في ظل أزمة مالية واقتصادية، وأزمة صراعات داخل السلطة وحركة فتح.
وبالتالي جاءت هذه الحكومة جزءًا من التغيير الذي كان قد بدأ على نطاق المحافظين والسفراء، ثم وصل الرئيس عباس إلى اقتناع بضرورة تغيير الحكومة على الرغم من أنها لن تختلف في الأداء عن حكومة محمد اشتية.
ولكن ربما ركز تشكيل الحكومة الحالية على التكنوقراط والمهنيين بعيدا عن الوجوه السياسية، حيث إن بعض الوزراء محسوب على المؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني، ولكن هذا لا يعني أن التغيير الذي جرى على الحكومة يمكن أن يحدث تغييرًا جذريًّا في منهج العمل والأداء.
كما أن تشكيل الحكومة من التكنوقراط يحمل رسالة إلى حركة حماس، مفادها أنه إن كان هناك تقدم فيما يتعلق بحالة توافق وطني مستقبلي، فإنه يمكن الاندماج بأريحية بسبب عدم وجود ارتباطات سياسية للوزراء، وأن هذه الحكومة قد تكون جزءًا من عملية إعادة إعمار قطاع غزة وملفات ما بعد الحرب، وبالتالي تكون أكثر ديناميكية، ومقبولة حتى لدى حركة حماس نفسها.
الحرب على غزة وما قد يترتب عليها لاحقًا هي قضية أكبر من هذه الحكومة، وهي ملف عالمي يشكل تحديًا على مستوى كبير، فإسرائيل لا تتعاطى حتى اللحظة مع أي طرف فلسطيني في هذا الإطار.
وبالتالي فإن تشكيل هذه الحكومة واحتواءها على ستة أو سبعة وزراء من قطاع غزة، قد يشكل أرضية للتعاطي مع أي أطروحات تتعلق بإعادة إعمار القطاع، والمهمة الأساسية لهذه الحكومة قد تكون في الأساس لغايات الإعمار، ومحاولة إيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالموظفين العموميين.

أعتقد أن أبعاد وأهداف تشكيل الحكومة نابعة من ضغط خارجي، أو ترهّل في الحكومة السابقة، أو سحب البساط من تحت أي قوة كانت تسعى لاستغلال أحداث السابع من أكتوبر. وتشكيلها وفقًا لهذه الخريطة من الخبراء، له علاقه بالوضع الداخلي وخاصة الاقتصادي، في محاولة للملمة الفوضى التي تعصف بالحالة الفلسطينية.
معظم الحكومات السابقة كانت محسوبة على لون واحد وفصيل محدد، أما هذه الحكومة فمعظم وزرائها من الخبراء، وكثير منهم غير معروفين للشارع الفلسطيني. وبسبب عدم وجود رؤية سياسية للحكومة، وعدم وجود قوات عسكرية تابعة لها في غزة، فيبدو أن دورها مقتصر على الإعمار فقط.
لا أعتقد أن هذه الحكومة قادرة على التعاطي مع موضوع الحرب، لأنها لا تسيطر على الأرض في غزة، ولا أعتقد أنها ستكون حرة الحركة في ظل غياب توافق وطني، ولن تستطيع أن تستحوذ على القرار الفلسطيني، حتى لو دعمتها حركة فتح، خاصة أن الأوضاع في غزة تحديدًا صعبة، والوضع خارج إطار قدرة حكومة لا تحظى بدعم فصائلي في غزة.
فريق العمل:
الإعداد: الجزيرة نت بالتعاون مع مركز رؤية للتنمية السياسية
إشراف: محمود العدم
تصميم: قسم الوسائط





