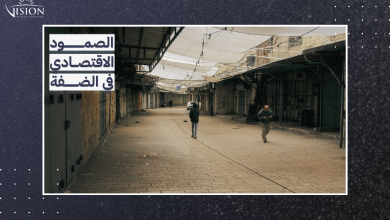العمالة الفلسطينيّة في الداخل المُحتل: التحدّيات الاجتماعيّة وسُبل التمكين الاقتصادي

رغد عزّام
غالبُا ما تخضع جميع مسارات التحوّل الهيكلي للاقتصاد الفلسطيني لمحددات تمليها متطلبات ومقتضيات البيروقراطية الاستعمارية، وبما يتواءم مع مصالحها. وقد عَمِد الاحتلال إلى إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي الفلسطيني من خلال خلق ظروف اقتصادية تُحفّز الفلسطينيين على التخلي عن الزراعة والارتباط بالأرض، عبر تقديم فرص عمل في الداخل المُحتل ذات عوائد مالية أعلى مقارنة بالدخل الناتج عن العمل الزراعي. هذه الإستراتيجية جعلت العمل داخل “إسرائيل” أكثر جاذبية وجدوى للفلسطينيين، وأدت إلى تحويل العمالة الفلسطينية نحو العمل ضمن القطاعات الإسرائيلية بدلاً من تعزيز الأنشطة الإنتاجية المحلية المرتبطة بالأرض. إلى جانب العقيدة الإسرائيلية المترسّخة، بأنّ الهدوء الأمني وانشغال الفلسطينيين بالعمل يخفّف من أعمال المقاومة، ويضمن السيطرة على شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني، والتحكم بقوت يومها. هذا النهج الذي يمزج بين الترغيب والترهيب، مارسه الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 بطريقة ممنهجة للضغط على العمال الفلسطينيين لدفعهم نحو تبني سلوكيات تخدم مصلحة الاحتلال وأمنه، الأمر الذي ترتب عليه تبعات اقتصادية واجتماعية في كلا الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا ما سيتناوله التقرير.
فلسطينيًا … ما هي التبعات؟
عند الحديث عن 17% من القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة[1] كانت تعمل في “إسرائيل” والمستعمرات قبل اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن هذا يعكس اعتماد الاقتصاد الفلسطيني بشكل ملحوظ على السوق الإسرائيلية كمصدر رئيس لتأمين الدخل وتحسين مستويات المعيشة لعدد كبير من الأسر، ما يوضّح الطبيعة الهيكلية للعلاقة الاقتصادية القائمة. وعليه، فإن تقييد أو منع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى فرص عملهم يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، يمكن تلخيصها فيما يلي:
- الضغط على سوق العمل الفلسطيني
واجه العديد من العمال الفلسطينيين صعوبة في إيجاد وظائف بديلة في السوق الفلسطينية منذ تقييد الاحتلال لتصاريح العمل الممنوحة لهم، خاصة وأنّ السوق المحلية غير قادرة على توفير فرص عمل كافية أو توليد فرص عمل جديدة. أدى هذا بدوره إلى تفاقم أزمة البطالة، لترتفع من حوالي 26% عام 2022 (14% في الضفة الغربية و45% في قطاع غزة)، إلى حوالي 51% (35% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة) مع نهاية عام 2024.
يقارن الجدول (1) بين عدد العمال الفلسطينيين في “إسرائيل” والمستعمرات ومعدل أجورهم اليومية، وكما هو واضح فإنّ انخفاض عدد العاملين في السوق الإسرائيلية قد رافقه انخفاض في أجورهم، إلا أنّها لا تزال أعلى بكثير مما هي عليه الأجور في الضفة الغربية (38 دولارًا). الأمر الذي يجعل العمل في السوق الإسرائيلية أكثر جذبًا للقوى العاملة، على الرغم من المخاطر والتضييقات التي يواجهها العمال الفلسطينيون أثناء توجههم لأماكن عملهم.
جدول (1): عدد القوى العاملة من الضفة الغربية وقطاع غزة في “إسرائيل” والمستعمرات ومعدل أجرهم اليومي
| الربع | العاملون في “إسرائيل” | العاملون في المستعمرات | معدل الأجر اليومي |
| الربع الثالث 2023 | 152,900 | 24,500 | 80$ |
| الربع الثالث 2024 | 17,000 | 13,000 | 64$ |
| معدل الانخفاض (٪) | -89% | -47% | -20% |
المصدر: تحليل الباحثة بالاستناد إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، (2023، 2024)، مسح القوى العاملة.
وفقًا لدراسة استقصائية شملت 700 منشأة تعمل في 7 قطاعات مختلفة في الضفة الغربية، أجرتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية، أدى ارتفاع عدد نقاط التفتيش والحواجز في الضفة الغربية والتوغلات الإسرائيلية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. مما أثر بشكل مباشر على سوق العمل، حيث صرحت المنشآت التي شملها المسح أنها اضطرت لتقليص ساعات وأيام العمل بنسبة 73.4%، كما تعرض 52.7% من العمال للتسريح المؤقت إلى حين تحسن أوضاع المنشآت، بينما تم تسريح 39.9% منهم بشكل دائم. تسببت هذه العوامل مجتمعة في زيادة العرض العمالي في سوق العمل المحلي، ما أحدث هبوطًا في مستويات الأجور نتيجة التنافس الشديد على الوظائف المتاحة، وارتفاع نسب العمالة غير المنظمة، وتردي أوضاع العمل وازديادها سوءًا.
ففي سوق العمل بالضفة الغربية، حوالي 48% من العاملين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقود عمل رسمية، مما يشير إلى ضعف الحماية القانونية لهذه الفئة. وعلى مستوى المساهمات في أنظمة التقاعد، فإن 39% فقط من العاملين يحصلون على تمويل تقاعدي، مما يعكس قصورًا في تغطية الضمان الاجتماعي. أما بالنسبة للنساء العاملات في القطاع الخاص، فإن حوالي 49% منهن فقط يستفدن من إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وهو ما يبرز التفاوت في الامتيازات ومستوى الحماية الاجتماعية في سوق العمل الفلسطيني.
- انخفاض الدخل وارتفاع الفقر
بالنظر إلى أن العمال الفلسطينيين الذين عملوا في السوق الإسرائيلية كانوا يتمتعون بمستوى دخل يفوق الأجور المحلية، فهذا وفر لهم قوة شرائية مكّنتهم من تحسين ظروفهم المعيشية بشكل ملحوظ. كما استفادوا من خدمات القروض التي تقدمها البنوك المحلية، الأمر الذي ساعدهم في تحقيق استقرار مالي واجتماعي نسبي. ومع ذلك، فإنّ حرمانهم المفاجئ من الوصول إلى سوق العمل الإسرائيلي أدى إلى انهيار مصادر دخلهم الرئيسة، مما أجبر العديد منهم على استنزاف مدّخراتهم أو بيع ممتلكاتهم، لتغطية احتياجاتهم الأساسية. هذا التحول السريع في الظروف الاقتصادية دفع الكثيرين منهم إلى السقوط في دائرة الفقر، وتراجع مستويات المعيشة بشكل كبير.
أما أولئك الذين يملكون أراضي زراعية صغيرة ويعتمدون عليها كملاذ أخير، فقد وجدوا أنفسهم مجبرين على التأقلم مع نمط حياة أكثر تقشفًا، في ظل غياب أي بديل اقتصادي مستدام. تدريجيًا، أصبح هذا الانقطاع عن سوق العمل الإسرائيلي عاملاً رئيسًا في تعميق الفجوة الاقتصادية داخل المجتمع الفلسطيني، وزيادة مستويات الفقر بين الفئات العمالية، ليمتد ذلك إلى الحياة الاجتماعية للعائلات، حيث تتعرض العديد من الأسر لصعوبات اقتصادية تؤثر على جودة حياتهم، ومستوى تعليم أبنائهم، والرعاية الصحية الموفرة لهم.
- زيادة الضغط على القطاع العام
يشكل خفض إيرادات السلطة الفلسطينية المتأتية من أجور العمال الفلسطينيين لدى الاحتلال، والتي تقدر بحوالي 50 مليون دولار سنويًا، عبئًا إضافيًا على الموازنة العمومية التي تعاني سنويًا من عجز مركّب، مع انعدام خيارات التمويل الممكنة وتضاؤل الدعم الدولي، إلى جانب تزايد الدين العام، الذي ارتفع بنسبة 21% [2]مع نهاية نوفمبر 2024 عما كان عليه في الشهر المناظر من العام الماضي. ومع تزايد البطالة، يتعين على الحكومة الفلسطينية توفير المزيد من الوظائف في القطاع العام، مما يشكل ضغطًا على الميزانية العامة، ويقلل من قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها وعلى وجه الخصوص فاتورة الأجور والرواتب.
أطلقت سلطة النقد برنامجًا تمويليًا بقيمة 70 مليون شيكل (حوالي 18 مليون دولار)، لدعم العمال والعاملات الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل قبل السابع من أكتوبر 2023، والذين تم تسريحهم قسرًا من أماكن عملهم بالداخل المحتل. وذلك بهدف مساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة أو تطوير مشاريعهم القائمة فعليًا، مع تخصيص حد أدنى بنسبة 5% للنساء. إلا أن ارتفاع الطلب على برامج المساعدات الاجتماعية والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية يُضعف مظلة الحماية الاجتماعية ويزيد من الأسر المتضررة التي تحتاج للدعم، مما يقلل من قوة وكفاءة المساعدات المقدمة.
- الشيكات الراجعة وانخفاض السيولة
تشكل تحويلات العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل مصدرًا أساسيًا لدخل العديد من العائلات الفلسطينية، ويؤدي تراجع هذه التحويلات إلى انخفاض السيولة النقدية في الأسواق، مما ينعكس سلبًا على مستويات الاستثمار المحلي، ويؤدي إلى تباطؤ نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي إضعاف رأس المال الإنتاجي. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تراجع دخول الأسر بشكل مباشر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يرفع من معدلات القروض المتعثرة ويزيد من المخاطر المالية في النظام المصرفي، وبالتالي حدوث انكماش اقتصادي.
كنتيجة مباشرة لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للعمال الفلسطينيين، وانخفاض فرص عملهم داخل السوق المحلي، تراجعت السيولة النقدية بشكل ملحوظ، ففي عام 2024، وصلت قيمة الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد حتى نهاية نوفمبر إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة، بحسب الإحصاءات الرسمية، إلى 8%، مقارنة بـ 5% و 6% خلال عامي 2022 و 2023 على التوالي[3].
إسرائيليًا… ما هي فُرص التخلي عن العمال الفلسطينيين؟
يشهد الاحتلال تحولًا كبيرًا في سياسات العمالة المهاجرة لمواجهة النقص الناتج عن غياب العمالة الفلسطينية، خاصة في قطاعات البناء والزراعة، إضافة إلى مغادرة 10 آلاف من العمال الأجانب هربًا من ظروف الحرب. ومع ذلك، تُثير السياسات الجديدة مخاوف داخلية تتعلق بارتفاع التكاليف وصعوبة استدامة الحلول المقترحة، إلى جانب المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن استبدال العمالة الفلسطينية ذات الخبرة بعمالة أجنبية أقل كفاءة وتدريبًا. فضلًا عن ذلك، يشكّل حاجز اللغة مع العمال من جنسيات متعددة تحديًا إضافيًا أضعف قدرة الاحتلال على الحفاظ على استقرار سوق العمل.
قطاع البناء، الذي يمثل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، يعتبر الخاسر الأكبر، والذي لا يزال يعاني من تعطل 40% من نشاطه منذ أن علّق الاحتلال تصاريح العمال الفلسطينيين، على الرغم من الجهود المبذولة لاستجلاب العمالة الأجنبية. إذ يساهم العمال الفلسطينيون بحوالي 22% من إجمالي العاملين في قطاع البناء لدى الاحتلال[4]، ويولّدون حوالي 66% من إنتاجه سنويًا.
ووفقًا لآدي بريندر، رئيس الأبحاث في بنك إسرائيل، فإن هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع الاقتصاد بنسبة قد تصل إلى 3%، والنسبة تتفاوت بناءً على سرعة وصول العمال الأجانب. كما أن توقف البناء سيزيد من تفاقم أزمة نقص المساكن وارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة المنتجات الزراعية من خضار وفواكه، نتيجة انخفاض العمالة في هذا القطاع، مما يسهم بشكل مركّب ومتسارع في تصاعد معدلات التضخم.
أما قطاع الصناعة فهو ليس ببعيد عن هذا المأزق، ففي ظل نقص العمالة بات يعمل بنسبة 30% من طاقته الإنتاجية. وقد قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية حجم الضرر الاقتصادي الناجم عن منع دخول العمال الفلسطينيين بنحو 3 مليارات شيكل (830 مليون دولار) شهريًا. ولعل هذا المأزق الذي يمر به سوق العمل الإسرائيلي هو ما جعلهم يتعاملون مع العمال الفلسطينيين بسياسة إغماض العين، والتغاضي عن السياسات العقابية والإجراءات القانونية، والسماح لأكثر من 30 ألف عامل فلسطيني بالدخول لمواقع عملهم بتصاريح أو بدون تصاريح بغية تسيير متطلبات الاقتصاد لديهم.
وكأحد التدابير العاجلة للتعامل مع أزمة نقص العمال، أقرّت حكومة الاحتلال تشريعات لرفع الحد الأقصى لتصاريح العمال المهاجرين وتوسيع نطاق القطاعات التي يمكن استقدام العمالة الأجنبية إليها. تشمل هذه القطاعات البنية التحتية، النقل، المطاعم، خدمات التنظيف، البناء، وتجارة التجزئة، حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى جلب أكبر عدد ممكن من العمال المهاجرين لمختلف القطاعات خلال أقصر وقت ممكن. ولتحقيق ذلك، استهدفت عدة دول لجلب العمالة، منها سريلانكا، التي تم توقيع اتفاقية ثنائية جديدة معها لجلب العمال الزراعيين، والهند، التي سيتم استقدام 42 ألف عامل منها للعمل في قطاعي البناء والتمريض. ومع ذلك، شهدت العلاقات مع دول أخرى مثل الصين وأوكرانيا تعقيدات، فقد جمدت الصين اتفاقها مع الاحتلال بسبب ظروف الحرب وحالة عدم الاستقرار، بينما توقف العمال الأوكرانيون عن القدوم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
خاتمة
على مدار عقود، واجه الاقتصاد الفلسطيني تشوّهات بنيوية تركت بصماتها على مختلف الجوانب الاجتماعية. تجلت هذه التشوهات في تآكل القطاعات الإنتاجية، وتفاقم البطالة الهيكلية، وازدياد اعتماد شريحة واسعة من القوة العاملة الفلسطينية على فرص العمل داخل الاقتصاد الإسرائيلي، مما رسخ حالة من التبعية الاقتصادية. أفضى هذا المسار إلى أسرلة الاقتصاد الفلسطيني، بأن أصبحت الأنشطة الاقتصادية تتجه نحو الطابع الخدمي غير المتجدد، والذي يعمل بالدرجة الأولى لتعظيم استفادة الاقتصاد الإسرائيلي، بدلاً من الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتنموية التي تحقق الهوية الاقتصادية المستقلة.
أدت هذه التغيرات إلى اتساع مظاهر التفاوت الاجتماعي والجغرافي بين التجمعات السكانية الفلسطينية، مع بروز مناطق مهمشة تعاني من معدلات حرمان أعلى، مثل قطاع غزة ومناطق الأغوار. في ظل هذه الظروف، تعمقت الفجوات الاجتماعية وانحسر الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مما جعل تحقيق التنمية المستدامة تحديًا مركبًا.
لذلك، ينبغي أن تركز إستراتيجية التنمية الاقتصادية على تعبئة الموارد البشرية وتنظيمها ضمن إطار متكامل يعزز التضامن والتنسيق الاجتماعي. وبهذا النهج، لا يكون النجاح مرهونًا فقط بتوافر الموارد المالية، بل يعتمد بشكل أساسي على استثمار شامل وفعّال للعمالة الفلسطينية كعنصر رئيس في التنمية، بعيدًا عن سياسات التهميش أو التعامل معها كعبء. فكما فشل نموذج الإقصاء في غزة، القائم على العقاب الجماعي والحصار الاقتصادي، لا بُدّ من إفشال نموذج السيطرة في الضفة الغربية، القائم على استغلال العمال الفلسطينيين.
[1] هذه النسبة تمثل الإحصاءات الرسمية، ولا تشتمل على العمال الذين يدخلون بالتهريب ودون تصاريح رسمية، حيث قدّرت منظمة العمل الدولي أن حوالي 40 ألف فلسطيني كانوا يعملون في “إسرائيل” والمستعمرات دون تصاريح عمل قبل الحرب على قطاع غزة.
[2] النسبة المئوية من احتساب الباحثة، بالاستناد لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، البيانات الشهرية، تداول الشيكات في فلسطين، https://www.pma.ps/ar/Statistics//MonthlyStatisticalBulletin
[3] النسب المئوية من احتساب الباحثة، بالاستناد لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، البيانات الشهرية، الدين العام للسلطة الوطنية الفلسطينية، https://www.pma.ps/ar/Statistics//MonthlyStatisticalBulletin
[4] تمثل هذه النسبة العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل رسمية، إلا أنّ تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى حوالي 14 ألف فلسطيني كانوا يعملون في قطاع البناء دون تصريح.