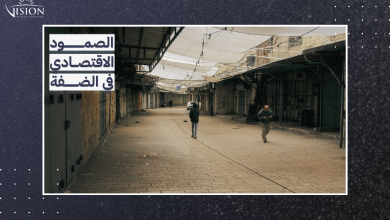الشيكل الخامل: أزمة ظاهرها اقتصادي وباطنها سياسي
رغد عزام

تقوم سياسة الاحتلال الإسرائيلي على تقويض السلطة الفلسطينية عبر الاحتواء والسيطرة. وتمارس ذلك من خلال ترسيخ هيكل مالي مقيد للسلطة الفلسطينية، ويوفر لها أليات تضمن تخفيف الأزمات المالية على المدى القصير، دون السماح بأي تغيير جوهري في واقع الاعتماد المالي وفقدان السيادة. يقوم هذا الهيكل على نظام إيرادات محدود ومقيَّد وقائم بحكم الواقع، ولا يُسمح بموجبه للسلطة الفلسطينية امتلاك أي أداة نقدية لحل الأزمات المالية كباقي الدول. وتبرز أزمة “تكدس الشيكل” كأحد أوجه هذا الهيكل المالي المقيّد، إذ تعاني المصارف الفلسطينية من أزمة تكدس الشيكل منذ سنوات طويلة، وبحجة محاربة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال في السوق الفلسطيني، يمتنع الاحتلال بشكل متكرر عن استقبال النقد من البنوك الفلسطينية، ويوظفها كأداة لضمان امتثال المصارف الفلسطينية لسياساته النقدية. يسعى هذا التقرير إلى تحليل الجذور القانونية والاقتصادية لهذه الأزمة وما ينتج عنها من قيود سياسية تقوض القرارات المالية للسلطة الفلسطينية.
-
ما معنى تكدس العملة؟
يشير مصطلح “تكدس العملة” إلى تراكم كميات كبيرة من النقد داخل النظام المصرفي دون تدويرها في الأنشطة الاقتصادية المنتجة. يحدث هذا التكدس عندما تتجاوز السيولة النقدية المتاحة قدرة الاقتصاد على استيعابها واستثمارها بشكل فعّال، ما يؤدي إلى ركود رأس المال. اقتصاديًا، يشكل هذا الوضع مشكلة مزدوجة؛ فمن جهة، يؤدي إلى انخفاض كفاءة النظام المالي، حيث تبقى الأموال راكدة دون توليد قيمة اقتصادية مضافة. ومن جهة أخرى، يؤدي تراكم العملة إلى زيادة تكاليف إدارة السيولة لدى المصارف، ويزيد من الفجوة بين العرض النقدي والطلب الفعلي على الأموال، ما يؤدي إلى ضغوط تضخمية.
-
ما الإطار القانوني لتحويل الشيكل بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية؟
يستند تحويل الشيكل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الأسس القانونية الواردة في اتفاق باريس الاقتصادي، والذي نص على اعتماد الشيكل الإسرائيلي كعملة قانونية متداولة محليًا، وإنشاء سلطة نقد فلسطينية تتولى تنظيم العمل المصرفي، والاحتفاظ بالاحتياطي، والرقابة على المصارف، وتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية. كما نص الاتفاق على التزام الاحتلال الإسرائيلي بتحويل فائض الشيكل وتبادل النقد بين المصارف الفلسطينية (عبر بنك فلسطين والبنوك الأردنية)، والمصارف الإسرائيلية عبر بنوك المراسلة، “هبوعليم” و”ديسكونت”.
وبحسب الاتفاق، ينبغي أن تعقد سلطة النقد الفلسطينية وبنك “إسرائيل” اجتماعات دورية للتنسيق بشأن تحويل فائض الشيكل، تشمل اجتماعًا سنويًا لتحديد المبلغ المتوقع تحويله للسنة المالية القادمة، مع مراجعة نصف سنوية لتعديل هذا المبلغ استنادًا إلى البيانات المالية السابقة والتوقعات المستقبلية. أما تبادل العملة الأجنبية مقابل الشيكل، والعكس، من قبل السلطة النقد الفلسطينية يتم عبر بنك “إسرائيل”، وذلك وفقًا لمعدلات الصرف في السوق.
لاحقا، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون تقليص استخدام النقد، المعروف باسم “قانون لوكر”، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2019. جاء هذا القرار بحجة منع اقتصاد الظل والتهرب الضريبي وغسل الأموال داخل الاقتصاد الإسرائيلي. يحدد القانون سقفًا للمعاملات النقدية بين الأفراد بقيمة 50,000 شيكل (حوالي 14,000 دولار)، وبين الشركات بقيمة 11,000 شيكل (حوالي 3,000 دولار). كما يُلزم المشترين بالإفصاح عن مصادر تمويلهم. عام 2022، أقر الكنيست الإسرائيلي المرحلة الثانية من هذا القانون، والذي خفض سقف التعاملات النقدية إلى 15,000 شيكل (4,200 دولار تقريبا) للأفراد و6,000 شيكل (1,700 دولار تقريبا) للشركات.
-
ما سبب تكدس الشيكل في المصارف الفلسطينية؟
بمعادلة بسيطة، يمكن احتساب فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية عبر جمع الشيكل المتأتي للسوق الفلسطيني مطروح منه الشيكل الخارج منه. يدخل الشيكل للسوق الفلسطيني من خلال أربع قنوات رئيسية: دخل العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل (18 مليار شيكل، تقريبا 5 مليار دولار سنويا)، وأموال المقاصة[1] (10 مليار شيكل، تقريبا 3 مليار دولار سنويا)، والأموال التي ينفقها أهالي الداخل المحتل في الضفة الغربية (5 مليار شيكل، حوالي1.4 مليار دولار سنويا) والتي تشمل امتلاك الأصول الثابتة كالأراضي والعقارات، والصادرات الفلسطينية للاحتلال (4.8 مليار شيكل، 1.3 مليار دولار). أما الشيكل الذي يخرج من السوق الفلسطيني فهو ثمن الواردات التي تأتي من أو عن طريق الاحتلال (16 مليار شيكل، 4.4 مليار دولار). وكنتيجة لذلك، فمن المفترض أن يصل فائض الشيكل إلى حوالي 22 مليار شيكل (6 مليار دولار) سنويا.
على مر السنوات، تم رفع سقف فائض الشيكل الذي تسمح المصارف الإسرائيلية باستقباله، ليصل إلى 4.5 مليار شيكل (1.2 مليار دولار) بوتيرة ربعية، أي 18 مليار شيكل (4.8 مليار دولار) سنويا. بمعنى أن السقف القانوني للشيكل الذي يسمح بترحيله للمصارف الإسرائيلية هو أقل بحوالي 4 مليار شيكل من المبلغ المتكدس في المصارف الفلسطينية سنويا! هذا الشيكل المكدس أضحى “خامل” لا يمكن استخدامه أو استثماره، وإنما يشكل عبء على المصارف الفلسطينية في تخزينه ونقله، فمع نهاية عام 2023 سيطرت عملة الشيكل على 84% من إجمالي السيولة النقدية للمصارف الفلسطينية.
تحتفظ البنوك الفلسطينية بجزء من عملة الشيكل لهدفين رئيسيين: الأول، كجزء من الاحتياطي النقدي إلى جانب احتياطيات العملات الأجنبية الأخرى؛ والثاني، لتلبية احتياجات السوق من السيولة اليومية. أما المبالغ التي تتجاوز هذه الاحتياجات، فتُعد فائضًا ويجب ترحيلها إلى بنك إسرائيل. وفقًا لبروتوكول باريس، يحق للسلطة الفلسطينية تحويل فائض الشيكل إلى بنك إسرائيل، الذي يتولى بدوره تحويله إلى عملات أجنبية لصالح سلطة النقد الفلسطينية، إذ تحتاج البنوك الفلسطينية لتحويل فائض عملة الشيكل إلى عملات أجنبية لتنفيذ تعاملاتها المالية الدولية، ولا يتم ذلك إلا عبر البنوك الإسرائيلية، التي تعمل كوسيط مالي بين الجهاز المصرفي الفلسطيني والعالم الخارجي. وفي حال تعذر ترحيل هذا الفائض، يتكدس الشيكل في خزائن البنوك الفلسطينية، ما يترتب عليه خسائر ناجمة عن تكاليف التخزين، والتأمين، وانعدام القدرة على استخدام هذه الأموال بشكل فعّال.
يتم اللجوء، أحيانا، إلى شحنات استثنائية لفائض الشيكل بالاتفاق بين سلطة النقد الفلسطينية وبنك “إسرائيل”، بحيث تتجاوز هذه الشحنات الحد السنوي المتفق عليه. فعلى سبيل المثال، في عام 2022 قامت سلطة النقد الفلسطينية بترحيل نحو 25.5 مليار شيكل إلى المصارف الإسرائيلية، منها 7.5 مليار شيكل كشحنات استثنائية، لتقليص فائض النقد بالشيكل في المصارف الفلسطينية. إلا أن علاقات المراسلات بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية رهينة الأوضاع السياسية، حالها حال كل التعاملات المالية مع الاحتلال. إذ تواجه البنوك الفلسطينية تحديات مستمرة في علاقات المراسلة مع نظيراتها الإسرائيلية، حيث تتلكأ الأخيرة في استقبال فائض الشيكل وتفرض قيودًا متزايدة على التحويلات المالية، وغالبا ما يتم رفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية بحجة تبييض الأموال ودعم الإرهاب.
كما أن اتفاقية المراسلات بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية يتم تمديدها بشكل مضطرد. حيث يتطلب بنكي “هبوعليم” و”ديسكونت” الحصول على ضمانات حكومية لحمايتهما من المخاطر القانونية والمالية المحتملة. وفي هذا السياق، تقدم الحكومة الإسرائيلية لهما ضمانين رئيسيين: الأول من وزارة العدل، تمنحهما حصانة من أي دعاوى قضائية قد تُرفع ضدهما بتهم تتعلق بـ”تمويل الإرهاب” بسبب تعاملاتهما مع البنوك الفلسطينية، والثاني من وزارة المالية، تلتزم فيها الحكومة بتعويضهما عن أي غرامات أو خسائر مالية قد تنجم عن مثل هذه الدعاوى في المحاكم الدولية.
حالة عدم اليقين الناجمة عن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية، وما رافقها من مخاوف متزايدة بين المواطنين والتجار من فقدان مدخراتهم في ظل التصعيد العسكري المتواصل في مدن الضفة الغربية، انعكست في نمو تصاعدي في حجم إيداع عملة الشيكل لدى البنوك الفلسطينية، ما أدى إلى تكدس الشيكل في خزائن المصارف المحلية بمستويات تتجاوز قدرتها الاستيعابية خلال فترة الحرب.
أضف إلى ذلك، أن التشريعات والإجراءات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية لتقليص استخدام المدفوعات النقدية تتم بشكل أحادي، دون أي تنسيق مع الجانب الفلسطيني. وقد أدى خفض سقف المدفوعات النقدية، وفقا لقانون لوكر بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني. فعلى عكس الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل أكبر على الأنظمة المالية الرقمية ووسائل الدفع الإلكترونية، يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل أساسي على المعاملات النقدية نظراً لطبيعة السوق والتحديات المتعلقة بالبنية التحتية المالية. هذا التباين في أنماط الدفع يجعل الاقتصاد الفلسطيني أكثر عرضة للتأثر السلبي بمثل هذه القيود، ما يؤدي إلى تعقيد العمليات التجارية اليومية، ويزيد من الأعباء المالية على الأفراد والشركات الفلسطينية، ولا يحرز أي تقدم في حل مشكلة تكدس الشيكل.
كما يؤدي انتشار الاقتصاد غير الرسمي في فلسطين إلى تفاقم مشكلة فائض الشيكل، حيث يتداول جزء كبير من النقد خارج القنوات المصرفية الرسمية. ويرتبط هذا بشكل رئيسي بالأنشطة والمعاملات الاقتصادية التي تجري نقدًا بدلاً من المرور عبر الأنظمة المصرفية الرسمية. مثل عمليات البيع للسلع والخدمات التي تتم بين المستوطنين والتجار أو الحرفيين الفلسطينيين في المناطق ج، وتهريب المنتجات الفلسطينية الاحتلال[2]، ودخول العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل بشكل غير رسمي (دون تصريح عمل). جميع هذه الأنشطة يتم تسديد ثمنها نقدا بالشيكل، ما يعني زيادة التدفق غير المنظم للشيكل عبر النظام المالي الرسمي.
-
ما تأثير تكدس الشيكل على الاقتصاد الفلسطيني؟
عانت المنظومة المصرفية الفلسطينية من آثار متفاقمة لتراكم الشيكل في السوق المحلي، وهو ما يعكس خللاً نقديًا يرتبط بطبيعة العلاقة النقدية غير المتكافئة مع الاقتصاد الإسرائيلي. إذ أسهمت الإجراءات النقدية الإسرائيلية في إبقاء كميات فائضة من الشيكل داخل المصارف الفلسطينية، ما فرض تحديات كبيرة على إدارة السيولة النقدية.
في هذا السياق، أفرز فائض الشيكل زيادة في المعروض النقدي بعملة الشيكل، دون مقابل إنتاجي محلي كافٍ من السلع والخدمات، قادت إلى ارتفاع متواصل في الأسعار. وبالتالي هدف الاحتلال إلى تصدير التضخم للسوق الفلسطيني عبر ضخ كميات من الشيكل دون أدوات رقابة نقدية مستقلة، مما يُقوّض القوة الشرائية ويؤدي إلى تآكل مستويات الدخل الحقيقي للأسر. كما تؤثر هذه الحالة من عدم الاستقرار النقدي في مناخ الاستثمار، إذ يؤدي ضعف اليقين إلى إحجام القطاع الخاص عن ضخ استثمارات طويلة الأجل، لا سيما في القطاعات الإنتاجية، مما يضعف آفاق النمو الاقتصادي.
على مستوى النظام المصرفي، تجاوز فائض الشيكل قدرات البنوك الفلسطينية على تصريفه أو تحويله إلى عملات أجنبية، مما أدى إلى أزمة سيولة حادة، خاصة بالعملات الأجنبية، انعكست سلبًا على قدرة الجهاز المصرفي في تمويل التجارة الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد، لا سيما في القطاعات الحيوية. كما اضطرت البنوك إلى تحمل تكاليف إضافية لتخزين العملة الفائضة، شملت تكاليف التأمين والنقل، مما أضعف من هوامشها التشغيلية، عدا عن خسارة البنوك لتكلفة الفرصة البديلة من تشغيل الشيكل بدل تخزينه.
من جهة أخرى، لجأت البنوك إلى فرض رسوم على إيداعات الشيكل أو الامتناع عن قبولها في بعض الحالات، كوسيلة للحد من تدفقه، وهو ما أثر سلبًا على ثقة المودعين. وترافق ذلك مع توسع في المعاملات المالية غير الرسمية، والسوق السوداء واقتصاد الظل، في ظل غياب قنوات تحويل رسمية وفعالة، مما زاد من نسب التهرب الضريبي، وعمّق الفجوة في الإيرادات العامة.
خاتمة
في ظل غياب سياسة نقدية فلسطينية مستقلة، يؤدي استمرار الارتهان للنظام المالي الإسرائيلي إلى تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة أدواتها الاقتصادية والرقابية، ويفتح الباب أمام مزيد من الهشاشة المالية. وتعتمد البنوك الفلسطينية بشكل شبه كامل على نظيرتها الإسرائيلية في إجراء التحويلات الدولية والتعاملات المصرفية العابرة للحدود، مما يجعل أي توقف مفاجئ في هذه العلاقة تهديدًا مباشرًا لاستمرارية التجارة الخارجية، ويزيد من اضطراب سلاسل التوريد، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والغذاء والطاقة.
ورغم أن الاحتلال كثّف من سياساته التضييقية على القطاع المصرفي الفلسطيني خلال الحرب، وقيّد قنوات التحويلات النقدية كأداة للضغط المالي، إلا أنه حرص في المقابل على الحفاظ على استقرار مخزونه من النقد الأجنبي. فقد ارتفعت احتياطيات الاحتلال من العملات الأجنبية في نهاية أبريل 2025 إلى حوالي 222 مليار دولار، وفقًا لتقارير بنك “إسرائيل”. ما يعكس حرص الاحتلال على حماية اقتصاده الداخلي من موجات التضخم، والحفاظ على استقرار تعاملاته المالية الدولية، في الوقت الذي يصدر فيه التضخم للسوق المالية الفلسطينية.
[1] تشمل: ضرائب الاستيراد والجمارك على البضائع المستوردة من الاحتلال أو عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المنتجات والخدمات الإسرائيلية المباعة للفلسطينيين، ورسوم المحروقات، ورسوم المعابر، وضريبة الدخل على أموال العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل.
[2] كتهريب المنتجات الزراعية للاحتلال بشكل غير رسمي، للاطلاع على الموضوع يمكن الرجوع للتحقيق الصحفي على هذا الرابط: https://albaladfm.ps/38150/تحقيق-صحفي-مزارعو-الأغوار-يواجهون-الض/